كثر الهراء غرابة في هذه الأيام ما تكتبه بعض الأقلام من كلام حاصله أن السينما عندنا كانت أحسن حالاً قبل فجر الثالث والعشرين من يوليه لعام 1952 منها بعده.
ووجه الغرابة في هذا الكلام الأقرب إلى اللغو، أنه لو استطعنا العودة عبر رحلة الذاكرة إلى السينما الروائية عند الميلاد على أرض الوطن، أي في الربع الرابع من عقد العشرينات، ثم الصعود مع سيرتها مرة ثانية نحو المستقبل حتى بلوغها سن الخامسة والعشرين ربيعاً في الربع الأول من عقد الخمسينيات، لو استطعنا ذلك لوجدنا أمامنا سينما وطنية تعيش عالة على السينما العالمية في كل صغيرة وكبيرة. فالمعدات مستوردة، والأفكار مستعارة، والأخطر من هذا كله ذلك الانبهار بسينما هوليوود الذي وصل إلى حد التأليه والسجود لأفلامها، والتقليد الأعمى لكل ما تنطوي من زبد لا ينفع الناس.
ولبيان هذا المدى في التأثير، تكفي نظرة طائرة على كل من “قبلة في الصحراء” للأخوين إبراهيم وبدر لاما (5 مايو لعام 1927) الذي يعتبر بحق أول فيلم عربي روائي تجاري طويل.
 و”ليلى” للمخرج “استيفان روستي” (16 نوفمبر لعام 1927)، والذي به- في رأي نفر من مؤرخي السينما– بدأ إنتاج الأفلام الروائية الطويلة في مصر، وذلك باعتبار أن نجمته ومنتجته “عزيزة أمير” تحمل الجنسية المصرية، الأمر غير المتوافر في حق الأخوين “لاما”.
و”ليلى” للمخرج “استيفان روستي” (16 نوفمبر لعام 1927)، والذي به- في رأي نفر من مؤرخي السينما– بدأ إنتاج الأفلام الروائية الطويلة في مصر، وذلك باعتبار أن نجمته ومنتجته “عزيزة أمير” تحمل الجنسية المصرية، الأمر غير المتوافر في حق الأخوين “لاما”.
الأرض الخراب
وسواء أكان أي من هذين الفيلمين هو الأول أم الثاني، فمن المتيقن أن الإنتاج السينمائي بدأ على أرض مصر، والوطن العربي، ماعدا المملكة السعودية وإمامة اليمن، ترفرف على جميع ربوعه من المحيط إلى الخليج أعلام الاستعمار الإنجليزي والفرنسي والإيطالي والأسباني والحكم في مصر يتقاسمه الإنجليز والسراي وأحزاب لا تمثل سوى الأقلية، وشراذم من المغامرين والأفاقين الأجانب.
في هذا الجو الذي يشيع فيه الذل والخوف، بدت السينما في مصر، أو بمعنى أصح في الوطن العربي كما لو كانت لا تعزف إلا لحناً واحداً لا يتغير .
معبود هوليوود
ومهما يكن من الأمر، فما هو هذا اللحن الواحد الذي يعزفه الفيلمان الرائدان؟
أولهما: وهو منقول جملة وتفصيلا عن فيلم أمريكي قام بتمثيله “رودلف فالنتينو” معبود النساء تحت اسم “ابن الشيخ” يقول ضمن ما يقول من تفاهات أن شاباً “شفيق” من الأعراب المقيمين في الصحراء، رأته شابة أمريكية “هلدا” فهامت به من أول نظرة.
وكان “شفيق” مولعاً بسباق الخيل والمراهنة، دائم الشجار مع عمه لهذا السبب.
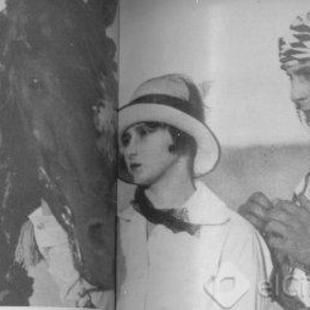

وحدث ذات يوم أن عثر “شفيق”على عمه قتيلاً،وحامت حوله الشبهات الأمرالذي اضطره إلى الفرار والاختفاء في الصحراء حيث انضم إلى عصابة من قطاع الطرق.
وتشاء الصدف أن تهاجم العصابة قافلة تضم “هلدا” ويأمر “شفيق” رفاقه بإخلاء سبيل القافلة بمجرد تعرفه عليها.
وبفضل خنجر مشدود إلى وسطه تتعرف هي الأخرى عليه، فتعود إليه لتعبر عن هيامها به، ويتعانقان، إلا أنه سرعان ما يتذكر أنه طريد العدالة، ولا يستطيع العودة معها إلى المدينة.
وبعد أن تستأنف رحلتها مع القافلة يزف اليه نبأ الحكم ببراءته، فيلاحق القافلة في الصحراء حيث يكتشف أن ثلاثة لصوص قد اختطفوا “هلدا” فيطاردهم حتى ينتصر عليهم ويسترد محبوبته.
طريق الضياع
ومن عجب أن الأخوين لاما ظلا مدمنين لهذا النوع من الهراء المستورد حتى آخر فيلم لهما “صلاح الدين الأيوبي” (1941) فهو لا يعدو أن يكون مسخاً اختلطت فيه الأمور، فالجيوش الصليبية تكر وتفر بأسلوب قطاع الطرق، تخطف، تنهب، تحرق.
و”صلاح الدين” مع نفر من الأتباع الأبرار يقف بالمرصاد للصليبيين الأشرار كما رعاة البقر في أفلام الغرب الأمريكي.
وللنهوض فنياً بفيلمه اختصر”إبراهيم لاما” الطريق، لجأ إلى ما نعتته مجلة “الراديو” وقتذاك بسرقة غريبة أو تدجيل من نوع جديد كيف؟
بأن قام بلصق أجزاء من المعارك الحربية في فيلم للمخرج الأمريكي الشهير “سيسيل ب . دي ميل” اسمه “الصليبيون”.
فكان أن بدت وجوه العرب “افرنجية الملامح” وعندما قرأ الأخوان “لاما” هذا النقد اللاذع بادرا بحذف المشاهد المختلسة، فكانت النتيجة أنهما– وفق ما جاء في مقال بنفس المجلة– زادا الأمر اضطراباً على اضطراب وعبثاً على عبث”
علية القوم
وفي الفيلم الثاني “ليلى” نجد نفس الهراء متجسداً في قصته التي تدورحول فتاة جميلة يتيمة يكفلها عمدة قرية صغيرة تقع على مشارف الصحراء.
يزور القرية الثري رءوف بك، فيرى البدوية الحسناء ويراودها عن نفسها، تعرض عنه لأنها وهبت قلبها لجارها الشاب البدوي الشهم “أحمد” الذي يعمل دليلاً للسائحين.
وتشاء الصدف أن تزور القرية سائحة متحررة تهيم بأحمد وتغرية بالرحيل معها بعيداً إلى البرازيل.
وطبعاً تطرد ليلى من القرية بعد اكتشاف انها حامل من أحمد الذي غدر بها.
وفي الطريق، وبينما هي وحيدة منبوذة، يتوقف لها “رءوف بك” بعربته ثم يصطحبها معززة مكرمة إلى قصره حيث يعقد قرانه عليها.
وقد يكون من الصعوبة بمكان تصور قصة بمثل هذا القدر من التفاهة والبعد عن الواقع والحط من شأن الجماهير. ومع ذلك فقد تعرضت “عزيزة أمير” لحملة من الانتقادات، وأخذ عليها إفراطها في الاهتمام بالدهماء.
ولعل المقال الذي نشر في عدد 28 من نوفمبر لعام 1927 في مجلة “الصباح” خير مثال يساق للتدليل على مستوى هذه الانتقادات.
ففيه يأخذ كاتبه على “عزيزة أمير” جنوحها إلى احتقار الشرق والسخرية من تقاليده بأسلوب امرأة متفرنجة، ويعترض على اتخاذ القرية مكاناً لأحداث الفيلم، مستفسراً من المنتجة– وهو في أشدّ حالات الاستياء– عن سبب اصرارها على إظهار مصر وكأنها لا تزال تعيش في القرون الوسطى، هذا في الوقت الذي يوجد “الكثير مما نفخر به”.
وفي ختام مقاله صاح متسائلاً كيف سمح السينمائيون صانعو الفيلم لأنفسهم- وهم من علية القوم في القاهرة- أن يجري تصويرهم داخل عشش.
وكرد فعل لهذا النقد أعلنت “عزيزة أمير” عن توبتها واتجاه نيتها إلى اختيار قصة لفيلمها القادم تجري أحداثها وسط الطبقات العليا في مصر.
متكلم وصامت
ولم تكن الفترة الصامتة من حياة السينما العربية على أرض مصر طويلة، فبعد فيلمي “قبلة في الصحراء” و”ليلى” بخمسة أعوام إلا قليلا، وبالتحديد يوم 14من مارس لعام 1932 أي في عهد إسماعيل صدقي باشا- وهو من أشد العهود سواداً في تاريخ مصر الحديث- عرض أول فيلم عربي ناطق “أولاد الذوات” الذي أخرجه “محمد كريم” ومثله “يوسف وهبي”.
وفي هذا اليوم التاريخي اكتشف جمهور الحفلة أنه كان ضحية غش كبير، فقد تبين له أثناء العرض أن “أولاد الذوات” نصفان الأول ناطق عربي اللسان والثاني صامت لا ينطق حرفاً واحداً.
وأن هذا الاستهتار ليس له من سبب سوى رغبة منتجي الفيلم في الحد من تكاليف جعله ناطقاً بالكامل، وهي تكاليف باهظة لا قبل لهم بتحمل أعبائها.
وهكذا ولدت السينما المتكلمة مريضة بداء الاستسهال والتسطيح والجري اللاهث وراء الكسب السريع، وهو داء يرجع إلى الخطيئة الأولى، ألا وهي ميلاد السينما العربية أصلاً في مصر والوطن العربي يئن تحت كعاب جنود الاحتلال الأجنبي.
الماضي المجهول
وبمناسبة قصر الفترة الصامتة من حياة السينما عندنا، لا يفوتني أن أشير هنا إلى ملاحظة ذكية للناقد نور الدين غالي ضمّنها مقاله “السينما المصرية بانعكاساتها وسرابها” المنشور بالعدد 83 من مجلة “جين سينما” الفرنسية.
فهو فيها يرجع فقر المرئيات في “الأفلام المصرية” إلى أن السينما المصرية “تكلمت وهي لاتزال في المهد صبية، فيكاد لا يكون ثمة وجود “لسينما صامتة مصرية” آية ذلك أن “أول فيلم طويل مصري” قد أنتج عام 1927 أي العام الذي نطقت فيه السينما العالمية.
ومن ثم افتقد “المخرجون المصريون” خبرة الفيلم الصامت، وذلك لعدم مرورهم بتجربة إكراه الصمت التي كان لابد أن تجبرهم على التعبير المرئي، فضلاً عن إجراء بحوث في مجالي التشكيل والإيقاع.
المسرح المعلب
وعلاوة على هذا التاريخ الذي يفتقر إلى ماضي صامت، فقد لعب المسرح هو الآخر دوراً في الإساءة إلى السينما والإضرار بها.
ففي البدء مع تكلم السينما وعدم توافر مبدعين سينمائيين، أنيط مصير الفيلم بكتاب سيناريو اعتادوا التعبير بالحوار وليس بالصورة.
وهولاء الكتاب وفدوا في معظمهم إلى السينما من عالم الأدب المسرحي أو الروائي، بل إن بعضهم اكتفى بأن يسجل سينمائياً المسرحيات التي سبق له أن كتبها أو أخرجها دون أن يكلف نفسه عناء حذف أو إضافة همزة أو وصلة.
ولعل يوسف وهبي المثل الصارخ على هذا الغلو.
فمن المعروف عنه أنه استغل شهرته المسرحية باعتباره ممثلاً ومؤلفاً ومخرجاً ومنتجاً في آنٍ واحد، فنقل إلى السينما موضوعات مسرحياته، وهي من نوع الدراما النفسية والاجتماعية الزائفة ذات الأنماط الإنسانية المبسطة.
وهكذا، ومنذ البداية فرض المسرح على السينما أسلوبه في التمثيل وطابعه في الإخراج، وهو وضع ضار كُتب له الاستقرار زمناً طويلاً.
ومن هذا المنطلق وخلال فترة لا تتجاوز العامين (34 – 1935) تم تقنين النمطين الرئيسيين للسينما التجارية في مصر، ألا وهما الفيلم المسرحي تحت رعاية “يوسف وهبي” و”نجيب الريحاني” وغيرهما من أهل المسرح والفيلم الغنائي الذي أرسى المخرج “محمد كريم” قواعده، وكان محمد عبد الوهاب مطرب الملوك والأمراء نجمه الأول بلا منازع.
القاعدة والاستثناء
وعن الظاهرة الأخيرة كتب الناقد “جي هينيبيل”– وهو من المهتمين بالسينما العربية– في مؤلفه “خمسة عشر عاماً من السينما العالمية” (ص 219)، قائلاً ففي مصر هم– يقصد المصريين- مولعون بالأغنية، فالكلمة عند العرب تفوق الصورة في الأهمية لأن الصورة ليست أمراً مستحباً في الإسلام!!
وليس محض صدفة أن الحضارة العربية ترجمت– وهي في أوج مجدها- كل الفلسفة الإغريقية، ولم تترجم المسرح.
وهكذا ظل العالم العربي حصيناً من المسرح الذي لم يستطع التسلل إليه إلا من جحافل الغزو الأجنبي وبخاصة الجنرال بونابرت، ثم انتشر بعد ذلك بفضل السوريين واللبنانيين من أهل الكتاب”.
واستثناء من هذه الأفلام ذات الطابع المسرحي والتي يغلب عليها البكاء والغناء وخروجاً على تقاليدها التي أصبحت من الثوابت، فاجأ كمال سليم الناس بفيلمه الأول الذي أراد له اسم “في الحارة”، وشاءت الأقدار له اسما آخر “العزيمة” (1940).
وهذا الفيلم الاستثناء ذهب نقاد الغرب في شأنه مذهباً واحداً، هو الإشادة به وبالدور الإيجابي الذي لعبه في تاريخ السينما العربية.
وهذا الإجماع في الحماس للعزيمة لم يحظ به فيلم عربي آخر على مدى ثلاثين عاماً أو يزيد.
بعد ذلك كله، فلا عجب إذا ما انصرفت السينما، لا في مصر وحدها بل في أقطار عربية أخرى كسوريا ولبنان، عن تناول أي موضوع جاد يؤدي إلى صحوة وطنية أو نهضة فكرية، بل الأعجب من هذا العجب أن يكون الأمر على خلاف ذلك في ظل احتلال أجنبي ليس له من هدف سوى حجب المعرفة عن الأمة العربية بمزيد من التشدد في الرقابة على حرية الفكر، وبالذات حرية التعبير بلغة السينما.
ومن هنا فليس من باب الصدفة أن أحداً لم يحاول في جميع الأفلام المنتجة في مصر، بل في الوطن العربي بأسره، وحتى عام 1952 حين بدأ “أحمد بدرخان” تصوير فيلمه عن حياة الزعيم مصطفى كامل، لم يحاول أحد أن يعرض لكفاح الأمة العربية ضد المحتل الأجنبي، وضد الظلم الاجتماعي.
وفي مواجهة تصاعد الحركة الوطنية المعادية للاستعمار عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية باندحار الفاشية- وقبل الحرب العربية- الإسرائيلية الأولى بقليل– لجأت الدوائر الحاكمة إلى سلاح الحد من حرية التعبير، لاسيما في مجال السينما.
وإذا كانت مصر مرآة الوطن العربي كما يقول بحق “فؤاد عجمي” في كتابه “المأزق العربي” فإن التعليمات التي أصدرتها إدارة الدعاية والإرشاد الاجتماعي في فبراير 1947 بغرض تقنين ما جرى عليه العمل رقابياً في مصر فيما يتعلق بالسينما، هذه التعليمات المتشددة التي اشتملت على أربعة وستين محظوراً، كان لابد أن يكون لها انعكاساتها على السينما في الأقطار الأخرى من الوطن العربي.
وفي ضوء هذه المحظورات كان أمراً مقضياً أن تنصرف السينما على امتداد الوطن الفسيح عن معالجة أي موضوع اجتماعي أو سياسي يمس من قريب أو بعيد صراع المعذبين في أرض الوطن ضد الاحتلال والخوف والجوع.
فجر جديد
كل ذلك كان قبل فجر الثالث والعشرين من يوليه، والتحول بمصر من ملكية إلى جمهورية مستقلة متحررة من رق الاستعمار.
ومع هذا الفجر ظهر جيل جديد من المخرجين الشبان كصلاح أبو سيف وتوفيق صالح ويوسف شاهين وهنري بركات، حاول في بعض أفلامه “كالفتوة” “ودرب المهابيل” “وباب الحديد” “والحرام” أن ينتقد الأوضاع الاجتماعية.
 وتدعيم التيار الجاد في السينما بانشاء معهد عال لها ومراكز فنية للأفلام التسجيلية والتجريبية، ونواد للتعريف بالفن السابع باعتباره الدرجة الأسمى التي وصل إليها الفن في تطوره الصاعد.
وتدعيم التيار الجاد في السينما بانشاء معهد عال لها ومراكز فنية للأفلام التسجيلية والتجريبية، ونواد للتعريف بالفن السابع باعتباره الدرجة الأسمى التي وصل إليها الفن في تطوره الصاعد.
ومع ذلك ظل النقد الذي انطوت عليه أفلام هذا الجيل الذي ظهر مع الفجر، ظل محصوراً في وصف الأمراض الاجتماعية لا يتجاوزها إلى اقتراح الوسائل السياسية لعلاجها وإحداث التغيير المنشود.
وفوق هذا بقى عدد هذه الأفلام الجادة قليلاً تائهاً في خضم أفلام غريبة عن أرض الوطن لا تكترث بتراثنا العاطفي والاجتماعي والانساني بل قل تستهر به وتشهّر.
فيلم وزلزال
وبداهة ما كان لهذا الوضع الذي تحول مرة أخرى بواقع السينما العربية إلى مستنقع راكد أن يدوم، فبعد مرور أربعة عشر عاماً على الثالث والعشرين من يولية انقض على هذا الواقع المستنقع فيلم “معركة الجزائر” (1966).
ففي مهرجان فينسيا خرج هذا الفيلم متوجاً بالأسد الذهبي جائزته الكبرى، وكذلك بجائزة النقد الدولي.
والوقع الصاعقي الذي أحدثه في الوطن العربي حيثما عرض أو سمع عنه، هذا الوقع، إنما يرجع إلى أنه قادم من أول أرض عربية تحرر من الاستعمار بفضل ثورة شعبية مسلحة، هذا إلى أنه فيلم سياسي من ألفه إلى يائه، فضلاً عن أنه يعرض للثورة في الجزائر العاصمة بأسلوب جمالي يدفع المتلقي إلى فهم يؤدي إلى العمل على تغيير الواقع.
وعلى كل حال، فقد كان من أثر “معركة الجزائر” أن اهتزت السينما في الوطن العربي على وجه أدى إلى تدعيم الاتجاه نحو سينما واقعية جادة. ولا أقول سياسية.
وقبيل زلزال الخامس من يونية لعام 1967، وبعدها تلاحقت الأفلام السياسية داخل مصر وخارجها، وظهر في الساحة السينمائية العربية، ولأول مرة، ما يسمى بالمخرج السياسي، ولعل خير مثل على ذلك “برهان علوية” صاحب “كفر قاسم”.
وبحكم البداية، لم تكن جميع الأفلام السياسية إيجابية في مضونها، فبعضها كان ذا أثر سلبي إذ لعب دوراً من خلال كشف أخطاء ونقائص الأجهزة الحاكمة، وبخاصة الاتحاد الاشتراكي العربي في التشكيك في ثورية نظام عبد الناصر والنظم المماثلة له في أنحاء الوطن العربي، مما مهد الطريق لنكسة جديدة في مسار حركة التحرر الوطني والاجتماعي أدت إلى تفاقم أمر التشتت العربي.
وعن الدور الذي لعبه أحد هذه الأفلام “ميرامار” في هذا الخصوص ألقى صاحبه “كمال الشيخ” بعض الضوء بقوله في حديث له أن الفيلم لم يحصل على ترخيص الرقابة بالعرض إلا بعد أن شاهده نائب رئيس الجمهورية وقتذاك وأجازه مبدياً إعجابه الشديد.
متمردون ومخدوعون
فإذا ما انتقلنا إلى الأفلام السياسية التي لعبت دوراً إيجابياً في كشف الواقع ومواجهته بغرض التمرد عليه وتغييره إلى ما هو أفضل لوجدناها لا تزال نادرة.
وأهمها عندي، وذلك على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، رائعتا توفيق صالح “المتمردون” و”المخدوعون”. والأولى تم إخراجها في مصر بفضل القطاع العام، أما الثانية– فهي مستوحاة من قصة للأديب غسان كنفاني– فلم يستطع إخراجها إلا في سوريا، وأيضاً بفضل القطاع العام ثم “كفر قاسم” لبرهان علوية من لبنان “وصور من مذكرات خصبة” لصاحبه ميشال خليفة من فلسطيين المحتلة.. و”عمر قتلته الرجولة”.. لصاحبه “مرزاق علواش” من الجزائر و”ليلة حساب السنين” (المومياء 1969) رائعة شادي عبد السلام، وعندها أقف قليلاً.
السينما الغائبة
عندما كُتب لنقاد الغرب أن يشاهدوها في مطلع السبعينيات دفع الحماس نفراً منهم إلى أن يشبه “شادي عبد السلام” “بساتيا جيت راي” ويتنبأ له بأن يكون صاحب تأثير خلاق على “السينما المصرية” قريب من تأثير المخرج البنغالي الشهير على السينما الهندية.
غير أن “جون راسل تايلور” الناقد الإنجليزي ذهب، رغم فيض حماسه لشادي وفيلمه، مذهباً على عكس ذلك تماماً.
ففي الدراسة التي خصّ “ساتيا جيت راي” بها في مؤلفه القيّم “مخرجون واتجاهات” كتب في وصف رائعة شادي قائلاً “إنها عمل فردي يتسم بالغرابة والخروج على المألوف، وأغلب الظن أنه لا يعكس سوى مواهب مبدعه.
وفي ظني أن “راسل تايلور” كان في تقويمه لفيلم “ليلة حساب السنين” وأثره أكثر جنوحاً إلى الصواب من أغلب النقاد.
فهو، وبعد انقضاء زهاء عشرين عاماً على إخراجه، لم نر فيلماً أنتج من أفلام، وهي تعد بالمئات، شبيهاً له لا من قريب ولا من بعيد.
بل أن صاحبه امتنع عليه حتى اختفائه بالموت قبل شهور، أن يخرج من بعده فيلماً روائياً طويلاً آخر.
وإذن فليس غريباً إذا ما استخلص من ذلك أن رائعة شادي الشهيرة بالمومياء استثناء.
وفي عالم الأطياف الاستثناء لا مستقبل له، وبخاصة إذا كان الأمر متعلقاً ببناء صرح مدرسة وطنية سينمائية.
وعن مأساة المخرج الراحل ومعها مأساة السينما في الوطن العربي كتب الناقد الإنجليزي كين ولاشين في المجلد السادس من موسوعة الأفلام قائلاً “المومياء لشادي عبد السلام هو أشهر فيلم في فترة السبعينيات ولكن مخرجه لم يبدع أفلاما بعد ذلك، الأمر الذي يعكس حالة الصناعة المصرية”.. وكفى..!!
