أختتم قبل بضعة أيام، وفي نفس الوقت، موسم العروض الاوبرالية، فى كل من المسرح الصغير بالقاهرة، ومسرح المترو بوليتان بنيويورك
وكان الاختتام باوبرا “سيندريللا” وتنطق باللغة الايطالية “شينيرنتولا” !!

وهى من إبداع “جياتينو روسيني” (1792 1868)، ذلك الموسيقار
الايطالى الفذ الذى أبدع خلال عقدين فقط من عمره، تسعة وثلاثين عملا أوبراليا، أخص بالذكر من بينها “حلاق اشبيلية”، “عطيل”، “اليزابيث.. ملكة انجلترا”، “الايطالية فى الجزائر”، “موسى فى مصر” و “ويليم تل” التى تعد آخر ابداعاته الاوبرالية، اذ بعدها اكتفى بتأليف انواعا موسيقية أخري، من بينها اذكر اعمالا لموسيقى الحجرة، واعمالا للبيانو المنفرد، مثل مجموعته التى اطلق عليها اسم “خطايا الشيخوخة” واثناء الربع الأول من القرن التاسع عشر، حققت اعماله الاوبرالية نجاحا غير مسبوق أهله لأن يكون واحدا من اشهر الموسيقيى اوروبا، وبخاصة فى مجال فن الاوبرا، واكثرهم جاها وثراء
كما اهلت ذلك الفن لان يكون ان أكثر فنون ذلك الزمان جماهيرية، بفضل جمعها فى صعيد واحد سابقا بذلك فن السينما، وممهدا له فيما هو آت من أعوام.
واوبرا “سندريللا” تعد واحدة من أشهر أعمال “روسيني” الاوبرالية وأكثرها شعبية.
ابدعها ولما لم يكن له من العمر سوى خمسة وعشرين عاما وكان أول عرض لها على خشبة مسرح “فالية” بمدينة روما (1817).
وكما هو معروف فحكاية “سيندريللا” من صنع الخيال وبدءا من نشرها تعلقت القلوب ببطلتها على نحو ذاعت معه شهرتها بحيث كاد أن يكون اسمها على كل لسان.
وما لبثت أن ترجمة حكايتها إلى لغة الاوبرا فلغة البالية، بواسطة الموسيقار الروسى “سيرجييى بروكوفييث” ومع اختراع السينما، قبل بداية القرن العشرين بقليل، جرى ترجمة حكاية “سيندريللا ” إلى لغة السينما فى أكثر من فيلم
وبطبيعة الحال كان لافلام أستديوهات ديزنى بهوليوود الصدارة فى هذا المجال
فعلى امتداد النصف الثانى من القرن الماضى انتجت تلك الاستديوهات ثلاثة أفلام من بينها اثنان من نوع الكرتون أى الصور المتحركة.
أما ثالثها، وصاحبة المخرج الانجليزى “كينيث براناج” فلم يعرض بعد، والراجح طرحه للعرض فى مستهل العام القادم ومن بين ممثلاته اللاتى اسندت اليهن الادوار الرئيسية “حيلن بونام كارتر” و “كيت بلانشيت” السابق لها الفوز، قبل بضعة اشهر بجائزة أوسكار افضل ممثلة رئيسية عن ادائها فى فيلم “ياسمين الزرقاء” (2014) لصاحبه المخرج البارع “وودى الن”
وحكاية “سندريللا” كما تناولها “روسيني” فى الاوبرا تمس ادق المشاعر الانسانية من خلال حبكة درامية، روعى فى كتابتها أن تكون احداثها واقعية ليس فيها من شطحات الخيال إلا أقل القليل فكان أن كادت تخلو الاوبرا من آثار العالم المسحور التى تعج بها حكاية “سندريللا” كما الفناها مكتوبة أو مترجمة إلى لغة البالية أو السينما أو غير ذلك من اللغات.
فلا العربة الزجاجية بجيادها المطهمة التى تجئ بعصا سحرية إلى حيث تقيم “سيندريللا” لتذهب بها إلى قصر الأمير حيث الحفل الراقص، تتنافس فيه الحسنوات على جذب نظر صاحب القصر، عسى ولعل يقع اختياره على أحداهن لعقد قرانه عليها ولا الحذاء الزجاجى الذى تفقد “سندريللا” أحدى فردينته وهى تهرول مغادرة الحفل، قبل منتصف الليل ولا أى شئ آخر له صلة بمفردات الخيال الجامح حيث تملك بعض الشخوص قدرات سحرية، بعيدة عن الواقع الذى يعيشه الناس.
فاحداث الاوبرا تقع فى مكان واقعي، وتحديدا مدينة “ساليرنو” الساحلية فى جنوب ايطاليا وبطلها ليس مجرد امير شاب وسيم، بل أمير تلك المدينة الصغيرة، المطلة على البحر.
وختاما، فما يراد قوله أن اوبرا سندريللا على نقيض النسخ المختلفة لحكاية سيندريللا مكتوبة اكانت أم مرئية أنها باختصار قد انفردت بواقعيتها على غير المألوف مما هو معروف عن حكاية رومانسية يغلب عليها الخيال.


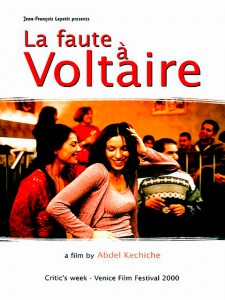 الاوروبية، لم يعرض للظروف المعيشية التى يعانى منها من غادروا أوطانهم، بحثا عن حياة انسانية أفضل.
الاوروبية، لم يعرض للظروف المعيشية التى يعانى منها من غادروا أوطانهم، بحثا عن حياة انسانية أفضل.