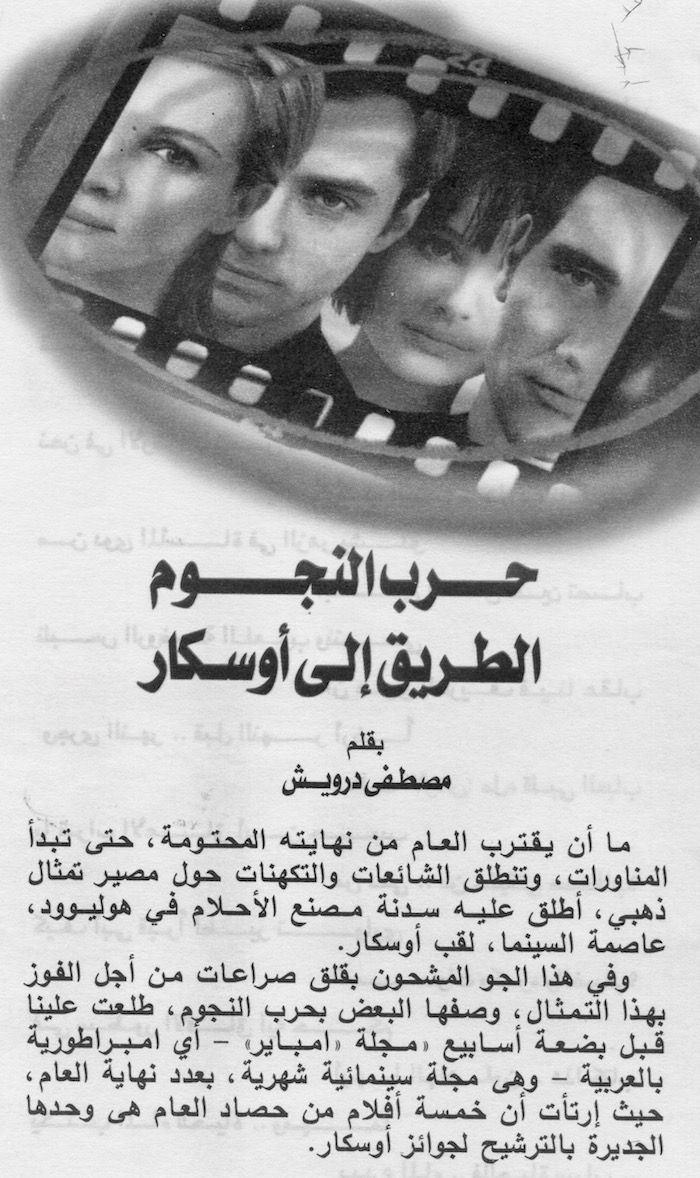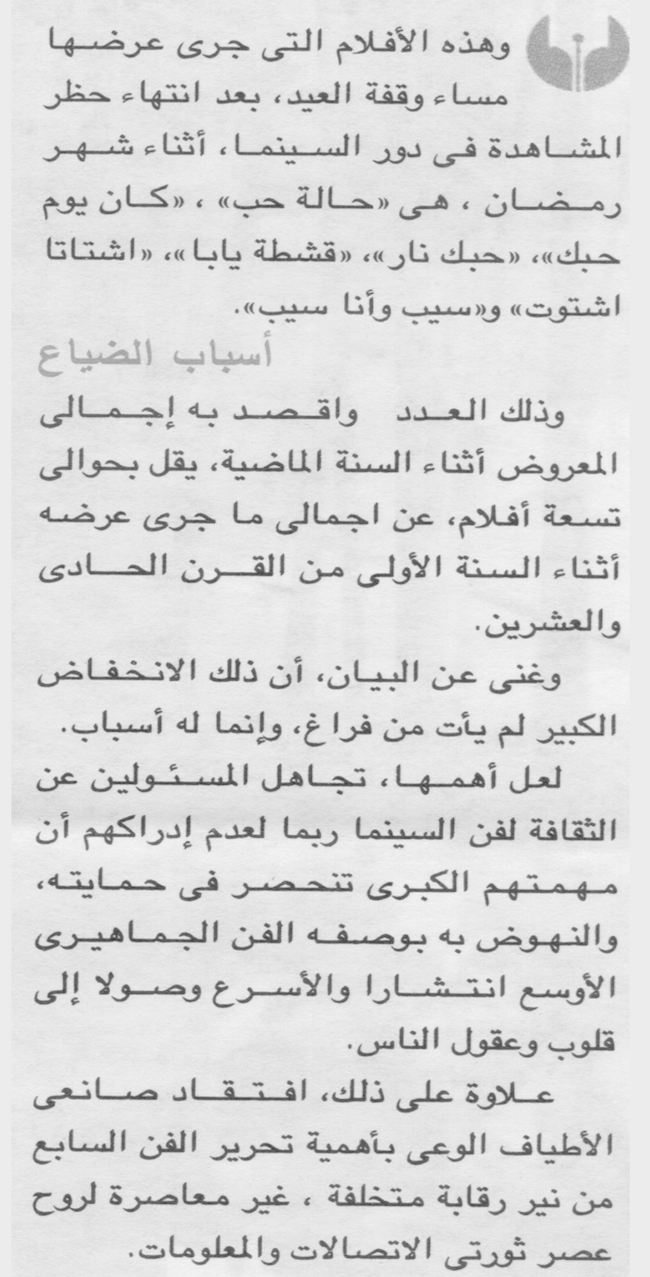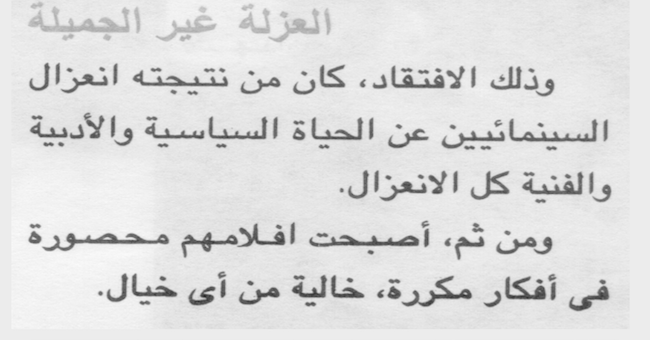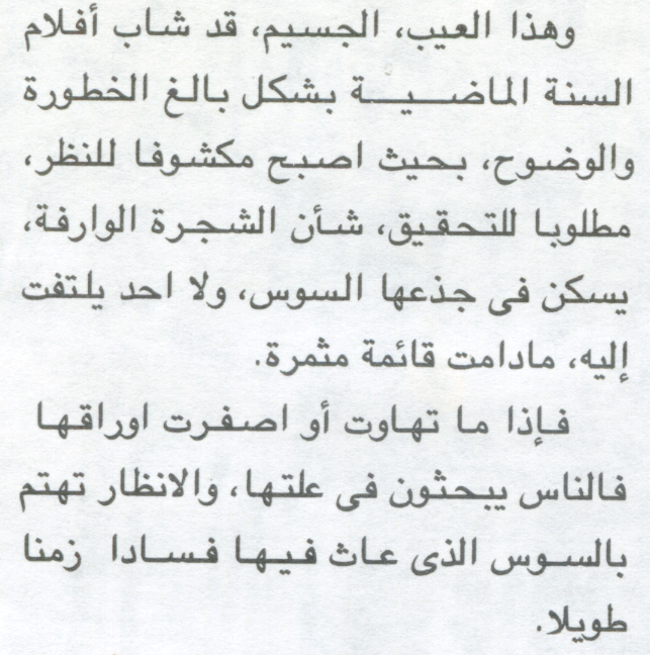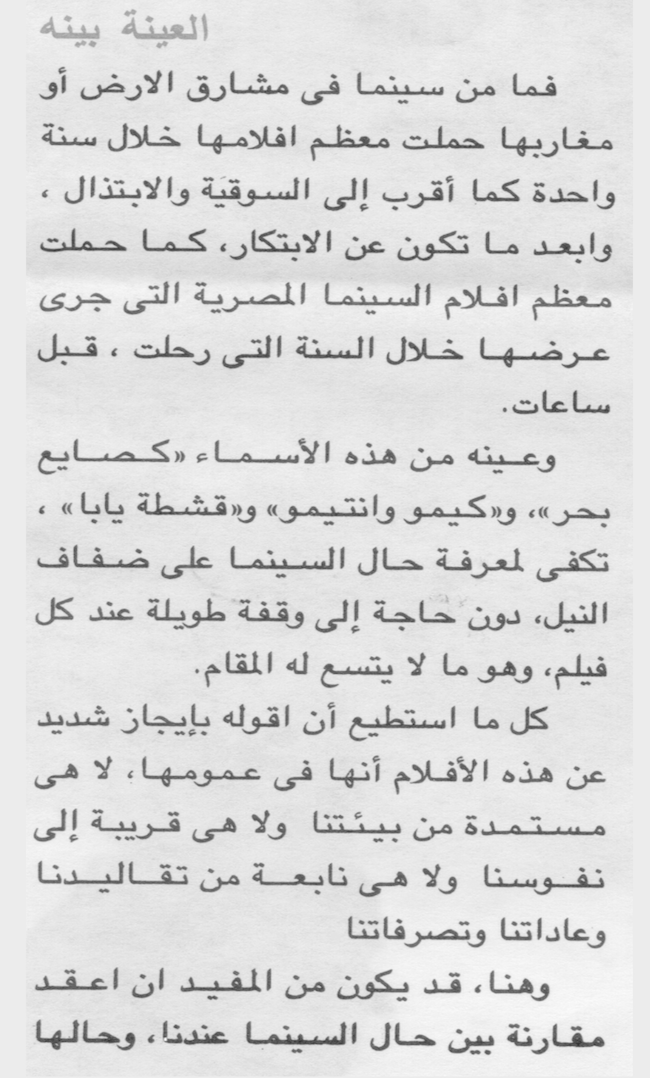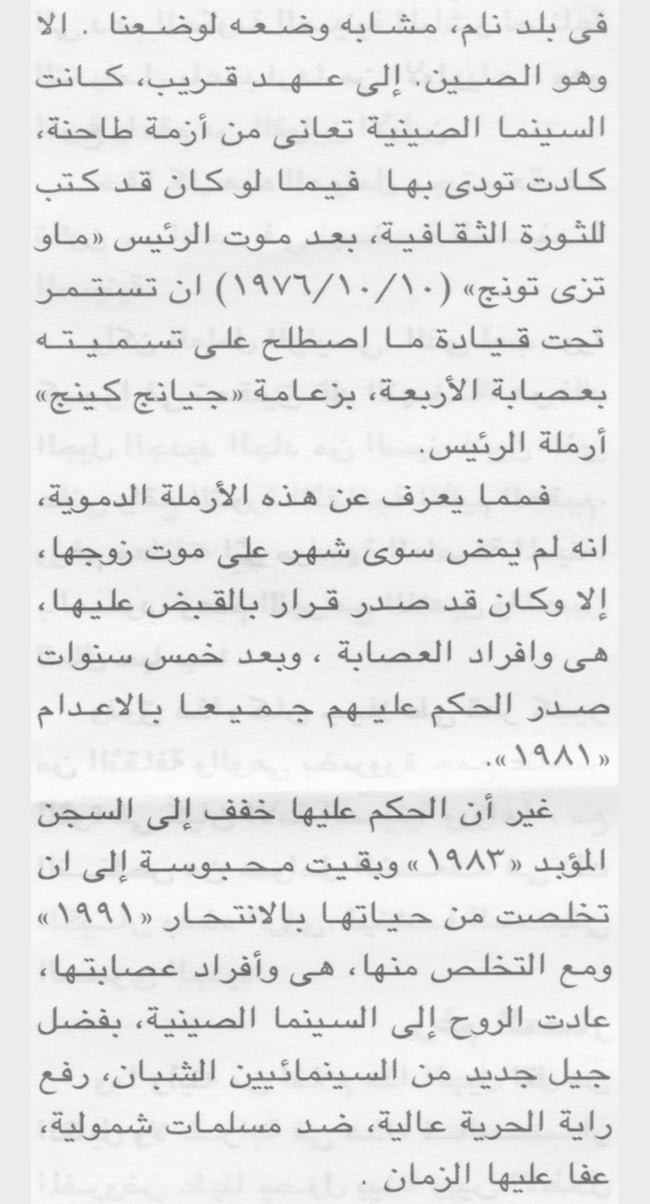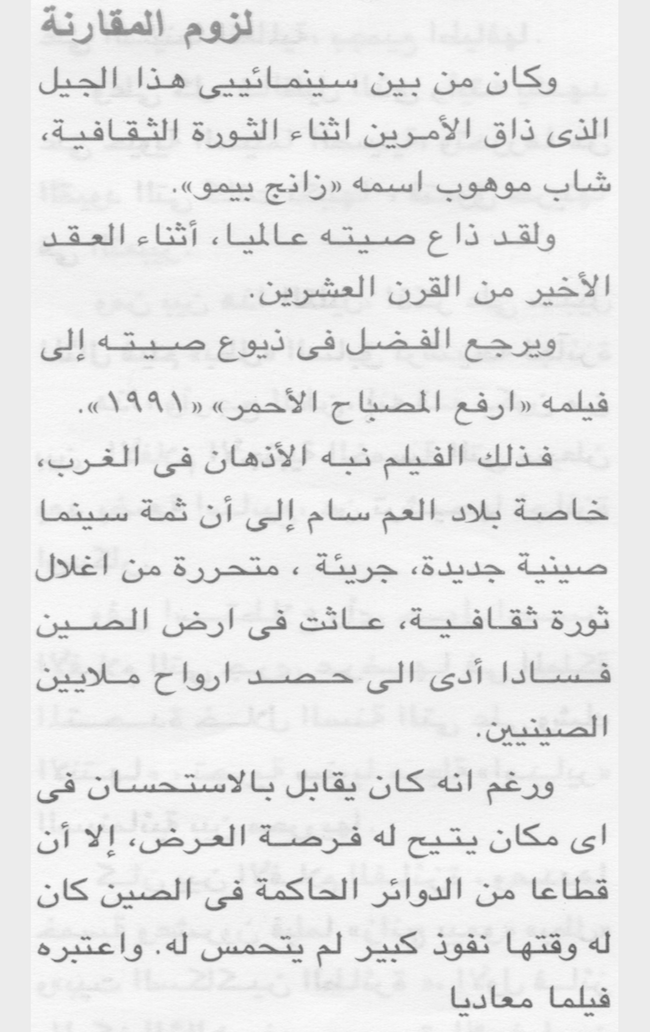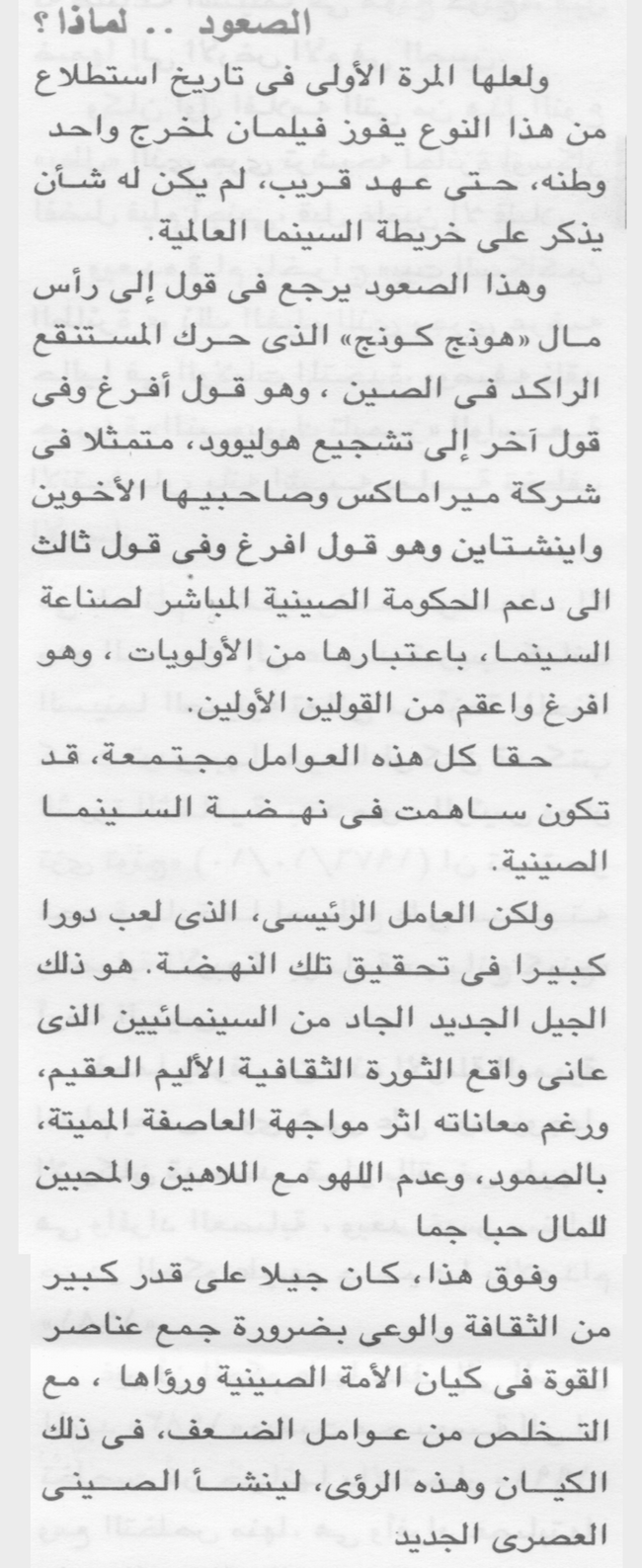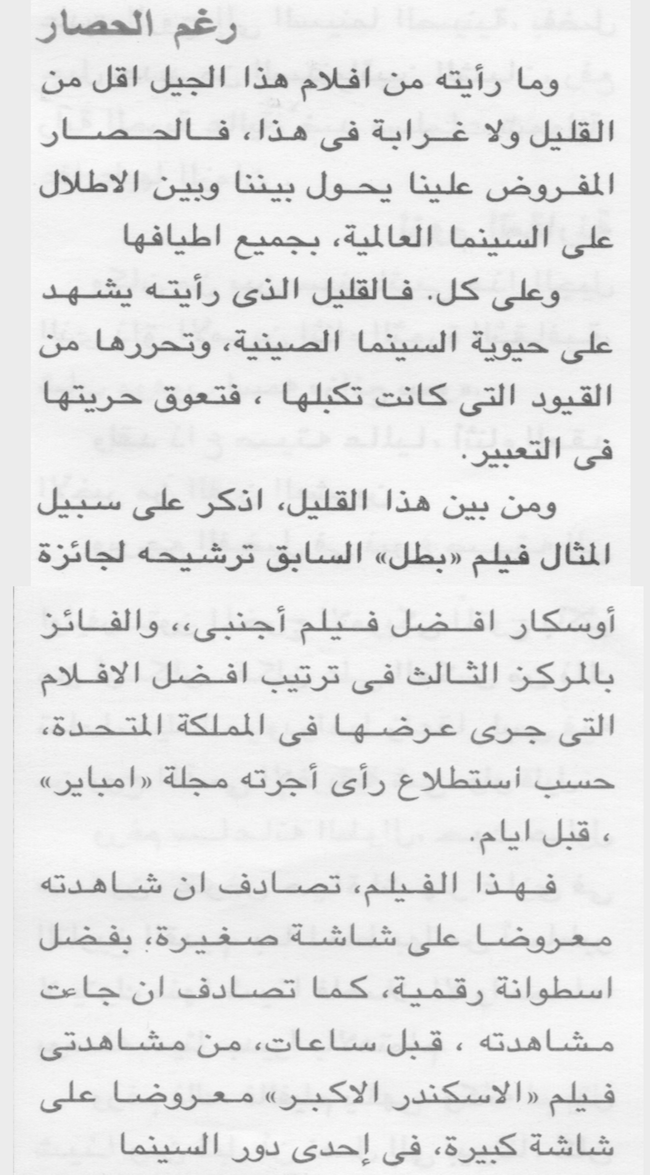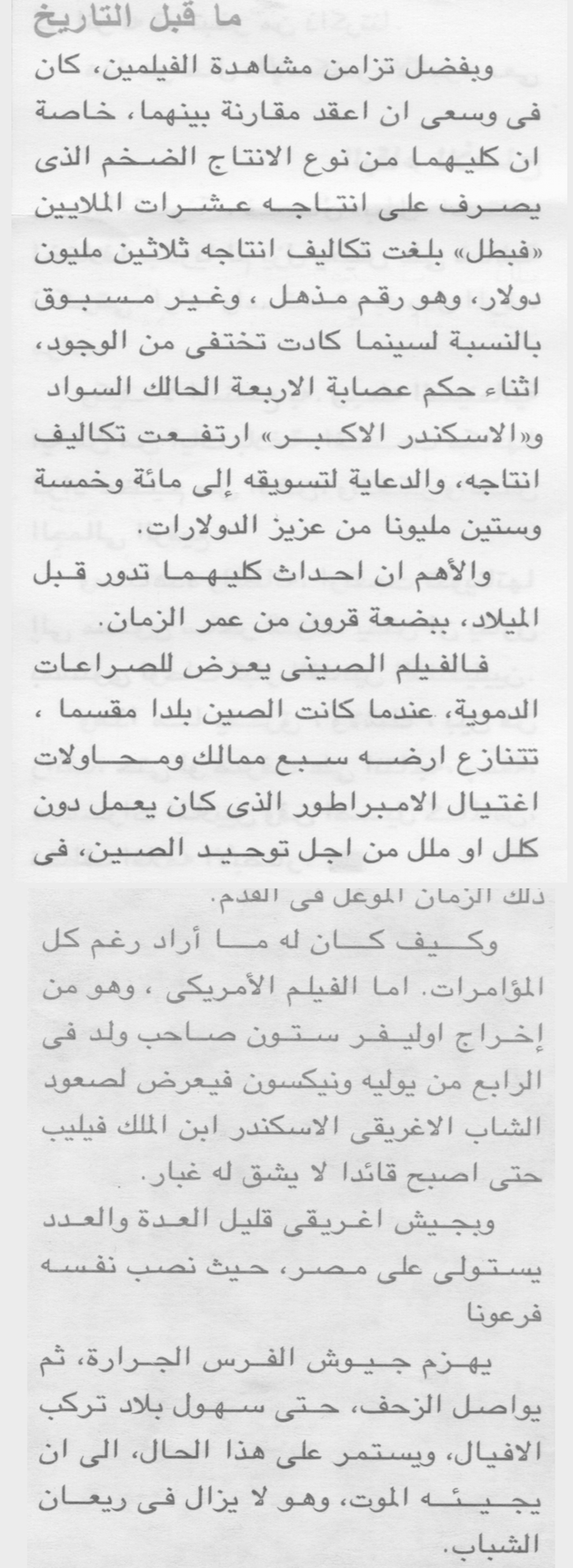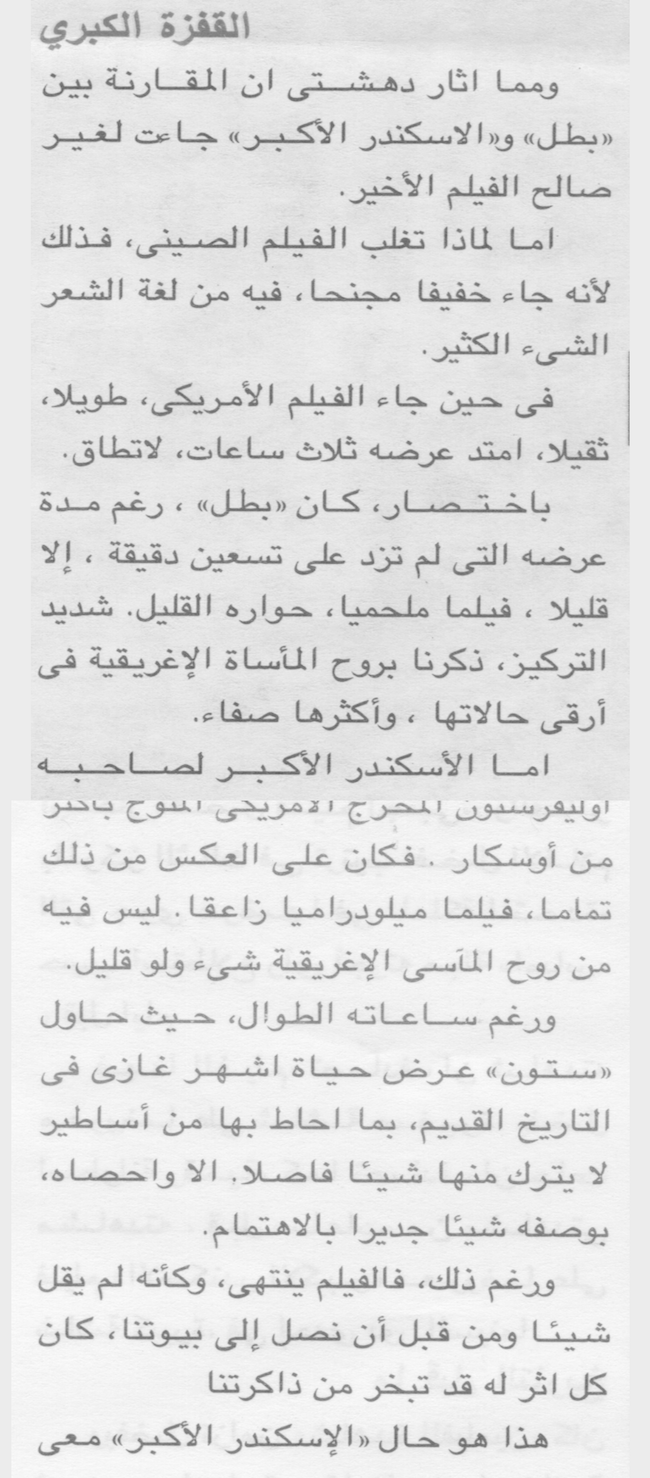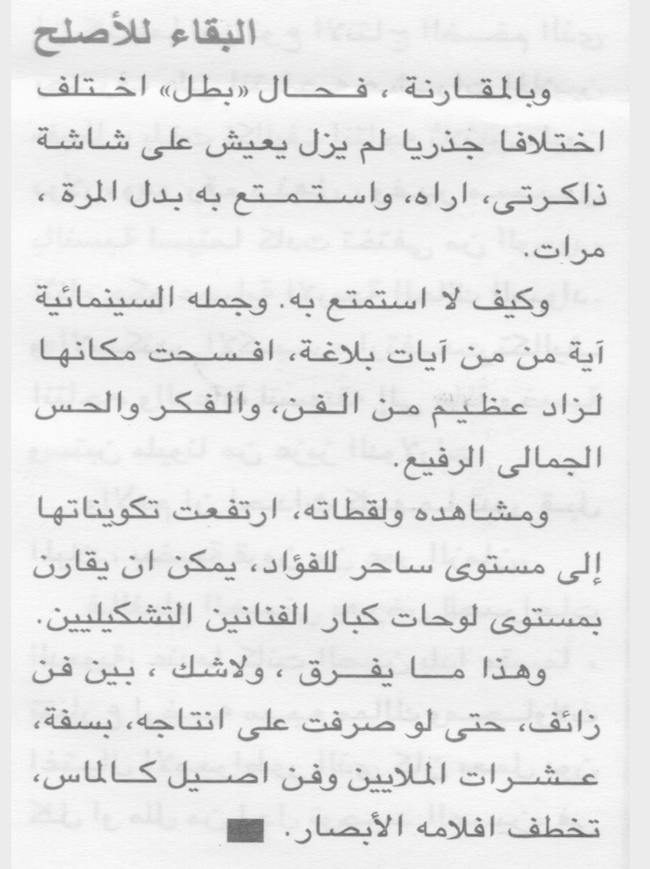التصنيف: دار الهلال
رحلة مع آفاق السينما من مصر إلي الصين
ضياع الوعي بأهمية السينما
لعلها المرة الأولى في تاريخ السينما على أرض مصر، وربما في تاريخها على أية أرض أخرى، أن يحرم جمهور السينما من مشاهدة الأفلام على شاشات كبيرة، لمدة قاربت شهراً من عمر الزمان وذلك تنفيذاً لقرار مفاجئ بإغلاق أبواب جميع دور السينما بطول وعرض البلاد.
والأبواب لم تغلق بسبب حدث جلل، كهزيمة ساحقة ماحقة في ساحة الوعي، أو كارثة طبيعية نشرت الخراب، وأودت بحياة آلاف العباد، أو موت رئيس محبوب، بينه وبين العقول والقلوب، جذب ووصال.
وإنما اغلقت لسبب آخر، منبت الصلة بمثل تلك الأحداث الجسام، ألا وهو ظهور هلال رمضان في كبد السماء، مبشراً ببدء أيام وليالي الشهر الفضيل.
فلقد تصادف، مع ظهور الهلال أنني أخذت أبحث في جريدة ذات جلال في كل العهود، عن دار سينما يعرض على شاشتها أحد الأفلام التي كان لزاماً عليّ أن أشاهده.
وفيما أنا منهمك في البحث في البحث لفت نظري إعلانات صغيرة، مرصوصة جنبا إلى جنب في الصفحة الثانية من تلك الجريدة ذات الجلال والمخصص أسفلها لإعلانات دور السينما والملاهي الأخرى.
ولدهشتي كانت جميعها، ودون استثناء لا تقول إلا شيئاً واحداً. وهو أن دور السينما بالقاهرة والأسكندرية في أجازة بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وهكذا، وجدتني، وعلى غير المعتاد، محروماً من مشاهدة الفيلم الذي كنت أزمع الكتابة عنه ومحروما من متعة مشاهدة أي فيلم آخر في دور السينما طوال شهر بالتمام. وكم ترحمت لحظة الدهشة على عصر جميل كانت الأفلام المعروضة، أيامه على شاشات دور السينما، حديث الناس من الخليج إلى المحيط.
ومن الأكيد أنه نتيجة غلاق أبواب دور السينما، لبث الجمهور في مصر على غير عادة محروماً من ممارسة حقه في الاستمتاع بالأفلام التي يرغب في مشاهدتها وبحكم اللزوم أسير مسلسلات وليدة فكر فقير، الأدوار الرئيسية فيها، يؤديها ممثلون وممثلات شاخوا، فضاق بهم الناس إلى حد مقاطعة أفلامهم.
عمالقة تتأقزم
وكأن القدر أراد لهم نهاية أعمتهم عن سلوك الطريق الذي ينقذ سمعتهم، وسمعة تليفزيون، قيل عنه في يوم من الأيام أنه ولد عملاقاً. والآن لا حديث إلا عن تأقزمه وعجزه عن معاصرة عصر ثورتي الاتصالات والمعلومات.
فإذا بهم، أي نجومنا، يكبر عليهم الاعتزال الكريم فيغزون الشاشة الصغيرة بكروش بارزة ووجوه مشدودة منفوخة وباروكات قبيحة متعددة الألوان وصدور وأذرع عارية إلا من حمالات لا تستر شيئا.
والغريب أن هذه المسلسلات التي فرضت حصاراً على الناس لا يستطيعون الفكاك منه، معظمها لمخرجين كان لهم شأن كبير في عالم صناعة الأفلام، أهدروه بالقفز سريعاً من سفينة السينما إلى بر أمان مسلسلات، أغلبها لا يقول إلا تفاهات تحت إغراء ذهب تليفزيون معز، مذل، لمن يشاء بغير حساب.
ولأن قرار إغلاق أبواب جميع دور السينما مخالف لطبائع الأمور فقد تراجع عنه مصدروه، بعض الشيء، والشهر الفضيل على وشك الرحيل.
حب ولعب
ومع مجيء العيد السعيد فتحت دور السينما أبوابها لتستقبل ستة أفلام مصرية من بينها ثلاثة القاسم المشترك الذي يجمعها في صعيد واحد هو كلمة حب.
وهذه الأفلام “حالة حب”، “كان يوم حبك”، و”حبك نار”.
أما الأفلام الثلاثة الأخرى فأسماؤها الهازلة “قشطة يابا”، “أشتاتاً أشتوت”، و”سيب وأنا سيب” إنما تدل على واقع سينمائي أشدّ هزلاً وهزالاً!
هذا وطابع أفلام العيد الرقص والغناء فتامر حسني يشارك هاني سلامة بطولة “حالة حب” و”خالد سليم” بطل “كان يوم حبك” دون شريك و”مصطفي قمر” يلعب دور روميو في “حبك نار” المأخوذ قصته بتصرف مخل من مسرحية شكسبير مع استبدال الأسكندرية بڨيرونا.
و”مصطفى كامل” وهو الآخر مطرب قد أسند إليه المخرج “عاطف شكري” بطولة “قشطة يابا”.
و”مدحت صالح” المطرب المعروف بطل “أشتاتاً أشتوت” لصاحبه المخرج “عمر عبد العزيز”.
جيل جديد
وفيما عدا المخرج الأخير فمخرجو الأفلام الخمسة الأخرى إما ليس لهم رصيد سابق من أفلام روائية طويلة مثل “سعد هندواي” صاحب “حالة حب” و”عاطف شكري” و”وائل شركس” صاحب “سيب وأنا سيب”.
وإما رصيدهم لا يعدو أن يكون فيلماً يتيماً مثل “إيهاب لمعي” صاحب “كان يوم حبك” و”إيهاب راضي” صاحب “حبك نار”.
“فلمعي” له فيلم سابق “نظرة عين” (2003) و”راضي” ليس له هو الآخر سوى فيلم واحد أخرجه قبل خمسة أعوام “فتاة من فلسطين” عن قصة للأديب “أحمد المنسي قنديل”.
والأفلام الستة غارقة في التهريج أو الافتعال أو الاثنين معاً، شأنها في ذلك شأن معظم الأفلام التي جرى عرضها أثناء السنة التي على وشك الرحيل.
أيام لها تاريخ
وعند أحد هذه الأفلام وهو”يوم الكرامة” أقف قليلاً لأقارن فشله بنجاح فيلمين أجنبيين، أحدهما ألماني والآخر أمريكي من انتاج مصنع الأحلام.
أما لماذا المقارنة بين الأفلام الثلاثة فذلك لأن أيّاً منها يدور وجوداً وعدماً حول يوم له تاريخ في حياة كل شعب من شعوب البلاد الثلاثة، مصر ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وليس من شك أنه من بين الأيام التي لها تاريخ عندنا يوم 26من أكتوبر لعام 1967، ذلك اليوم الذي تم فيه إغراق المدمرة الإسرائلية “إيلات” فبفضله عادت روح الثقة لنا “نحن المصرين” حتى إلى أكثر الناس تشاؤماً وتشككاً في قدرتنا على تجاوز كابوس هزيمة ساحقة لن ينساها التاريخ.
و”يوم الكرامة “للمخرج”علي عبد الخالق” صاحب فيلمي “أغنيه على الممر” و”العار” مداره الأحداث التي مهدت والبطولات التي التي أدت إلى إغراق “ايلات” وأدخلت يوم اختفائها في قاع اليمّ في عداد الأيام التي لها التاريخ.
ومما شككت، وأنا أشاهده في دار سينما شبه خالية من المتفرجين، أن حظه من النجاح لن يكون كبيراً ولكن لم يخطر ببالي قط أن مثل هذا التغير قد يكون بعيداً عن الصواب بعد المسافة بين الأرض والسماء.
فلدهشتي لم يحقق الفيلم أي نجاح بل كان والحق يقال واحد من أفشل أفلام الصيف، إذ كان أقلها تحقيقاً للإيرادات.
لكل سؤال جواب
وما أن أفقت من الدهشة، حتى أخذت اتساءل لماذا كان هذا الفشل غير المسبوق لعمل سينمائي جاد يعرض لأحداث يوم كله أمجاد؟
ولم أصل إلى جواب إلا بعد مشاهدة فيلمين أحدهما “معجزة برن” لصاحبه المخرج الألماني”سونكي فورتمان” والآخر”سيبسكويت” لصاحبه المخرج الأمريكي “جاري روس” الذي سبق له وأن أمتعنا بفيلمه الأول “بلسنتفيل”.

فكلاهما مداره أحداث وقائعها جرت بالفعل سواء في ألمانيا، وذلك بعد ألقت الحرب العالمية الثانية سلاحها بتسعة أعوام، أو في الولايات المتحدة، أثناء عقد الثلاثينات والعاصفة المميتة، عاصفة النازية، تنذر بنار حامية، اندلعت ألسنتها في أواخر سنة 1939.
والفيلم الألماني يعرض ليوم انتصار الفريق القومي الألماني لكرة القدم في مباراته الفاصلة بمدينة “برن” السويسرية، مع الفريق القومي المجري الدائم الانتصار وخروجه بفضل معجزة دحرة الفريق الأخير، متوجاً بكأس العالم.
ويكشف من خلال تكوين ذلك الفريق وتدريبه، ومن خلال صبي مولع بالكرة وعائلته الفقيرة، معاناة شعب لم يزل يعيش عار هزيمة سحقت وطنه سحقاً إلى أن جاء اليوم الموعود، يوم الانتصار على الغول المجري فبفضله عادت للشعب الألماني روح الثقة بالنفس وإرادة إزالة آثار هزيمة كلها عار وشنار، يقال أن المستشار الألماني الهر شرويدر بكى والفيلم يقترب من الختام.
أما الفيلم الأمريكي، فيعرض لسيرة “سيبسكويت” كما كتبتها “لورا هيلينبراند” في مؤلف ضخم ونال من النجاح والاستحسان الشيء الكثير.
قصة حصان ورئيس
و”سبيسكويت” من فصيل الخيل حصان تعلقت به قلوب الناس وأفئدتهم بطول وعرض الولايات المتحدة، حيث كان لا حديث في المجالس والإذاعات إلا عنه، والأمل في وصوله إلى الدور النهائي وفوزه على الجياد الأخرى في سباق الخيل الأخير.
أما لماذا تعلقت به الأفئدة والقلوب فذلك لأنه أولاً حصان غلبان مستواه لا ينهض إلى المستوى الرفيع المتوافر في الجياد الأخرى.
وكذلك حال ممتطيه الجوكي الذي نجح في ترويضه (يؤدي دوره تومي ماكجوير)، فلقد كان وياللعجب نصف ضرير وثانياً لأن الشعب الأمريكي كان وقتذاك، يعاني هو الآخر من آثار أزمة اقتصادية طاحنة أخذت بخناقه وحتى يتخلص منها، انتخب لرئاسة الجمهورية رجلاً معاقاً مصاباً بمرض شلل الأطفال.
ولو كتب للحصان المحبوب، والجوكي مروضه وكلاهما شبه معاق، الانتصار في السباق.
فلم لا ينتهي الأمر بالرئيس المشلول منتصراً هو الآخر في المعركة الدائرة من أجل إعادة الروح إلى الاقتصاد بانتشال المجتمع الامريكي من هاوية الكساد.
وعندما تحققت المعجزة، يوم انتصار الحصان الغلبان في السباق، أحيا انتصاره هذا أمل الشعب الأمريكي في غد مغرد تحت قيادة فرانكلين د. روزفلت الرئيس المصاب بشلل الأطفال.
وهكذا دخل هذا اليوم في عداد الأيام التي لها تاريخ.
سر الفشل
يبقى لي أن أقول أن هذه المزاوجة بين الخاص والعام، مع الاهتمام بتفاصيل الحياة اليومية في زمن الحدث افتقدها “يوم الكرامة” على نحو كان لابد أن يؤدي إلى فشله فشلاً ذريعاً.
وأرجح الظن أن هذا الافتقاد إنما يرجع إلى داء الاستسهال، ذلك الداء العضال الذي لن ينجح سينمائيونا في التخلص منه إلا بعد كثير من المشقة والعناء!.