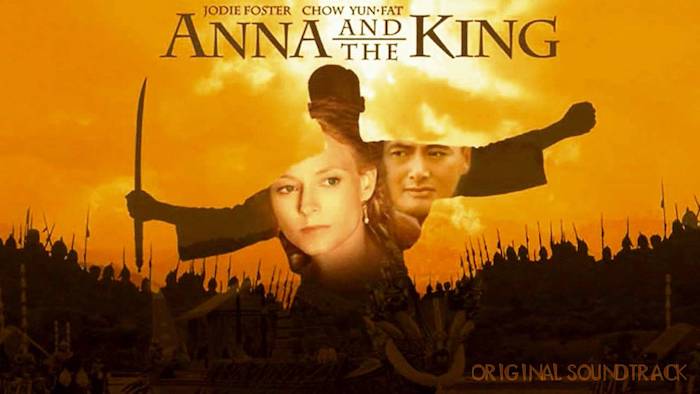وأقصد بالأمريكي العليل “توم ريبلي” ذلك الفتى، أو بمعنى أصح، القاتل الموهوب في آخر عمل سينمائي أبدعه خيال المخرج البريطاني، المنحدر من أصل إيطالي “انطوني منجيللا”، صاحب “الانجيزي العليل” الفيلم الفائز، قبل أربعة أعوام بتسع جوائز أوسكار.
وفيلمه الأخير”السيد ريبلي الموهوب” وهو رابع أفلامه، مأخوذ عن قصة بنفس الاسم للأديبة الراحلة “باتريشيا هايسميث”. ولقد سبق للمخرج الفرنسي الراحل “رينيه كليمون” أن قام قبل واحد وأربعين عامان بترجمتها إلى لغة السينما في فيلم أسماه “شمس الظهيرة”.
ولعله من أنجح الأفلام التي أنتجتها السينما الفرنسية في ذلك الزمان.
ونجاحه يرجع، ولا شك، إلى إتقان المخرج، وروعة أداء النجم “آلان ديلون” لدور “ريبلي” المخادع الوسيم.
والآن، وبعد كل هذه الأعوام، وأيامها التي ذهبت كالأحلام، تعود شخصيات تلك القصة الشيقة إلى الشاشة الفضية، حيث نراها حيّة، مرسومة بكاميرات “جون سيل” مدير تصوير “الإنجليزي العليل”.
و”ريبلي”، ويؤدي دوره النجم “مات دامون”، لا يعاني من علة جسدية، مثل تلك التي كان يعاني منها بطل “الانجليزي العليل”. وإنما يعاني من علة نفسية، أكثر خطورة، وأشدّ تعقيداً واستعصاءً على الشفاء.
فهو يعيش في نيويورك، فقيراً، ضائعاً، محروماً، بينه وبين مجتمع الحياة الراقية، اللذيذة، حواجز من حديد.
ومن فرط ولعه بتلك الحياة وهيامه بها، أخذ يلح على نفسه بضرورة التخلص من شخصيته، سعياً إلى شخصية أخرى، يتحرر بفضلها من أسر مغارة الفقراء.
والفيلم يبدأ به، وهو على هذا الحال من الشقاء. فمع اللقطات الأولى نراه، وقد نمّت حركات مفاصله “الرقبة والساق والذراع” عن خلل في اتزان الأعصاب.
وعبّر وجهه عن أبلغ ذل يعقب الإعياء النفسي، وأبشع غلظة وقسوة، يسفر عنهما الغلّ المكتوم .
إنه عليل، وعلته تثير الاشمئزاز والعطف والرثاء.
اللقاء السعيد
وها هي الفرصة تجيئه سانحة، عندما التقى، مصادفة، برجل من أقطاب صناعة السفن والواسعي الثراء، اختلط عليه الأمر، فظنه زميل ابنه الوحيد “ديك”، أيام الدراسة في الجامعة.
ولأنه ابن ضال، يعيش في ربوع إيطاليا لاهياً لاعباً، فقد عرض الأب على “ريبلي” أن يسافر، على حسابه، إلى حيث يقيم “ديك”، كي يقنعه بالعودة إلى أمريكا، خاصة أن أمه تعاني من مرض عضال، وعلى وشك الرحيل. وبطبيعة الحال، سارع “ريبلي” إلى الترحيب بعرض الأب، الذي لم يكن في الحسبان.
وها هو ذا في إيطاليا، حيث تم اللقاء بينه وبين “ديك” ويؤدي دوره “جود لو” ذلك الممثل الانجليزي الصاعد الواعد، وآية ذلك ترشيحه عن أدائه لهذا الدور لأوسكار أفضل ممثل مساعد.
الانبهار والسقوط
وبحكم تركيبته النفسية المعقدة أشدّ تعقيد انبهر “ريبلي” بحياة “ديك” الماجنة في علب الليل، حيث كان يستبدل الفتيات والفتيان كما يستبدل حذاء بحذاء. وحيث كان يعزف على آلة الساكسفون مع فرق الچاز،ويغني ويسكر حتى صياح الديكة في الصباح.
ولم يقتصر الانبهار على”ديك” بل انصرف كذلك إلى “مارچ” حبيبته الانجليزية الشقراء، وتؤدي دورها النجمة “جونيث بالترو”، الفائزة بأوسكار أفضل ممثلة رئيسية عن أدائها المتميز في فيلم شكسبير عاشقاً (1999).
ومع هذا الانبهار، بدأ السقوط الكبير، الذي وصل “بريبلي” إلى حد قيامه بقتل “ديك” وتقمص شخصيته، على نحو أتاح له فرصة العيش مستمتعاً بالحياة كما يحياها أصحاب الجاه والمال، متجنباً بذلك طبقته الدنيا تجنبه للجذام.
ولأن دوام الحال، على هذا النحو، من المحال، فقد بدأ الوسواس من لحظة القتل.
فمن أجل إخفاء معالم الجريمة، أخذ في ارتكاب جرائم أخرى، يشيب من هولها الولدان.
وإذا به يتحول إلى ما يشبه القاتل العشوائي، مزدوج الشخصية، حائراً، فهو تارة “ريبلي” وتارة أخرى “ديك”.
الحيرة والحصار
وعلى مر الأيام تزداد الحيرة، ويضيق من حوله الحصار، فلا يذوق طعم الراحة والاستقرار. وينتهي به الفيلم، وقد ارتكب جريمة قتل على ظهر عبّارة، حيث نراه وحيداً حائراً، مستسلماً للمصير.
ولست أدري لم لم يعجب الفيلم أصحاب الأمر والنهي في أمر الترشيح لجوائز أوسكار، فلم يرشحوا سوى الممثل “جود لو” مع أن المعنى الذي أراد إليه الفيلم قيم خطير.
ومع أنه من الناحية الفنية لا يقل من ناحية المستوى عن “الانجليزي العليل”. وأكبر الظن أن الموضوع والجرأة في تناوله هو الذي لم يعجب.
وأكاد أقول أن رقابتنا هي الأخرى ضاقت به أكثر مما ارتاحت إليه. ومن هنا تدخلها بالمقص لحذف اللقطات المتسببة في الضيق!!