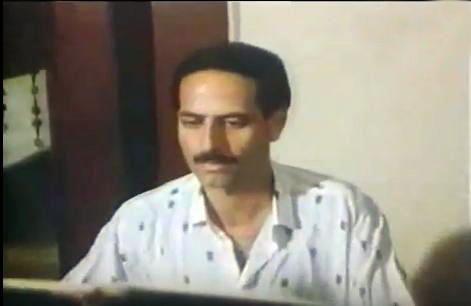كل سينما في العالم تقوم على بعض مسلمات لا تحيد عنها في أغلب ما تنتج من أفلام، ومن مسلمات السينما الامريكية رسم صورة العربي بشكل قبيح، كريه يثير الاشمئزاز في النفوس، ومصداقاً لذلك الأفلام الامريكية التي أتيحت لنا فرصة مشاهدتها على مر الزمان.
فلو أفلحنا في استرجاع عدد منها على شاشة الذاكرة، لاستبان لنا أن صورة العربي في معظمها قد رسمت على وجه مشوه، بحيث نكاد لا نرى أي عربي فيها إلا مرتكباً لآثام جسام لابد وان تنتهي به معاقباً عنها أشد عقاب وهنا يحق لنا أن نتساءل لماذا كل هذا الاصرار؟
الماضي المجهول
معروف عن السينما، وبالذات في الولايات المتحدة، أنها أداة ثقافية ذات تأثير كبير، بموجبها يتشكل وعي الشباب الامريكي بالعالم.
ولو تأملنا جمهورها المولع بها، المقبل على مشاهدتها سواء على الشاشات الكبيرة أو الصغيرة، لوجدناه في عمومه من جيل الشباب القابل للتأثر، وذلك بحكم أنه لا يزال غضاً في مقتبل العمر.
وفي الحق، فجيل الشباب هذا لا يلتقي بالعربي إلا من خلال صورته التي يراها فيما يعرض على تلك الشاشات، وليس من شك أن كل هذا لابد وأن يسفر عن بذر بذور الاحتقار الممتزجة بالخوف من كل ما هو عربي في قلوب الشباب.
ومن هنا خطورة ظاهرة تصوير العربي مشوهاً على الوجه سالف البيان، وخطورة عدم الوعي بها، وعدم مواجهتها بما تستاهل من بحث ودراسة وتأصيل.
والغريب أنها ظاهرة قديمة قدم السينما، فعندما أنشأ توماس أديسون أول استديو للفيلم في الولايات المتحدة (1883) كان فيلم”رقصة الأقنعة السبعة” واحداً من أوائل الأفلام التي انتجها ذلك الاستديو.
وخلال عقد العشرينات انتجت السينما الامريكية التي كانت قد احتلت مكان الصدارة عالمياً، ما لا يقل عن سبعة وثمانين فيلماً تدور موضوعاتها بشكل أو بآخر حول العرب.
ولقد كان بعضها من النوع الفكاهي الذي يصورنا نحن العرب مهرجين أخياراً وأشراراً فاسدين تارة أخرى. وكان البعض الآخر- وهو أكثر شعبية – من نوع المغامرات الميلودرامية التي تجري أحداثها في الصحراء.
البحث عن اللذات
ولعل أشهر أفلام النوع الأخير هما “الشيخ” (1921) و”ابن الشيخ” (1926) اللذان قام بأداء دور البطولة فيهما “رودلف فالنتينو”، ذلك الممثل الذي أصبح نجماً معبوداً بفضل هذين الفيلمين، ولا يكتمل أي مجلد دعائي عن السينما الامريكية، إلا بصورة له مرتدياً عباءة عربية، ومختطفاً امرأة أوروبية.
 وإجمالاً – فصورة العربي التي تبقى مترسبة في ذهن كل متفرج على تلك الأفلام الأولى، هي صورة كائن همجي يروع بالعنف والشهوات.
وإجمالاً – فصورة العربي التي تبقى مترسبة في ذهن كل متفرج على تلك الأفلام الأولى، هي صورة كائن همجي يروع بالعنف والشهوات.
والغالب على حبكة تلك الأفلام، لاسيما ما كان منها موضوعه يدور حول الفرقة الأجنبية، هو ثنائية التضاد الذي يجعل من العرب والأوروبيين أعداء على الدوام وربما خير مثل على ذلك فيلم “بوجست” حيث نرى الأوروبيين محاصرين داخل قلعة تائهة وسط الصحراء يتهددهم الموت في صورة موجات متتالية من عرب قتلة مقنعين، ممتطين الجياد، شاهرين السيوف.
وغالباً ما تنحدر تلك الأفلام بأرض العرب إلى مجرد صحراء جرداء، وآية ذلك فيلم “أغنية الصحراء” (1929) حيث تتحول جبال الريف في المغرب العربي بسحر ساحر إلى أرض خراب عارية تماماً إلا من كثبان الرمال.
لص بغداد
ومع ذلك، فعرب تلك الأفلام الموغلة في القدم، ليسوا أشراراً إلى آخر مدى. “فدوجلاس فيربانكس” في لص بغداد، وان كان كسولاً إلا أنه بهلون خفيف الدم.
وفالنتينو، وإن كان شيخاً يفور بالشهوات، إلا أنه شريف يرعى الحرمات.
وهكذا يمكن القول بأن عربي تلك الأفلام قد اجتمعت فيه خرافة الانسان الطبيعي الذي لم تفسده الحضارة بوجهيها القائل بهما “جان جاك روسو” ونقيضه “جون هوبز” الأول بزعمه أن الانسان في حالته الطبيعية كائن متوحش نبيل، الثاني بذهابه إلى حد اعتبار الانسان في حالته تلك سفاحاً ومتعطشاً للدماء.
القناع
وأغرب ما نعجب له أمر العربي الخيّر في تلك الأفلام أنه لا يستمر عربياً حتى الختام !!
فما أن تقترب الأحداث من النهاية حتى يفصح عن هوية البطل، فإذا بها غير عربية، وأنما أوروبية.
وهكذا تتجنب حبكة تلك الأفلام حرج اختلاط الأجناس الناجم عن وقوع الحسناء الأوروبية البيضاء في حب عربي، ذلك أنه ولئن كان خيّراً فإنه من جنس أكثر انحطاطاً.
فمثل هذا الحرج لابد وأن يزول إذا ما اتضح للمتفرج أن المحبوب الذي كان يظنه عربياً، هو الآخر من نفس جنس المحبوبة الحسناء، أوروبي زكي الدماء.
وعند تلك النهاية السعيدة المفتعلة لفليم “الشيخ” كتب محرر جريدة النيويورك تايمز يطمئن قراءه قائلاً “ولن يتأذى شعورك بزواج فتاة بيضاء من عربي لا لشيء سوى أن “الشيخ في حقيقة الأمر ليس من أبناء الصحراء”.
مومياء هوليوود
وما أن تكلمت السينما الامريكية ثم تلونت، حتى تغيرت على وجه يمكن القول معه أنها قد تحولت من حال إلى حال.
ورغم ذلك، فالموضوعات المتصلة بالعرب ظلت بنفس وصفتها القديمة لا تتغير، حتى أن فيلم “قسمة” (1920) قد أُعيد إنتاجه بعد ذلك ثلاث مرات (1955،1944،1930).
وكذلك الحال بالنسبة لكل من “لص بغداد” ( 1924) الذي أُعيد انتاجه هو الآخر ثلاث مرات (1978،1960،1940) و”بوجست” (1926) الذي أُعيد انتاجه مرتين ( 1966،1939).

ومن الأفلام العلامة في تشويه صورة العربي إبان عقد الثلاثينات فيلم “المومياء” الذي بفضلة أدخل “بوريس كارلوف” على السينما الامريكية نوعاً جديداً كُتِب له طول البقاء.
فبموجب تنويعات على نفس الاسم “قبر المومياء” ( 1942)، و”شبح المومياء” (1944) و”لعنة المومياء” (1945)، ثم مرة أخرى”المومياء” (1955) تكرر هذا النوع المرعب من الإعلام .
والأحداث فيها جميعاً تدور في شرق عربي متآكل يستبد به الموت والشيخوخة والاضمحلال، يتحكم فيه الظلم والجور والفساد، تسيطر عليه الخرافات والخزعبلات.
وعلي العكس من ذلك تماماً علماء الآثار القادمون إلى هذا الشرق المريض من الغرب.
إنهم يمثلون العلم والديمقراطية، الشاب والحيوية، وهم بوصفهم كذلك ينجحون في اختراق كل شيء، حتى الأماكن المحرمة كبيوت العبادة والحريم والمقابر.

الموجة الجديدة
ولعلي لست مغالياً إذا ما قلت أن فيلم “الخروج” (1960) قد بدأ به نوع سينمائي جديد، موضوعه الصراع العربي – الاسرائيلي من خلال ميلودراما تاريخية يتصارع فيها الأخيار الاسرائليون مع الأشرار العرب.
والأكيد أن أفلام هذا النوع التي جرى توزيعها في الولايات المتحدة خلال عقد الستينات، هذه الأفلام لا يقل عددها عن عشرة أفلام من بينها “جوديث” (1966) و”ألقى بظله الضخم” (1966) و”النجاة” (1968) و”رحلة إلى أورشليم” (1968).
ومما لوحظ على تلك الأفلام أن الاسرائيليين فيها لا يختلفون عن الأوروبيين في شيء.
أما العرب فقتلة ملثمون، لا ينفرد أي منهم بصفة يتميز بها عن القطيع.
وهم جميعا مثل الجنود العرب في “ألقى بظله الضخم” قساة يقهقهون مهللين مكبرين، وهم يطلقون الرصاص على امرأة حبيسة سيارة في أسفل واد لا تستطيع منه نجاة.
وإذا ما اكتفينا بإلقاء نظرة متسرعة على أفلام هذا العقد، فقد تجنح بنا تلك النظرة إلى اعتبار عدد منها منصفاً بعض الشيء للعرب.
الوهم والحقيقة
فمثلاً “لورنس العرب” (1962) لصاحبه “دافيد لين” يظهر الانجليز وقد تراجعوا عن وعدهم منح العرب الاستقلال فضلاً عن أنه يبدو وكأنه فيلم قد حقق لصورة العربي في السينما الامريكية بعض التقدم، فالعرب فيه ليسوا جميعاً من فئة الاشرار.
وهذا ولا شك خطوة إلى أمام إذا ما قورن “لورنس” “بالخروج” حيث العرب جميعاً ليسوا إلا أشرارا.
غير أنه إذا تعمقنا النظر في عرب “لورنس” لوجدناهم جميعا إما أناساً يمارسون عنفاً لا مكسب من ورائه، أو أناساً غير أكفاء لا يحسنون تصريف الأمور، أو أناسا منقسمين على أنفسهم بحكم انتسابهم إلى قبائل متناحرة على الغنائم والأسلاب.
وفضلاً عن ذلك فدمشق عندما سقطت في أيديهم، لم يستطيعوا الاحتفاظ بها لأكثر من يوم أو يومين، وذلك لعجزهم عن إدارة مرفق المياه والمستشفيات ثم إذا بهم ينسحبون منها فجاة، ليتركوها نهباً للانجليز.
وغني عن البيان أن كل ما جاء في “لورنس” عن دخول العرب دمشق ثم خروجهم منها بعد يومين، وذلك لفشلهم في إدارة مرافقها، كل ذلك لا يعدو أن يكون هراء وتحريفاً صارخاً للتاريخ، فالعرب حكموا دمشق مدة عامين إلا يومين، ولم يخرجوا راضين بل مكرهين تحت ضغط الجيش الفرنسي الذي كان يسعى إلى احتلالها استكمالاً لخطة تقسيم المشرق العربي بين الاستعمارين البريطاني والفرنسي.

وهذا الذي قيل عن تحريف التاريخ في “لورنس” يمكن ان يقال كذلك في حق فيلم “الخرطوم” (1966)، ففيه تاريخ الثورة المهدية قد جرى تحريفه تبريراً للغزو الاستعماري للسودان.
وفيه لا يظهر أنصار تلك الثورة إلا بمظهر القتلة المتعصبين ضد رسل التقدم والرخاء.
الاصرار.. لماذا؟
ومما يثير الدهشة أنه كلما مرت الأيام، ازدادت صورة العربي في السينما الأمريكية سوءًا.
فخلال النصف الثاني من عقد السبعينات، والنصف الأول من عقد الثمانينات، بلغ التشوية لصورة العربي في تلك السينما ذروة، ما أظن أن لها مثيلاً في السينما على مر العصور.
فالإرهابي في فيلم “الأحد الأسود” (1977) عربي يتآمر من أجل قتل المتفرجين، بما فيهم رئيس الولايات المتحدة بواسطة تفجير قنبلة شديدة التدمير في مدرج رياضي وتاجر العبيد “بيتر استينوف” في فيلم “اشافتي” (1979) عربي يختطف زوجة “مايكيل كين” الانجليزي من أجل بيعها لزبونه الثري العربي “عمر الشريف”، وتاجر عبيد آخر في فيلم “الجنة” – وهو بدوره عربي – يطارد فتاة انجليزية في الصحراء، ولا ينقذها من بارثنه سوى صبي شجاع – اسمه بالمناسبة “دافيد” – بأن يصوب إليه سهماً، فيرديه قتيلاً، وملك وقائد ثوري، وكلاهما عربي، يسعيان في فيلم “الخطأ الصحيح” (1987) إلى تفجير قنابل ذرية في كل من نيويورك واسرائيل.

وتمضي السينما الامريكية قدماً في طريق تشويه صورة العربي حتى في أفلام موضوعاتها منبتة الصلة بشرقنا العربي، أفلام مثل “شبكة التليفزيون” (1977) و”المهر الأسود” (1979) و”غزاة صندوق العهد المفقود” (1981) و”الحياة والموت في لوس انجليس” (1985) و”شرلوك هولمز الصغير” (1985) و”العودة إلى المستقبل” (1985) نراها وقد حشرت فيها جميعاً شخصيات عربية كريهة لا لشيء سوى تشوية صورة العربي بحيث ينتهي الأمر بالمتفرج إلى الاستسلام إلى الدعاية التي تقول له تلميحاً وتصريحاً أن من الواجب عليه أن يرى الشر كل الشر، والنكر كل النكر في كل ما يصدر عن العرب من أفعال.
لحظة الحقيقة
والآن ماذا بعد مأساة غزو العراق للكويت؟
أغلب الظن أن السينما الامريكية ستعود إلى”قسمة” “لص بغداد” و”بوجست” و”المومياء” بدل المرة مرات.
وأغلب الظن أنها ستستوحي من احتجاز الرعايا الأجانب في الكويت والعراق كرهائن ودروع بشرية ضد الغارات، ومن تعذيب الطيارين أسرى الحرب وإهانتهم أمام أعين الكاميرات، ومن تلويث البيئة بالسرطان الأسود يلقى به في مياه الخليج دون اكتراث، ومن تدمير جميع حقول بترول الكويت تقريباً باشعال الحرائق فيها قبل الهروب الكبير، ومن التهديد باستعمال الغازات السامة وما شابهها من أسلحة الدمار والفناء.
ومن طريق العار تفترشه دبابات وعربات “أم المعارك” المحملة بالمسروقات وقد تحولت إلى حطام، من كل ذلك ستستوحي أفلام لا تعد بالعشرات، وإنما بالمئات.
وأغلب الظن أنها ستجد في وصف نجيب محفوظ صاحب جائزة نوبل لطاغية بغداد بأنه جعجاع، قليل الأدب، سيئ الرأي والسلوك، لص، غادر، ستجد فيها معيناً لا ينضب لمسلسل لا ينتهي من الأفلام ترسم صورة العربي وفق ما تهوى وتشاء.