لو وضعت “الطوق والإسورة” في كفة الميزان، ووضع في كفته الأخرى أغلب ما كُتب من أدب القصة عندنا عقب زلزال الخامس من يونيو “حزيران” لرجحت في ظني قصة يحيي الطاهر عبد الله ومن هنا صعوبة التحول بها إلى لغة السينما شأنها في ذلك شأن أية رائعة من روائع الأدب العالمي.
وعلى كُلٍ وقبل الكلام عن الفيلم، وكيف أقدم “خيري بشارة” على إخراجه عن سيناريو استوحاه بالإشتراك مع الدكتور يحيى عزمي عن “الطوق والإسورة” أرى من اللازم الوقوف قليلاً أولاً عند صاحب القصة وثانياً عند الإبداع فيها.
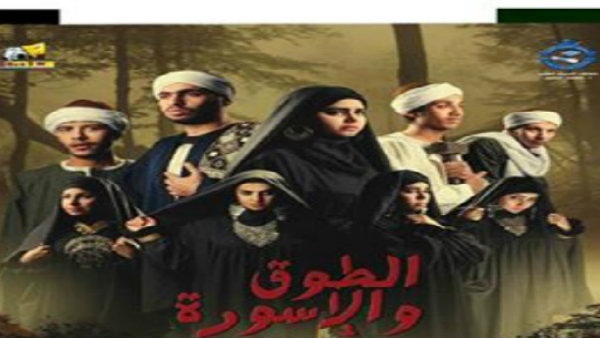 .الكابوس الأسود.
.الكابوس الأسود.
مر يحيى الطاهر عبد الله بهذا العالم مروراً سريعاً فلم يعش فيه إلا ثلاثة وأربعين عاماً أنفق جزءاً غير قليل منها في الطفولة والصبا متأثراً بما حوله في قرية الكرنك مركز الأقصر حيث ينام الرجل الصعيدي وبندقيته وزوجته وأولاده والكلب والحمار في حجرة واحدة.
وحيث تسلك الذئاب والثعالب تلك الدروب الضيقة على المارة، وحيث يتعذر على الغريب أن يُميّز الآدمي من الوحش والناس والأشياء.
.أيام في المدينة.
وبعد الحصول على دبلوم الزراعة المتوسطة أنفق بعض حياته في مدينة قنا حيث التقى بالشاعرين عبد الرحمن الأبنودي وأمل دنقل وحيث كان محاصراً بالسكون والظلمة والتعب وحيث أحس بأن روحه منهكة، وأنه فعلاً مضطهد ومقهور، وإنه حقيقة يتعذب .
فلما رحل (1964) بجسم نحيل وعينين براقتين وكلام مهتاج من الصعيد إلى القاهرة كي يظفر بشيء من الحياة الفنية المستقلة، لم يلتمس عملاً آخر غير كتابة القصة القصيرة يكسب منها القوت.
ورفض النصيحة “خصوصاً من الجيل السابق، لأنه مؤمن بأنه يفتح صفحة جديدة بريئة من الرتابة والصنعة وشكوك التقليد والاقتباس من بعيد لبعيد”
.الجثة.
ثم لا يكاد الربع الرابع من القرن العشرين يتقدم قليلاً حتى يكون قد حقق لنفسه فرحه الخاص بما كتب، فالكتابة بالنسبة له “متعة كما هو الأكل” وحتى يكون بعين مملوءة بالدمع والدم على موعد مع ملاك الموت في سكة القاهرة- الواحات سنة 1981(9 أبريل).
وها هو ـ بعد أن تمكن الموت من الريح وفرغت الحدوتة- يعود طائراً- وهو الذي لم يدخل الطائرة سوى نعشه- إلى مسقط رأسه الكرنك حيث رأت عيناه المضيئتان النور لأول مرة، وحيث دفن مع الشمس وكفن بالضباب.
وها هو محلقاً يسمع لآخر مرة صوت “الأبنودي” في ختام رثاءه يناجيه “دي مش نهايتك يا يحيى.. يمكن تكون دي البداية”.
.شموس.
أظهر ما يمتاز به قصص يحيى الطاهر من الخصائص أنه يصور الموت والقلق من مكر الدنيا الذي يوشك أن يبلغ اليأس وأين..؟ في قرية مركزها الكرنك في الأقصر أي “طيبة القديمة”، وعنها قال يحيى في حديث صحفي لعله الأول والأخير “أرى أن ما وقع على الوطن وقع عليها.. وهي قرية منسية منفية، كما أنا منفي ومنسي.. كما أنها أيضا قرية في مواجهة عالم عصري.. إذن عندما ابتعد عن قريتي أسعى إليها في المدينة، وأبحث عن أهلي وأقربائي وناسي الذين يعيشون معي.
وأنا لا أحيا إلا في عالمهم السفلي.. فحين التقي بهم نلتقي “كصعايدة” وكأبناء “كرنك” ونحيا معاً ألمنا المصري وفجيعتنا العربية وبعدنا عن العصر كشخوص مغتربة.
وأحداث “الطوق والإسورة”- التي هي واحدة من نفائس عقد يحيى- إنما تدور وجوداً وعدماً في قريته هذه، لا تخرج منها أبداً.
 .عطر الحبيب.
.عطر الحبيب.
فحتى “مصطفى” البطل الغالي الغائب عن جحيم الكرنك بعيداً في السودان ومن بعده فلسطين فالقنال، والذي لا نراه طوال الأيام التي طويت من أعمار أفراد أسرته الصغيرة، وذلك لأنه لا يعود إلى القرية إلا قريباً من النهاية، يعود أمياً كما كان، وفوق هذا مهزوماً مهاناً، حتى هذا البطل الغائب الغالي نحس به وكأنه حاضر في القرية، فهو في عقل الأب “بخيت البشاري” الذي صار بعد العمر الذي مرّ كالقفة.
وهو في قلب الأم “حزينة” الملهوفة التي تخطف رسائله من السودان أرض السحر والأحجبة والمهدي المنتظر، ومن فلسطين الشام جنة الله في الأرض تسلل إليها اليهودي كاره العربي، تخطفها لتشمّها وتقبلها ثم تدسها في الصدر الحنون.
وهو في حواس الأخت “فهيمة” التي تحبه، تتذكر وجهه، الرجل يظفر بالدم الأحمر الدافئ، والعروق في رقبته تنفر وتكاد تنفجر.
.ولادة أسطورة.
وهنا وقفة أخرى لابد منها، ذلك أن “الطوق والأسورة” بما انطوت عليه من كشف ما في نفس صاحبها الغنية، ومن فضح ما في الحياة التي تكرّ حوله في الكرنك من فقر وضحل وبشاعة وغثيان لم تخرج إلى الناس كاملة غير مفتوحة كما هي الآن.. بل خرجت مبتورة في شكل قصتين قصيرتين من مجموعة الدف والصندوق (1974) تحت اسمي “الشهر السادس من العالم الثالث” و”الموت في ثلاث لوحات”.
وهاتان القصتان تشغلان تسع صفحات إلا قليلاً، في حين أن “الطوق والأسورة” تزيد صفحاتها على ذلك بكثير حتى تبلغ سبعة أضعاف هذا الرقم أو يزيد.
ويبدو من الاطلاع عليهما أن “يحيى” قد باشر تأليفهما، وليس في رأسه غير فكرة واحدة وهي أن يصور كيف رحل إنسان بعيداً مع رجال التراحيل، وكيف أثّرت غربته هذه على أسرته حتى انتهت بأفرادها جميعاً إلى موت أكيد.
وبغتة- أجل بغتة- فتق له أن يعود إلى حكاية الغائب والموت، وأغراه بالغ الإغراء أن يتخذ من مصطفى ومأساته ترجماناً لأفكاره، فيصور ما كان من شأنه مع أبيه وأمه وأخته خلال أعوام من العناء المتصل والشتاء المقيم صرفوها في الكرنك، والمسافات تباعد بينهم والزمان يعاديهم.
فكان أن أقبل على كتابة “الطوق والأسورة” (1975)، وقد امتلأ خياله صوراً لأهل بيت مصطفى في غربته. وبسحر ساحر تهيأ له القالب الذي يريده والشخصيات التي كان يفتش عنها.
فكان أن تخلّقت شخصيات بنت الأخت “نبوية”- في الفيلم أسموها ” فرحانة” لا اعرف لماذا؟ـ وابن الشيخ الفاضل والحداد العاجز وشقيقته الحدادة الماكرة وابنها السعدي العاشق ومحمد الشرقاوي الصحفي.
 .لعنه الطاحونة.
.لعنه الطاحونة.
ولكن لم يكن بينها صاحب الطاحونة “منصور الصادق” (أحمد بدير) تلك الشخصية التي تلعب دوراً محورياً في الفيلم، فمن أين جاء؟
لصاحب “الطوق والأسورة” قصة قصيرة اسمها “طاحونة الشيخ موسى” نشرت ضمن مجموعة “ثلاث شجيرات كبيرة تثمر برتقالا” (1970).
وبطلها بنصف عين فقط، عثر على ماكينة طحين نصف عمر.
وبعدها جاءته المتاعب تباعاً بسبب كلام فارغ عن أطفال لابد وأن يرمي بهم داخل الماكينة حتى تدور. كلام يتردد صداه رجفة بقلوب آباء يعبدون الأبناء، وأمهات يفضلن تعب المشوار وشتاء العمر ولا المصيبة في الولد.
وحول هذه المتاعب تدور القصة التي تنتهي بانتصار صاحب الطاحونة بفضل بركات الشيخ موسى.
ولعل هذا الانتصار في المواجهة بين معتقد أهل القرية في أن الماكينة لا يمكن أن تدور دون التضحية بطفل ومعتقدهم الثابت في بركة الشيخ.. لعله هو الذي حدا بالأديب الراحل إلى استبعاد الطاحونة وحكايتها تماماً من حلقة الطوق والأسورة الجهنمية التي تحيط بشخصيات القصة، وهم مسلوبوا القدرة على مواجهتها حتى ينتهي بهم الأمر إلى موت سخيف حقير أو حياة مرة بائسة.
وقد لا أكون بعيداً عن الصواب إذا ما قلت أن حشر هذه الحكاية في سياق السيناريو سار بالفيلم القهقري، ورجع به إلى وراء.. كيف؟
لأنه كان على حساب الروح التي يشعها “الطوق والأسورة” ولأنه أدى إلى بعض الغموض والاضطراب في السرد بحيث كثيراً ما اختلطت الأمور.
ومهما يكن من شيء ففيما عدا هذه الهفوة التي كادت تكون قاتلة، فالفيلم كان في معالجته لأحداث درة يحيى الطاهر أميناً إلى حد كبير.
فهو يبدأ كما القصة بالأب “عزت العلايلي” كالقفة تحملها زوجته “حزينة” “فردوس عبد الحميد” وابنته “فهيمة” (شيريهان) من الشمس إلى الظل ومن الظل إلى الشمس.
وينتهي كما القصة بالابن “عزت العلايلي”- يقوم بدوره علاوة على الأب لا اعرف لماذا؟- ساقطاً من عداد الرجال شاحراً كالذبيحة.
وفيما بين البداية والنهاية يحدثنا الفيلم كما القصة عن الأب كيف تخلص من الأوجاع والعمر المكروه بالذهاب إلى الله الرحيم.
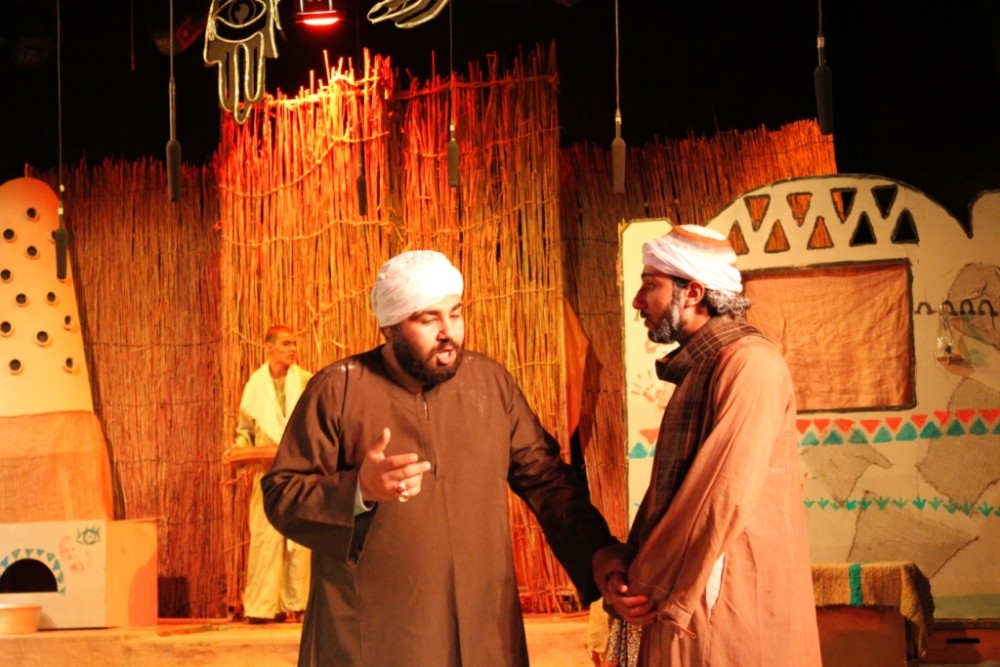 ويحدثنا عن ابنته فهيمة، وقد عقد قرانها على الحداد الهامد “أحمد عبد العزيز” الذي يوسعها ضرباً لأنه لا يستطيع أن يفلح أرضاً، ومن ثم ينفلت في بكاء مرّ.
ويحدثنا عن ابنته فهيمة، وقد عقد قرانها على الحداد الهامد “أحمد عبد العزيز” الذي يوسعها ضرباً لأنه لا يستطيع أن يفلح أرضاً، ومن ثم ينفلت في بكاء مرّ.
وحين تعلم “حزينة” بحال ابنتها هذه تذهب بها إلى المعبد القديم المشيّد من الحجر الكبير حيث ينشرخ إناء، وتنمو خرافة الأسطورة في رحم “فهيمة” فيطلقها الحداد، وتنجب طفلة “فرحانة” ثم لا تلبث أن تصاب بحمى يتعذب لها الجسد ولا يستريح إلا بالموت.
.الخيوط تتشابك.
وكذلك يحدثنا عن فرحانة “شريهان” مرة أخرى! يتيمة من الأم والأب الذي مات محترقاً بفعلته مع زوجته الجديدة بنت الصياد.
إنها صبية فقيرة لا تكاد تميز الأشياء.. تعيش حياة ضيقة ضئيلة.. تسعى مع جدتها على رزقها في بيت الشيخ الفاضل حيث حدث الذي لا يقدر على منعه أحد حين يختلي ولد وبنت مولعة به.
فلقد انشرخ الإناء مرة أخرى، ولكن عن غير طريق الأسطورة.
وطبعاً نقلت “حزينة” الخبر المفجع لابنها “مصطفى” الذي أشبع بطن “فرحانة” بما يحمل من حرام رفساً بقدميه، وتركها كوم لحم مهشم العظام حتى انتهى من حفر حفرة أنزلها فيها، وأهال التراب على جسمها حتى العنق، ثم تركها على هذه الحال حتى تموت، وحتى تبوح بمن فعل.
ويعلم بالخبر العاشق “سعدي” ابن الحدادة.
وفي مشاهد- ما أظن أن لها مثيلاً في الجمال المقترن بالقسوة طوال تاريخ السينما في الوطن العربي- يحرر السعدي “فرحانة” من أسر الأرض يحملها كما المحبين إلى الطاحونة لا ليعتلي الفرس وينطلق بها في دنيا الله كما كان يحلم، وإنما ليحصد بالمنجل العنق الشامخ.
كل ذلك يحكيه الفيلم بلغة سينمائية راقية بفضل مخرجه “خيري بشارة”، وبفضل كاميرا المصور الموهوب “طارق التلمساني”.
ولولا هفوة الطاحونة وما صاحبها من ظلال لبدت حسنات “الطوق والأسورة” ساطعة وهّاجة.
