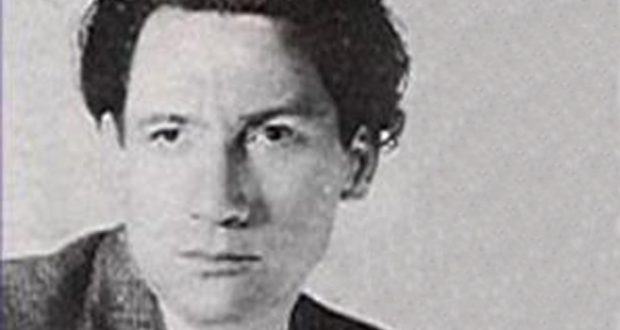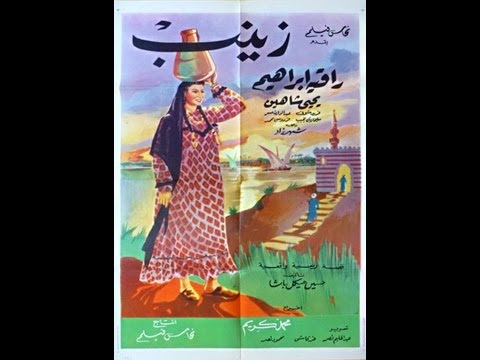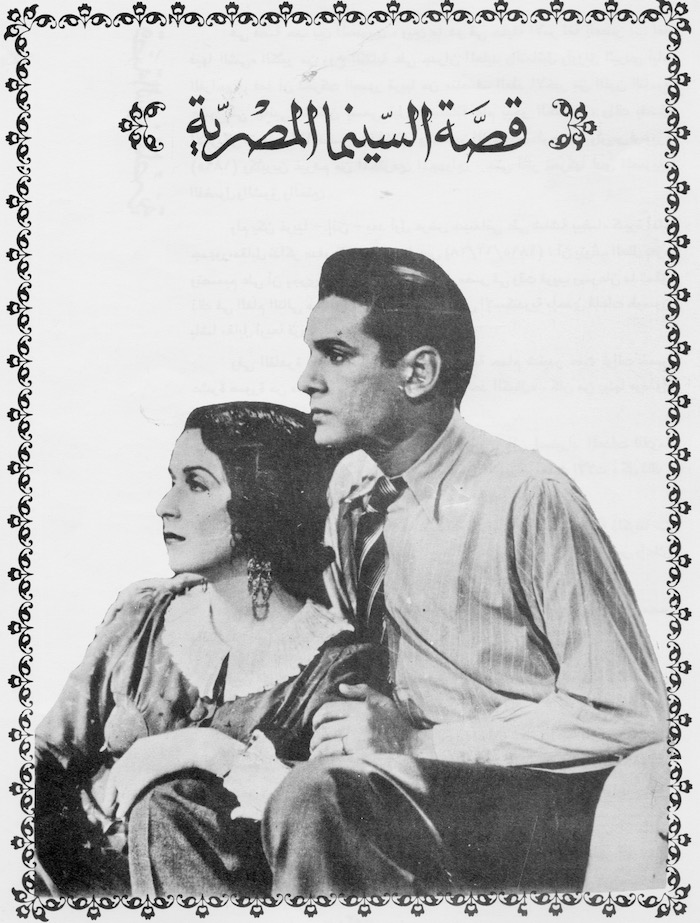هناك أفلام تمر صورها أمام أعيننا مر الكرام ودون أن تترك في حافظة ذاكرتنا أثر، وهناك أفلام ما أن ترأها حتى تبقي صورها في حافظة ذاكرتنا لا تنمحي أبدا، ومعظم الأفلام، لحسن حظنا، من النوع الأول، ما أن ننتهي من مشاهدتها على الشاشة صغيرة كانت أم كبيرة، حتى ننساها، وأبدا لا نستطيع استرجاع صورها على شاشة الذاكرة وقتما نريد.
أما أفلام النوع الثاني، وهي أقل القليل، فترسب في الأعماق، إنها دائماً هناك، ونستطيع استرجاعها بكل تفاصيلها ودقائقها ساعة نشاء.
وفي اعتقادي أن فيلمي “طوق الحمامة المفقود” و”شاشات الرمال” من هذا النوع الأخير النادر، الذي ما أن تلتقط صوره عدسة العين، حتى تتذكرة على الدوام.

ولسوء الحظ، فكلا الفيلمين من الممنوعات، بل أنهما في رأي نفر متعصب، معاد للفن، أكثر خطورة من أشد اصناف المخدرات هولاً.
قصة المدينتين
وأعجب العجب بالنسبة لهما، هو تضامن مهرجاني دمشق والقاهرة في اتخاذ موقف واحد منهما، ألا وهو موقف العداء الذي انحدر إلى حد التجريم فالتحريم.
وحتي الآن لا اعرف لهذا الموقف الغريب سبباً، اللهم إلا إذا سايرنا الشائعات التي عمل على نشرها نفر يتاجر بالقضايا المصيرية، ولا يحمل لحرية التعبير سوى المقت الشديد، وهي شائعات تقول فيما تقول أن الفيلمين قامت بتمويلهما مصارف غربية يتحكم في شئونها اليهود، فضلاً عن أن أحدهما، وهو “شاشات الرمال” يحقر من شأن المرأة العربية على وجه مشين.
ولقد كان لهذه الشائعات تأثيراً كبيراً على مهرجاني العاصمتين فإذا بدمشق تجد نفسها محرومة من مشاهدة “شاشات الرمال” وجميع الأفلام التونسية بما في ذلك رائعة “فريد بوغدير” “عصفور على السطح” أو “الحلفويين” و”شيشخان” بطولة الممثل المصري “جميل راتب” الذي أدى دوره باتزان واتقان غير مألوفين، يعود الفضل فيهما إلى صاحبي الفيلم “محمود بن محمود” و”فاضل جعايبي” وأولهما سبق له وأن امتعنا قبل خمس سنوات بفيلمه الأول “عبور”.

وإذا بالقاهرة بدلاً من افتتاح مهرجانها الكبير برائعة عربية مثل “طوق الحمامة المفقود” لصاحبها “ناصر خمير”، تفتتحه بفيلم رديء فنياً وسياسياً أسموه “ناجي العلي”، ولا تكتفي بهذه الكارثة، بل تعمل جاهدة على أن يكون الختام بفيلم عربي أكثر رداءة اسمه “طبول النار”.
وفي هذه الاثناء، إذا برائعة “ناصر خمير” تختفي من جميع دور العرض بسحر ساحر، نبحث عنها مهتدين بارشادات برنامج المهرجان، فلا نعثر عليها وكأنها فص ملح وذاب.
سور الصين
وبالمصادفة، وبعد انتهاء المهرجان بيومين أو ثلاثة، وجدتني أشاهدها في عرض شبه سري للنقاد، لم يعلن عنه لا لشيء سوى أن “طوق الحمامة المفقود” كما سبق أن قلت، إنما يعتبر في نظر نفر من الناس أكثر خطراً من أكثر أصناف المخدرات نكراً !!
أما “شاشات الرمال” رائعة المخرجة اللبنانية “رنده الشهال”، فحدث ولا حرج عن منعها باعتبارها من المحرمات.

فهي أصلاً لم يسمح لها باجتياز عتبات ديار مصر، وبالتالي ففرصة مشاهدتها والاستمتاع بها لم تتح لي إلا بفضل شريط فيديو، ذلك الاختراع اللعين الذي فتح في الأسوار نوافذ نطل منه على بساتين الفن السابع رغم أنف سيف الرقباء.
المجد التليد
وعلى كل، وأيا كانت الأسباب التي تذرعوا بها لحمايتنا من مشاهدة الرائعتين، باعتبارنا لانزال مراهقين، فالأكيد أن “طوق الحمامة المفقود”، فضلاً عن أنه وحيد نوعه بين الأفلام العربية، فهو عمل سينمائي ساحر، مستوحي من رسالة عن الحب “طوق الحمامة”، كتبها العالم الأندلسي “ابن حزم” الذي فرغ لعلوم اللغة والدين في عصر عصيب شهد انتقال السلطان من بني أمية إلى حُجَّابهم، ثم انهيار الأمر حول هؤلاء الحجاب، وقيام ملوك الطوائف، وتدّخل البربر في شئون العرب الأسبانيين.
والظاهر أن الحب كان يشغل الناس جميعاً في الأندلس لعهد هذا العالم الكبير، ولعله كان يشغل المثقفين والممتازين أكثر مما كان يشغل غيرهم من الناس.
والبادي من سياق الفيلم أنه الشغل الشاغل للخطاط “حسن” بطل “طوق الحمامة المفقود”.
فبدءًا من اللقطات الأولى، وهو أبدا يردد عبارة “ابن حزم” الشهيرة التي تغوص في ماهية الحب، عندما تصفه قائلة في سخرية لاذعة “الحب أعزك الله أوله هزل، وآخره جد”.
وهو أبدا يبحث عن مفردات كلمة حب، وعددها ستون، استطاع أن يجمع منها ثلاثاً وثلاثين.
وفي سعيه هذا، دائماً ما يلتقي “بزين” مرسال الغرام في قرطبة ذات الجلال، والصبي الذي لا يُعْرف له أب، فإذا ما استفسر ملتاعاً عنه من أمه، قالت له ضاحكة، وهي في حمام النساء، إنه جني أصيل.
ألف ليلة وليلة
ومن خلال مغامرات الاثنين “حسن وزين” التي جرى حكيها بأسلوب حكي قصص ألف ليلة وليلة، نجح المخرج في تسليط الأضواء على ابداعات الحضارة الأندلسية.. فن كتابة الخط العربي، المكتبات بمخطوطاتها النادرة، الساحات والباحات ملتقى المثقفين، الجوامع بمآذنها وأعمدتها عنواناً على علو شأن المعمار، ولا أقول الفنون جميعاً.
باختصار شديد “طوق الحمامة المفقود” حدث جليل في تاريخ السينما العربية.
وهو فيلم لا يحكي لا لسبب سوى أنه أقرب إلى موسيقى الشعر منه إلى أي شيء آخر.
وكذلك حال “شاشات الرمال” فهو فيلم تصعب حكاية وقائعه، ولو حكيت فهي لا تحكى إلا في كلمات معدودات.
ولقد جرى عرضه في مهرجان فينيسيا الأخير، ومن بعد في أكثر من مهرجان.
نساء لبنان
هذا، ولم يسبق لصاحبته أن أخرجت أفلاماً روائية، فجميع أعمالها السينمائية قبل “شاشات الرمال” من ذلك النوع المسمى بالتسجيلي في قول، وبالوثائقي في قول آخر، أذكر من بينها “خطوة..خطوة” (1979)، “لبنان أيام زمان” (1980)، “لبنان إرادة الحياة” (1981)، و”الشيخ إمام” (1984).
وبفضل رائعتها الروائية الأولى، استطاعت أن تلحق بزميلتيها المخرجتين اللبنانيتين “هيني سرور” و”جوسلين صعب”. فالمخرجات الثلاث بدأن المشوار معاً إبان عقد السبعينات، بأفلام تسجيلية بعضها طويل، والبعض الآخر قصير.
والآن لكل واحدة منهن فيلم روائي واحد لا يزيد.
ورائعة “شهال” بأسلوبها الذي قد يراه جمهور السينما التقليدية مفرطاً في التجريد، إنما تذكرنا بأسلوب الأديبة الفرنسية “مارجريت دورا” في الكتابة والإخراج.
ولا غرابة في أن تتأثر “شهال” بأسلوب” دورا فهي متخرجة في معهد “لوميير” للسينما (1985).
الاتصال والانفصال
وهي في رائعتها، أنما تعرض لمأساة المرأة العربية على امتداد الوطن العربي من المحيط إلى الخليج.
تلك المأساة التي تخلص في فرض الانفصال عليها عن المجتمع العامل، وبالذات مجتمع الرجال.
وهو انفصال شامل لجميع أجزاء هذا الوطن دون أي استثناء، موجود في كل مكان سواء أكان متقدما أم متخلفاً.
مفروض على المرأة في أقاصي الصعيد، في متاهات الصحروات، في أعالي لبنان، في وديان المغرب والسودان.
إذا نحن بازاء ظاهرة انفصال بين الجنسين جامعة لكل العرب ولسوء الحظ، تزداد على مر الأيام سوءًا.
ومن هنا ايثار “شهال” لوقائع رائعتها ألا تجري في بلد عربي محدد بالذات.
فكل النساء عندها في الهم عرب، لا فرق في ذلك بين مشرق ومغرب.
وهي تبدأ رائعتها بدءًا قريباً كل القرب، غريباً كل الغرابة، فتفرض علينا أن نصحبها في الطريق التي تريد أن تمضي فيها.
فهذه امرأة جميلة “سارة” (ماريا شنايدر بطلة التانجو الأخير في باريس أمام مارلون براندو) لم تتقدم بها السن، ولكنها قد جاوزت الشباب قليلاً إنها داخل سيارة فارهة “رولز رويس” يقودها سائق يتبين لنا تلميحاً فيما بعد أنه لا يميل إلى جنس النساء ولسبب لا نعرفه تصل بها السيارة إلى المطار، حيث لا يسمح لها بمغادرة البلاد.
فإذا ما عادت إلى حيث تقيم رأيناها في قصر منيف، به حمام سباحة كبير، مغطي بستائر تحجب الرؤية عن أعين المتطفلين، ودوائر تليفزيونية مغلقة، لا تترك شاشاتها صغيرة أو كبيرة، إلا سجلتها حماية لشرف نساء البيت الكبير.
وسارة في وحدتها، ورغم الثراء الفاضح، امرأة تعيش حياة طفيلية ملؤها الملل والضياع.
وليس عندها وسيلة للاتصال بالعالم الخارجي، سوى تليفون مثبت به شاشة تكشف عن شخصية المتلقي للمكالمة، لا تستعمله إلا لقتل الفراغ.
وفي محاولة منها للانعتاق من أسر تلك الوحدة القاتلة، ها هي ذي تلتقي بأمراة أخرى “مريم” أجبرتها ظروف الحرب الأهلية المستعرة الأوار، إلى مغادرة لبنان للعيش في هذا المكان الموحش حيث أسندت اليها مهمة إعداد مكتبة جامعية للنساء.
ولأمر ما، تظل هذه المكتبة خاوية على عروشها، بلا كتب، و”مريم” تلح في الطلب، ولا مستجيب.
وبعد حين تثوب هي إلى نفسها، حائرة أول الأمر، ثم ساخطة، ثم منكرة لهذا التصرف المريب.
ولا تزال تسأل، وتبحث وتستقصي، مستنجدة بأستاذ لبناني في جامعة النساء اسمه “طلال” تهرع إلى الالتقاء به في أحد المصاعد، حيث يمارسان الجنس في لهفة، تحت أعين كاميرات تعرض ما تلتقطه على شاشات يشاهدها رجال ساهرون على حماية حسن الآداب.
وسرعان ما نرى “طلال” وهو يلقى القبض عليه بواسطة جمهور من الناس غريب.
و”مريم” وهي هاربة بعدئذ استقر في نفسها أنها متهمة بدورها، وإن لم تعرف طبيعة التهمة.
وفي الختام نراها واقفة بمفردها في صحراء شاشعة، معلقة بين اليأس والرجاء.
وكأني بصاحبة “شاشات الرمال” تريد أن تقول بهذه النهاية أن المرأة في مجتعاتنا تضيع حياتها في جهود مجدبة لا تغني عنها شيئا.
يبقى أن أقول أن “شاشات الرمال” تحفة سينمائية، لا يعيبها رغم بعض الغموض، إلا أنها متكلمة بالفرنسية، أي بغير لغتنا الجميلة، وهو عيب، لو تعلم “شهال” كبير.