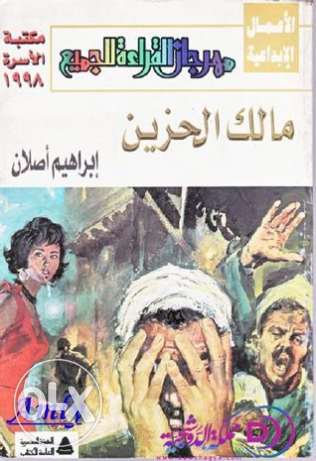أشياء تبقى بالذاكرة، لا تنمحي منها أبداً، من بينها أنني في سني الصبا والشباب، ما رأيت فيلماً أمريكياً، وكان من بين ممثليه واحد من السود، إلا وكان الدور المسند إليه إما خاصاً بعبد يشترى ويباع في الأسواق، بحر المال أو خادم ذليل مهان، أو مغن بملهى في أحسن الأحوال.
ولعل خير مثل على تلك الظاهرة الغريبة العجيبة حكاية “هاتي ماكدنيال”.. فما هي؟
من المعروف عن هذه الممثلة السوداء البدينة أن اسمها لم يدخل في عداد عظماء النجوم المبشرين بالخلود في سجلات هوليوود، إلا لسبب واحد، هو خروجه من مضمار الصراع من أجل أوسكار فائزة بها مقابل أدائها لدور صغير في الفيلم الشهير “ذهب مع الريح” (1940).. فما هو؟
كان دور خادمة، أو بمعنى أصح، جارية مطيعة شديدة الوفاء لأسيادها البيض أصحاب الضياع والعبيد في الجنوب القديم أيام الحرب الأهلية الأمريكية التي قادها “ابراهام لينكولن” منتصرا فيها إلى العبيد.
وعلى كل فما كادت تنتهي الاحتفالات بالفيلم المستوحى من قصة الأديبة الأمريكية “مرجريت ميتشيل” وأول نجمة سوداء تفوز بالاوسكار، حتى جاءت سنوات الأربعينات مثقلات بما حملت من أحداث وتحولات، لعل أهمها الحرب العالمية الثانية بأهوالها الجسام.
فجر جديد
وكان من نتيجة ذلك أن حدث في مسار هوليوود تغيّر بدا كما لو كان تغيراً مفاجئاً، لكنه في حقيقة الأمر كان متوقع الحدوث، وإن يكن قد تأخر وقوعه عما كان منتظرا.
حدث أن عاد مصنع الأحلام في عاصمة السينما بعد امتناع دام سبعة أعوام، إلى انتاج أفلام موسيقية مثل “جو عاصف” و”كابينة في السماء” (1943)، كل ممثليها وممثلاتها سود البشرة، وكل الأدوار المسندة إليهم عادية من ذلك النوع الذي يمارسه الناس في حياتهم اليومية، متى كانوا أحرار.
وحدث أن بدأ الرجال السود في الظهور على الشاشات في أدوار محاربين بواسل، لا يبالون بشيء في سبيل بلادهم، وفي سبيل تحقيق النصر على طاعون النازية، أكثر أنواع العنصرية خطورة، وأشدها فتكاً.
وبعد أن ألقت تلك الحرب سلاحها بقليل، وبالتحديد عام 1949 جرى عرض ثلاثة أفلام في أوقات متقاربة هي “موطن الشجعان” و”وبينكي” و”الحدود المفقودة” وكان من بين ما يميزها أنها تناولت بصراحة غير معهودة مأساة الاضطهاد العنصري الذي مبعثه التفرقة بين الناس على أساس الألوان.
ومما يلاحظ على الفيلمين الأخرين أنهما عرضا للتمييز العنصري ضد السود من خلال معذبين، مضطهدين لأنهم بيض ناصعو البياض، ولكنهم منحدرون من أصول سوداء، شأنهم في ذلك شأن كنجزبلد بطل قصة “كنجزبلد رويال” لصاحبها الأديب الأمريكي المتوّج بجائزة نوبل “سنكلير لويس” ذلك البطل الأشقر، الأزرق العينين الذي ما أن يكتشف، وياليته ما اكتشف، أن أحد أجداده القدامى من السود، حتى يصبح منبوذاً، مشرداً، فاقداً للاحترام.
الحب المستحيل
ورغم الحرب، ورغم انتهائها باندحار النازية، رغم كل ذلك ظل أمراً ممتنعاً على أفلام هوليوود أن تظهر رجلا أسود يطارح امرأة بيضاء الغرام، أو أن تلمح إلى ذلك، ولو من بعيد.
وبقي الحال هكذا إلى أن حدث أمر لم يكن في الحسبان عندما طارح “هاري بلافونت” وهو أسود- جوان فونتين- وهي بيضاء، طارحها الغرام في فيلم “جزيرة في الشمس” (1959)، ومع ذلك كان لابد لهذا الغرام أن ينتهي بالفراق لا لسبب سوى أنه ليس من طبائع الأمور أن يكون للحب بين أسود وبيضاء ختام سعيد.
ولم تكد تمر أربعة أعوام على الغرام في جزيرة الشمس، حتى فاز “سيدني بواتيه” باوسكار أفضل ممثل رئيسي عن تقمصه في فيلم “زنابق المروج” لدور عامل جائل، يلتقي براهبات ألمانيات متفانيات في حب المسيح، يقمن ببناء مكان للعبادة والصلاة، فيساعدهن حتى يستكملن التشييد.
السينما لغة العصر
وكان بذلك أول ممثل أسود يفوز بتلك الجائزة على امتداد ستة وثلاثين عاماً من عمر اوسكار المديد!
ومع تصاعد حركة العصيان المدني ضد التفرقة العنصرية قام “ستانلي كرامر” باخراج فيلمه “خمّن من القادم إلى العشاء” (1967).
وفيه تفاجيء الابنة “كاترين هوتون” والديها سبنسر تراسي” و”كاترين هيبرن”، وهما من علية الطبقة المتوسطة البيضاء، تفاجئهما بأنها قد دعت إلى العشاء شاباً ملوناً “سيدني بواتييه” عقدت العزم على الزواج منه، حتى ولو كره الآباء.
وينتهي الفيلم بفوزها برضاء الوالدين، بعد أن تبين لهما أن الحبيب الملون عالم يشغل مركزاً مرموقاً في الأمم المتحدة وعلى خلق عظيم !!
وطبعاً، هذه الصورة الوردية للسود لم يكتب لها أن تدوم طويلاً.
فسرعان ما عملت استديوهات هوليوود على اظهارهم في أفلام لا يلعبون في معظمها إلا أدوار أشرار يعيثون في الأرض فسادا.
الموجة السابعة
ولم يكن لهذا الوضع الشاذ أن يستمر بأي حال من الأحوال، لاسيما بعد الانتصارات التي تحققت للسود في مجال الحقوق المدنية بفضل الزعيم “مارتن لوثر كنج” الذي مات مغتالاً.
وكيفما كان الأمر، فمع زحف الثمانينات بدأت كوكبة من الممثلين والمخرجين السود في الظهور، تألق من بينها “ايدي ميرفي” الذي أصبح نجماً يشار إليه بالبنان، مما اضطر شركة بارامونت ذات الجلال، إلى أن تحتكر موهبته في ستة أفلام مقابل أربعة وعشرين مليون دولار.
و”سبايك لي” المخرج الذي أدهش مهرجان كان قبل عامين بفيلمه “اعمل الصح” الذي عرض فيه بأسلوب سينمائي آخاذ فكرته القائمة على عدم امكان التعايش بين البيض والسود في أحد الأحياء الشعبية بنيويورك، تلك المدينة، أو بمعنى أصح، الغابة التي ناطحت السحاب بمخلوقاتها العجيبة المتصارعة التي تنهش بعضها، ولكن بغير أنياب وإلى تلك الفكرة الأثيرة عاد “لي” في آخر أفلامه “حمى الأدغال” (1991) الذي جرى عرضه في مهرجان كان الأخير، حيث كان قاب قوسين أو أدنى من السعفة الذهبية، الجائزة الكبرى لذلك المهرجان.
وما أن تمر أيام معدودة، إلا ويعود إلى فكرته تلك مرة أخرى، عندما يبدأ تصوير فيلمه المنتظر “مالكولم أكس” الذي يقال أنه قد اعتمد لانتاجه خمسة وثلاثين مليون دولار وأيضاً يقال أن بعض مشاهده سيجري تصويرها في القاهرة، إلا إذا حال دون ذلك تزمت الرقابة المقيت، وهو تزمت لابد وأن يضعه أي مبدع في الحسبان.
شعاع الابداع
المهم أن “لي” قد راح بأفلامه يفعل فعل السحر في قلوب حفنة من المخرجين الشبان السود، فإذا بهم يبدعون تسعة عشر فيلماً خلال الأشهر القليلة الماضية، وهو عدد يعادل، إن لم يكن يزيد عمّا انتج من أفلام لجميع المخرجين السود في غضون عقد الثمانينات.
ولعل المخرجين “جون سنجلتون” و”ماتي رش” و”جوفاسكويز” و”ماريون فان بيبلز” الذي حقق فيلمه “مدينة نيوجاك” خلال أسابيع ايرادات بلغت أربعة وأربعين مليون دولار، و”جون سايلز” بفيلمه “مدينة الأمل” الذي أجمع النقاد على الاشادة به، مما قد ينهض سبباً لترشيحه لجائزة اوسكار، لعلهم أهم مخرجي تلك الموجة الجديدة.
ويعتبر”رش” و”سنجلتون” أصغر المخرجين الخمسة سناً. فالأول ليس له من العمر سوى تسعة عشر ربيعا. أما الثاني فلا يزال في الثالثة والعشرين.
فكر الفقر
وعند فيلم “طريق بروكلين” لصاحبه “رش” أقف قليلاً، لأن له قصة تخلص في أنه لم يكلف المخرج الشاب سوى سبعين ألف دولار.
ولضيق ذات اليد، لم يستطع أن يستكمل توليفه إلا بفضل “جونثان ديم” وهو مخرج أبيض مضطهد، وصاحب فيلم “جودي فوستر” الأخير “صمت الحملان” الذي يعتبر واحداً من أنجح أفلام الموسم فنياً وتجارياً.
ذلك أنه ما أن رأى فيلم “رش”- وهو في مرحلته الأخيرة السابقة مباشرة على التوليف- حتى تحمس له تحمساً شديداً.
وكان أن هيأ له منتجاً ساعد مخرجه الشاب على وضع اللمسات الأخيرة التي جعلت منه فيلماً رائعاً.
التزويق والتشويه
واضح إذن أن هوليوود، وصناعة الأفلام فيها تعاني الآن من فقر في الفكر، قد تنبهت إلى مواهب هؤلاء المخرجين، وحكاياتهم الغريبة التي ليس لها مثيل، تلك الحكايات التي لو تحولت إلى أفلام قليلة التكاليف، لعوضت أرباحها الخسائر الناجمة عن الأفلام الضخمة التي ينفق على انتاجها عشرات الملايين من عزيز الدولارات.
ولا غرابة في هذا الحماس، فالجمهور الامريكي المنحدر من أصول أفريقية، يشكل ثلاثة وعشرين في المائة من رواد السينما، وهي نسبة أعلى بكثير من نسبة عدد السود إلى العدد الاجمالي لسكان بلاد العم سام.
والأكيد.. الأكيد أن هذا الجمهور العريض يريد أن يرى العالم الذي يعيشه كما هو في الواقع بكل أفراحه وأتراحه، وليس كما هو في تصور البيض، عالماً إما مزوقاً كما هو الحال في “اللون الارجواني”، ذلك الفيلم الذي أخرجه “ستيفن سبيلبرج” صاحب الفك المفترس، وإما مشوهاً كما هو الحال في فيلم “الاشباح” الذي أدت فيه النجمة “ووبي جولدبرج” دور نصابة محضرة أرواح، وبفضله فازت باوسكار أفضل ممثلة مساعدة، بعد خمسين عاماً من فوز “ماكدونال” بها عن دور خادمة في “ذهب مع الريح”.
مدرسة المشاغبين
والغريب في الأمر أن نفراً من الشباب الأسود عندما رأى صورته على الشاشة كما تخيلها مخرجو تلك الموجة، وبخاصة فيلم “سنجلتون” المسمى “أولاد الغابة” لم يرقه ما رأى، فكان أن هاج غاضباً، مثيراً أنواعاً من الشغب، أدت إلى اصابة مئات المتفرجين، بل وإلى مقتل البعض.
مما كان سبباً في جنوح عدد من أصحاب دور السينما، إما إلى وقف عرض أفلام المخرجين السود، وإما إلى الامتناع عن عرضها أصلاً.
وفي رأي”سنجلتون” أن الشغب لم يحدث بسبب فيلمه، وإنما بسبب جيل كامل من فتية سود فقدوا احترام الذات، الأمر الذي سهل تبادل الطلقات حتى اسالة الدماء.
إنه جيل بلا أب يتخذه مثلاً يحتذى، جيل باحث عن الرجولة فلا يجدها إلا في السلاح، وتوهم أنه قد دخل بفضله في زمرة الأسياد الأحرار.
وغني عن البيان أنه ليس ثمة علاقة بين كل هذا وبين فيلمه، ومن ثم ما كان يجوز وقف عرضه لمجرد تبادل اللكمات والطلقات.
فمثل هذا التقاتل معتاد الحدوث في شوارع “لوس انجلوس” ويواصل دفاعه قائلاً: فيلمي لم يوقف عرضة إلا لسبب واحد، هو أن جميع ممثليه ومبدعيه من السود.
والوقف لمثل هذا السبب لا يعدوا أن يكون نوعاً من التفرقة العنصرية في ساحة الفن.
واذا كان الأمر كما يتهم صاحب “أولاد الغابة”، فهذا يعني أن شيئاً ما يُدَبّر في الخفاء ضد موجة المخرجين السود وأفلامهم الأكثر صدقاً في التعبير عن مشاكل الأقلية السوداء.