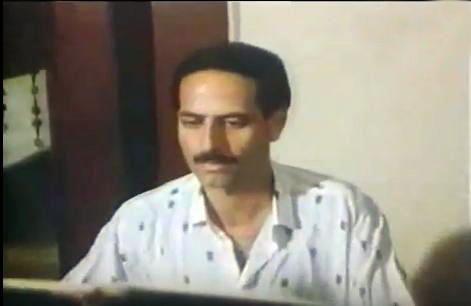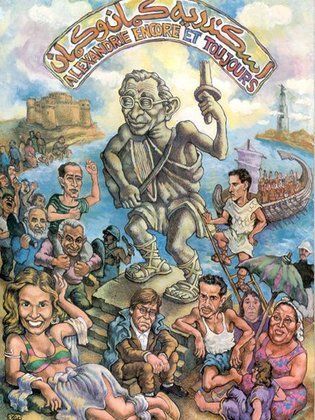لو ألقينا نظرة طائرة على الأفلام المصرية الجديدة المعروضة حاليا بدور السينما، لاستبان لنا أنها جميعاً، فيما عدا “الحكم لله” لصاحبه “حسام الدين مصطفى”، من ابداع صانعي أطياف متخرجين في معهد السينما بالقاهرة، أو في غيره من معاهدها على امتداد العالم الفسيح.
إنها في مجموعها مخيبة لما علق على هؤلاء المخرجين من آمال كبار، لا استثني من ذلك حتى “سوبر ماركت” للمخرج “محمد خان”.
فمن المعروف عن صاحب الفيلم الأخير أنه من المخرجين القلائل عندنا الذين لهم رؤية. ومن ثم يعتبر أي فيلم له حدثاً فنياً مثيراً للجدل، مستوجباً للاهتمام.
وهو في “سوبر ماركت” كما في “عودة مواطن” من قبل، وكلاهما لكاتب سيناريو واحد “عاصم توفيق”، إنما يعرض للمشكلة التي تؤرق باله وبال كل من يهمه أمر مصر، ألا وهي فساد الأوضاع في مجتمع تحرر من كثير جداً من قوانين الخلق والعرف تحت تأثير الإذعان لقيم الانفتاح، وما نشأ عنه من تعقيد بغيض في العلاقات داخل الأسرة الواحدة.
فإذا بها تتمزق، وإذا بالأزواج والأباء والأبناء والأشقاء بعضهم لبعض عدو.
لعنة الأشياء
وإذا بالمجتمع عاجز عن أن يقول في هذا كله شيئاً، أو أن يقاوم هذا كله بشيء..
وما تمزق في “سوبر ماركت” خان، هو ما كان بين الأم “أميرة” (نجلاء فتحي) التي تعمل بائعة في أحد محلات السوبر ماركت وبين ابنتها الوحيدة “ناهد” (مريم مخيون) من علاقات قوامها الحب والعطف والحنان، وذلك عندما عاد الأب مطلق الأم (نبيل الحلفاوي) إلى مصر بعد غياب في الكويت طال عشرة أعوام، مستصحباً زوجة عاقراً، واسعة الثراء، وأموالا تعد بالملايين.
فها هو ذا، يلوح للابنة الصغيرة بأشياء الحياة اللذيذة.. العربة المرسيدس الفارهة، فنادق النجوم الخمسة، السكن الأبهة، السهر في المراقص والملابس الغالية الغريبة..
مستهدفاً من وراء كل هذا الأغراء جذبها من فلك أمها إلى عالمه حيث لا وزن ولا قيمة إلا للأشياء.
وطبعاً لا تصمد الصغيرة طويلاً ومع الفقدان لها نهائياً بسبب تشيئها تسقط الأم هي الأخرى في مستنقع الأغراء.
وهاهي ذي، قريباً من نهاية الفيلم غانية في صحبة طبيب مليونير زير نساء “الدكتور عزمي” (عادل أدهم) اتخذ من مقولته المفضلة “الفلوس إما تسرقها أو تورثها أو تتجوزها” شعاراً له في ممارسة الحياة وفقاً لما يهوى ويشاء.
وأغلب الظن أن فكرة فساد العلاقات بين الأم والأبنة لأسباب تتصل بالثروة والجاه – وهي فكرة الفيلم الرئيسية – مأخوذة عن “ميلدريد بيرس”، ذلك الفيلم الأمريكي الذي أدت فيه النجمة الأسطورة “جوان كروفورد” دور أم مطلقة وهو دور أهّلها للفوز لأول وآخر مرة بأوسكار أفضل ممثلة (1946).
وكما أميرة في “سوبر ماركت” فقد كلفت “ميلدريد بيرس” بابنتها كلفاً شديداً، وعنيت بتربيتها عناية متصلة. غير أنه في آخر الأمر، وحين تتقدم السن بالابنة، تفسد العلاقة بينها وبين الأم شيئاً فشيئاً، لأسباب لعل أهمها أن الأم كانت قبل أن تشق طريقها إلى الثراء امرأة عاملة من عامة الشعب.
البرود.. لماذا ؟
ومهما يكن من الأمر، فعادة يتوقع لفيلم مداره فكرة تدهور العلاقة بين الأم والابنة لما سلف ذكره من أسباب، أن نشاهده بشيء من الحرارة.
ولكن ما حدث بالنسبة لسوبر ماركت خان كان على العكس من ذلك تماماً.
فلقد شاهدناه، والحق يقال، بكثير من البرود.. لماذا ؟
لأن صاحبه آثر تغليب العقل على القلب، والرأي على العاطفة. وعلاوة على هذا، ارتكب خطأين ليس لأحد أن يغتفرهما في أي عمل جاد.
أولهما: الاسراف في الجنوح إلى التعبير المباشر في عمل يعتمد بحكم بنائه الدرامي لا على الكلام، بل على التفاصيل كملامح الوجه والضوء والظلال.
ولعل خير مثل على هذا الجنوح، ذلك المشهد الذي نفاجأ فيه “برمزي” (ممدوح عبد العليم) الموسيقار المولع بالموسيقى الكلاسيكية، وهو يواجه الطبيب المليونير متمرداً، متحدياً صيانة لكرامته، قائلاً أنه ليس على استعداد أن يعمل لحسابة قواداً.
أما الخطأ الثاني: غير المغتفر فهو اختيار الوجه الجديد “مريم مخيون” لأداء دور الصغيرة.
فالأكيد حسب مسار الفيلم وتداعي أحداثه أن دورها فيه من ذلك النوع المحوري.
والأكيد الأكيد أن وجهها لا تنبعث منه الشرارة المتقدة التي تستولي على المشاعر، وتهز القلب والوجدان.
أخطاء بالجملة
فإذا ما انتقلنا إلى “السقوط” للمخرج “عادل الأعسر” لوجدنا أنفسنا أمام فيلم لا يتصور أن يكون صاحبه قد تعلم ألف باء السينما.
فالأخطاء فيه من ذلك النوع الذي يدخل في باب الإهمال الجسيم.
وأحد الأمثلة على ذلك، وما أكثرها، عدم محاولة مخرجه مع مصوره الحاج “محمد طاهر” التخلص من انعكاسات الضوء على الصورة في مشهد النيل حيث يستقل “حسن” (فاروق الفيشاوي) برفقة “توحيدة” (مديحة كامل) قارباً شراعياً لزوم الغرام.
فقد أخفت تلك الانعكاسات وجهي الحبيبين، حتى أننا طيلة المشهد ، لم نستطع أن نرى من ملامحهما شيئاً..
وثمة مثل ثان على هذا الإهمال في مشهد آخر تجري وقائعه داخل سنترال التيلفون حيث نرى “حسن” يشق بطن بطيخه، فإذا بها حمراء تسر الناظرين. وهو في المشهد لا يكتفي بذلك، بل يتذوقها سعيداً بحلاوتها وطعمها اللذيذ.
وهنا يشاء المخرج “لحسن” أن ينتقل إلى مكان آخر غير بعيد عن البطيخة التي استطعمها، ليعود به في اللقطة التالية إلى حيث توجد، فإذا بها بطيخة سليمة لم تمسسها سكين.
وذلك الغياب للوحدة في تتابع اللقطات، إنما يرجع إلى اهمال تسجيل كل الملاحظات بمحتويات المنظر وتكوين الصورة في كل لقطة، وفي كل موقف، حتى يبدو كل شيء في نهاية الأمر طبيعياً ومنساباً.
أما إذا انتقلنا – بعد هذه المهازل – إلى الموضوع فسنجده، حسب الظاهر،، يدور حول التصنت.
بعد السقوط
فبطلاه “حسن” و”توحيدة” يعملان في أحد السنترالات. وهما بحكم عملهما، يستطيعان التصنت على المكالمات ووفقاً لسيناريو الفيلم الذي كتبه “محمد الباسوس” وهو بدوره متخرج في معهد السينما، نراهما وهما ينحدران رويداً رويداً من اللهو باستعمال امكانيات التصنت المتاحة لهما إلى استغلالها، بفضل ما حصلا عليه من معلومات في الابتزاز.
إذن فنحن أمام موضوع جديد على السينما عندنا أراه متأثراً بفيلم “فرانسيس فورد كوبولا” المعروف تحت اسم “المحادثة”، والذي جرى تتويجه بجائزة مهرجان كان الكبرى لعام 1974.
ولكن سرعان ما يضيع هذا الموضوع الجديد في متاهات حكايات فرعية كأزمة المساكن والسوق السوداء والخيانة الزوجية وفساد القطاع العام، بحيث أصبح “السقوط” في نهاية الأمر فيلما يدور حول معان قديمة، منبتة الصلة بالتصنت بما يحمله في طياته من اعتداء أثيم على الحرمات.
أفلام الكيف
والآن إلى “الأمبراطور” و”شبكة الموت” وكلاهما من تلك الأفلام التي تدور وجوداً وعدماً حول تهريب المخدرات، وبالذات الهيروين.
وكلاهما يطرح الفكرة المستهلكة القائلة بأن السموم البيضاء إنما تتسرب إلى أرض الوطن العزيز لشيء سوى أن ثمة نفراً في قمة السلطة قد تورطوا مع عصابات تهريب دولية لليهود فيها نفوذ كبير.
وما أحب أن أتوقف كثيراً عند “الأمبراطور” أول فيلم “لطارق العريان” المتخرج في أحد معاهد السينما بالولايات المتحدة، لسببين.

أولهما لأنه لم يعرض بعد عرضاً عاماً في دور السينما.
وثانيهما لأنه يشبه الفيلم الأمريكي “الوجه ذو الندبة” لصاحبه المخرج “بريان دي بالما” في كثير من الوجوه.
وقد يكون من اللازم مشاهدة الفيلم الأخير مرة أخرى قبل القفز إلى اتهام “الأمبراطور” بأنه لا يعدو أن يكون صورة مشوهة من فيلم “دي بالما”.
يبقى “شبكة الموت” لصاحبه المخرج “نادر جلال” وفيه تلعب “نادية الجندي” او نجمة الجماهير كما يحلو لها أن تسمي نفسها في ملصقات أفلامها، دور امرأة دبّاحة للرجال، مستعينة في أدائها بكل أسلحتها القديمة، بما في ذلك تعرية كل ما سمحت الرقابة بتعريته في حدود حسن الآداب والنظام العام فضلاً عن هز البطن بكفاءة واقتدار معلمات الرقص الكبار أمام حشد رهيب من أخطر مهربي الهيروين، يلهو ويلعب في إحدى علب الليل بمدينة اثينا.
أقول اثينا لأن أهم أحداث الفيلم إنما تدور في عاصمة الأغريق حيث يقيم مهرب المخدرات “بسيوني” الشهير “بيلي” (فاروق الفيشاوي مرة أخرى).
وحين تذهب إليه “نور” (نادية الجندي) بتكليف من أجهزة الأمن المصرية على أعلى مستوى، التي رأت غرسها وسط عصابة المهرب المذكور كما “رأفت الهجان” وذلك بعد إذ تبين لتلك الأجهزة أنها كانت، وهي فتاة على علاقة حب به، لم تدم طويلاً.
أما لماذا وافقت “نور” على ركوب المخاطر في سبيل مصر، فسيناريو الفيلم – وهو من تأليف بشير الديك – يرجع ذلك إلى سببين متضاربين.
التخليط
الأول: التهديد والوعيد، فهي حين ترفض الإذعان إلى طلب الأجهزة التعاون معها، تُلفق لها تهم من بينها الاتجار في العملات المهربة، ومن ثم، يزجّ بها في السجن مع نساء احترفن كل ألوان الشذوذ والأجرام.
الثاني: الاقناع والترغيب، فهي حيث تعرف أن حبيبها القديم مهرب للسموم البيضاء، تلك السموم التي راحت ضحيتها ابنتها الوحيدة التي في عمر الزهور، تسرع بالموافقة على الانخراط في سلك المجاهدين والمجاهدات في سبيل تخليص الانسانية جمعاء من الأشرار تجار السموم البيضاء.
غير أن السيناريو لم يقل – وما أكثر اللغو الذي قاله- لماذا لم تلجأ تلك الأجهزة بداءة إلى أسلوب الإقناع المتحضر بعرض المهمة القومية الانسانية على نجمة الجماهير طالما أنه كان لديها الاستعداد نفسياً– بسبب ابنتها – للقبول، بدلاً من الابتداء معها بوسائل قهر غير مشروعة، وصلت في القسوة إلى حد الالقاء بها في غيابات السجون مع خساس النساء !!
قصة المدينتين
ومن عجب أن يجئ رسم شخصية المجرم “بيلي” مهلهلاً، مخلخلاً، وذلك رغم أن “بشير الديك” من أبرع كاتبي السيناريو في مصر، وعلى كُلٍ، فذلك التهلهل والتخلخل أمر متوقع بالنسبة لأية شخصية في أي من أفلام نجمة الجماهير.
ومن هنا عدم الدهشة من أن نرى مجرماً من طراز “بيلي” لا يتورع عن ارتكاب أبشع الجرائم وأضلها سبيلاً، نراه وقد انهار في ثوان أمام جسد نجمة الجماهير، وهو يتثنى ويتلوى أمامه في أحد ملاهي اثينا بعد انقطاع في الحب الذي كان بينهما دام خمسة عشر عاماً أو يزيد.
ثم نراه مرة أخرى، وهو الذي سبق وأن قال أنه لابد أن يظل أسداً في عالم أشبه بالغابة وإلا افترسته الذئاب، نراه وقد تحول إلى حمل وديع يقطر رقة لمجرد سماعه أن الصبية المدمنة المنحرفة التي جرى اجهاضها بدل المرة ثلاث مرات، من لحمة ودمه أنجبتها له نجمة الجماهير..
وإذا به ما أن يصله، إثر علمه بأن له صبية، خبر إصابتها في حادث إصابة جسيمة، وهو خبر كاذب سلل إليه بقصد استدراجه من اثينا إلى كمين منصوب له في القاهرة، حتى يسرع بالسفر إلى مصر كي يكون بجوار فلذة كبده، وهو الذي لم يكن يعلم بوجودها قبل أيام !!
وفي الختام، فلن أعرض لتفاصيل أخرى ساذجة يطفحها “شبكة الموت” ذلك الفيلم الذي أراه عملاً سينمائياً غير مستحب، كل ما فيه لغو وثرثرة، وكل ما فيه أمره غريب على “بشير الديك” صاحب”سواق الأوتوبيس” و”الطوفان”..