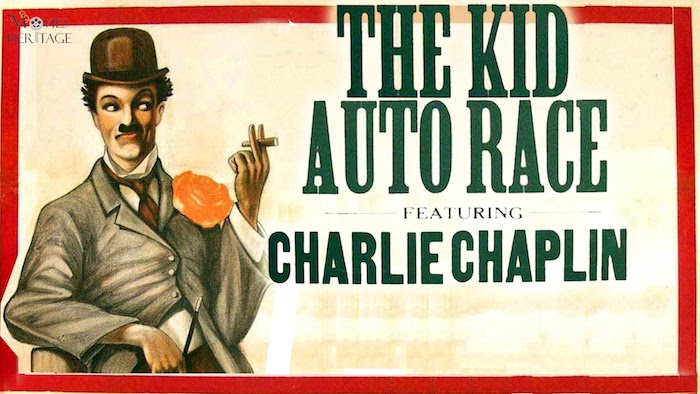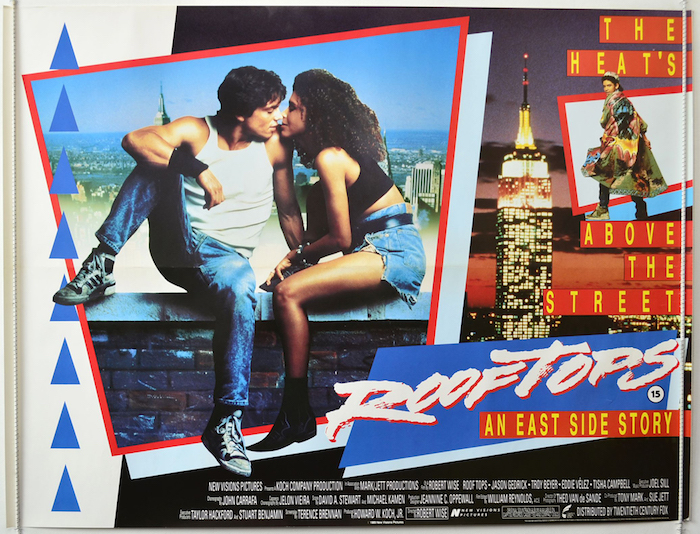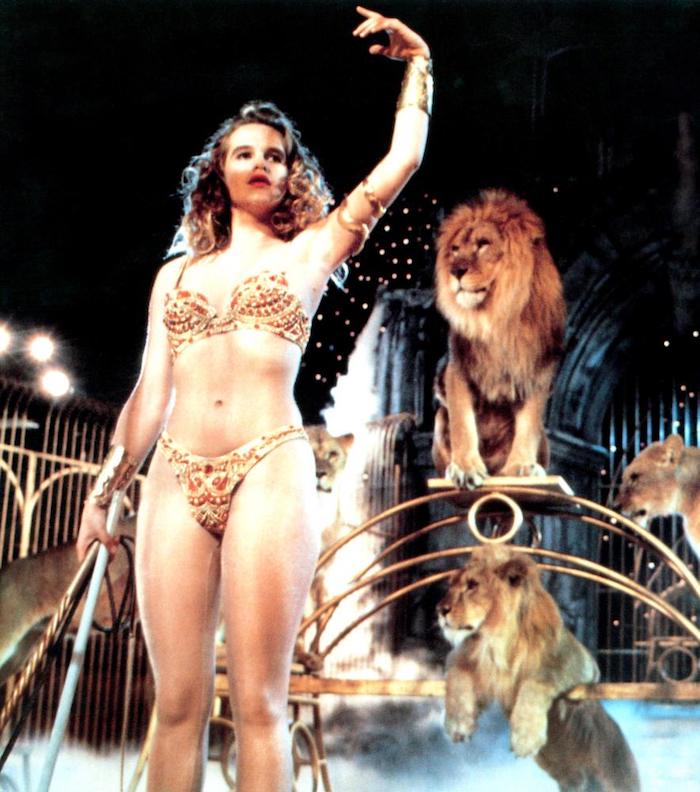كلمة “هولوكوست” من الكلمات التي لها تاريخ يرتد إلى أيام الرومان، فهي لاتينية الأصل، تعني الإبادة الكاملة، لاسيما بالاحراق.
ولم يكن للإبادة بذلك المعنى علاقة باليهود لا من قريب ولا من بعيد.
وظل الحال كذلك إلى أن بدأت محاكمات مجرمي الحرب في نورمبرج عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية بانحدار المانيا الهتلرية.
فبفضل تلك المحاكمات تكشف للعالم أن من بين جرائم النازية- وهي كثير- تبني سياسة تقوم على أساس تقسيم الشعوب عنصرياً إلى شعوب راقية تتحكم وتسود، وأخرى منحطة لا تستحق البقاء.
العاصفة المميتة
وكان من مقتضى تلك السياسة المسرفة في عنصريتها حشد الأفراد المنتمين إلى تلك الشعوب المقول بانحطاطها، حشدها في معسكرات اعتقال تمهيداً للإلقاء بهم في أفران أعدت خصيصاً لقتلهم جماعياً بغازات سريعة المفعول، حتى إذا ما جاءهم الموت بغته، تم حرقهم بنيران حامية لا تبقى من جثثهم شيئاً.
وما أن ذاع أمر هذه الجريمة البشعة، حتى تطلعت على الانسانية كلمة “هولوكوست” يعبر بها عن أهوال الاصطلاء بنيران تلك الأفران.
فإذا بها تعطي الآثر المراد من استعمالها لا أقل ولا أكثر وإذا بها منصرفة منذ البداية إلى جميع ضحايا المحرقة سواء أكانوا من الروس أو البولنديين أو الغجر أو اليهود أو غير ذلك من الشعوب التي اصطلت بتلك النيران.
وجملة القول أنها كانت كلمة مناسبة تماماً للمقام.
تحريف التاريخ
ثم تتقدم الأعوام، وإذا بأخبار كابوس المحرقة ينتشر رويداً على وجه يوحي باقتصار المحنة الكبرى على اليهود دون غيرهم من الشعوب.
وإذا بالكلمة تتعرض لتشويه أحالها إلى لفظة لا تعني كلما قيلت سوى شيء واحد.. محرقة اليهود.
ونتيجة لذلك كاد جميع ضحايا تلك المحنة، فيما عدا اليهود، أن يختفوا من على شاشة الذاكرة.
وهكذا كتب على ضحايا المحرقة- باستثناء اليهود- الإبادة مرتين الأولى بواسطة هتلر وجلادية والثانية بواسطة محرفي التاريخ.
والآن، وبمناسبة ذكرى مرور نصف قرن من عمر الزمن، على نشوب الحرب العالمية الثانية وخمسة وأربعين عاماً على انتهائها، خرجت علينا مطابع دور النشر في الغرب بكتب عديدة عن المحرقة من بينها “الكل أو لا شيء”: المحور والمحرقة (هولوكوست) لصاحبه “جوناثان شتا ينبرج”، “لماذا تظلم السماوات – الحل النهائي ” لصاحبه “ارنومايير” و”نهاية المحرقة.. تحرير المعسكرات” لصاحبه “يون بريد جمان” و”الشرطي ابتسم” لصاحبه “باري تيرنر” و”ظلال لا تنمحي.. الفيلم والمحرقة” لصاحبته الدكتورة “انيت انسدروف” “الطبعة الثانية”.
وهذه الكتب – جميعها وبلا استثناء – تتناول مأساة المحرقة من منطلق أن اليهود وحدهم هم الضحايا.
وأسجل، منذ الآن، أني لن أعرض من بين الكتب سالفة الذكر، إلا للكتاب الأخير، لا لشيء سوى أنه الكتاب الوحيد الذي تناول محرقة اليهود في السينما، فضلاً عن أن تناوله لها قد اتسم بالإمعان والتعمق.
وما أزعم لهذه المحاولة احاطة وشمولاً فهي لا تعدو أن تكون تمهيداً للكلام عن أهم أفلام أمريكية تناولت محرقة اليهود مما جرى عرضها خلال الأشهر الأخيرة.
وهي أفلام ثلاثة لا تزيد، أحدها “انتصار الروح” سبق وأن عرضت له باستفاضه هنا في مجلة الهلال (مايو 1990).
أما الفيلمان الآخران “أعداء.. قصة حب” و”صندوق الموسيقى”، فقد اتيحت لي فرصة مشاهدتهما أثناء زيارة أخيرة لباريس.
القديسون الجدد
وقبل الكلام عنهما أعود إلى كتاب “ظلال لا تنمحي”، فأقول أن صاحبته تنحدر من أسرة يهودية تعرضت للاضطهاد إبان فترة خضوع أوروبا للنير الهتلري، حتى أن والديها قد زجَّ بهما في غيابات معسكرات الاعتقال حيث أوشكا على الهلاك في محارق الأفران.
وثمة مقدمة لكتابها في طبعته الثانية بقلم “ايلي ڨيسيل” الحاصل على جائزة نوبل للسلام، وهو بدوره من المنتمين لشعب الله المختار، ومن الذين عانوا عذابات معسكرات الاعتقال، إلى أن هيأت له السماء مع فئه قليلة معجزة النجاة من موت أكيد.
وفي وصف من بقى من تلك الفئة على قيد الحياة، قال أحد أبطال فيلم “صندوق الموسيقى” أنهم بمثابة قديسين أبرار!!
وعلى كُلٍ، “فڨيسيل” في مقدمته تلك يقول أن عالم معسكرات الاعتقال “أوشڨتز” و”تربلينكا”، يتحدى التعبير بالكلمات.
ويتساءل، هل توجد وسيلة أخرى، لغة أخرى يمكن التعبير بها عن ذلك العالم.
وبعد أن يطرح الصورة وسيلة بديلة للتعبير، يعود فيقول أنها بدورها تثير مخاوفه، بل أن تخوفه منها أكثر بكثير.. لماذا ؟
لأن موضوع الإبادة الجماعية لليهود تنفيذاً لمخطط الحل النهائي، هو في حقيقة الأمر موضوع مقدس، وأي تناول له بواسطة وسائل الإعلام الجماهيرية، وبخاصة الأفلام، إنما يحمل في طياته خطر التدنيس لتلك القدسية.
غير أنه سرعان ما يستدرك قائلاً أن ثمه أفلام عن المحرقة تذهل بمصداقيتها، وأخرى تصدم بسوقيتها.
وفي رأيه أن من بين أفلام النوع الأول “الليل والضباب” للمخرج الفرنسي “آلان رينيه” صاحب “هيروشيما حبي” و”حديقة فينزي كونتيني” للمخرج الايطالي “فيتوريو دي سيكا” و”قيثرات الحفل” للمخرج الفرنسي”ميشيل دراش” و”الحانوت في الشارع الرئيسي” للمخرجين التشيكيين “يان كادار” و”المار كلوس”.
عش الغراب
أما بالنسبة للافلام الموصومة بالسوقية، فلم يتوقف “ڨيسيل” إلا عند المسلسل الأمريكي الشهير “المحرقة” قائلاً أن عرض أهوال المحرقة في صورة مغامرة رومانسية، لأمر مهين للموتى، جارح للاحساس.
وفي مقدمة أخرى، ولكنها لصاحبة الكتاب، جاء على لسانها ما مفاده، انه رغم أن ما شاهدته من أفلام عن المحرقة حتى عام 1980، قد بلغ عدده ستين فيلماً على الأقل، إلا أنها ما كادت تنتهي من وضع اللمسات الأخيرة على الطبعة الأولى لكتابها (1982)، حتى كان قد تم طرح عشرين فيلماً جديداً عن المحرقة ثم تكاثر عدد الأفلام التي من هذا القبيل على وجه يشبه تكاثر عش الغراب، حتى وصل الأمر قريباً من نهاية عام 1988 إلى أن ثمة حوالي مائة فيلم جديد ما بين روائي (40 فيلماً) وتسجيلي (60 فيلماً).
وهي جميعاً ليس بينها فيلم واحد لا يستحق أن يُشار إليه في الكتاب، ولو ببضع كلمات..
هذا ولو كان قد كتب للطبعة الثانية من كتابها أن يتأخر ظهورها وقتاً قصيراً، لوجدت نفسها أمام عدد غير قليل من أفلام جديدة تعرض للمحرقة من بينها “أعداء.. قصة حب” و”صندوق الموسيقى”.
وأغلب الظن أنها، ومهما اصطنعت الحذر والاحتياط، فما كانت لتطمئن لهذين الفيلمين، وما كانت لتتحمس لهما لا لسبب سوى أن الأول مسرف في السوقية، والثاني مفرط في الفاشية.. كيف ؟
تعدد الزوجات
“هرمان برودر” (رون سيلڨر) بطل “أعداء.. قصة حب” الفيلم المأخوذ عن رواية للأديب الأمريكي اليهودي “اسحاق سنجر”؛ ذلك البطل أحد الناجين من النار.. نار الأفران.
والفيلم يبدأ به مختبئاً في جرن، وكلاب النازي من حول المكان تنبح مسعورة.
أنه في كابوس، يشقى به أثناء اليقظة، وأثناء النوم وها هو ذا، يهب مفزوعاً، لنكتشف أنه ليس في أوروبا أيام النازية، وإنما في أمريكا وبالتحديد “كوني ايلاند” بنيويورك.
ولنكتشف، بعد ذلك، أنه يعيش مع “يادويجا” (مارجريت سوفي شتاين)، وهي فلاحة كانت تعمل خادمة في بيت عائلته اليهودية ببولندا، وكان لها فضل انقاذه من المحرقة بتوفير مكان أمين له في الريف حيث ظل مختبئاً زهاء ثلاثة أعوام إلى أن كتب له النجاة.
ورغم زواجه منها عرفاناً منه لجميلها عليه، إلا أن هذا لم يحل بينه وبين اقامة علاقة غرامية عاصفة مع “ماشا” (لينا أولين)، وهي أمراة يهودية ألّمت بها خطوب العذاب الذي لا يشبهه عذاب في معسكرات الاعتقال النازية والسوفييتية.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل انتهى، ازاء الحاح “ماشا”، إلى عقد قران بينهما جرى وفقاً للطقوس اليهودية.
كل ذلك، والزوجة “يادويجا” لا تعلم من أمر تلك الخيانة شيئاً.
وتمضي الأيام، وإذا بهرمان يلتقي فجأة في وسط نيويورك “بتامارا” (انجيليكا هوستون)، وهي أمراة يهودية كان قد تزوجها في بولندا قبل نشوب الحرب.
وكان من المفترض أنها وأولادها منه قد ماتوا جميعاً مقتولين برصاص الألمان.
وهكذا نجد “هرمان” وقد عبثت به الأقدار فإذا به صاحب ثلاث زوجات في آن واحد وهو نتيجة لذلك في حيرة مهلكة، لا يعرف لنفسه غاية يقف عندها، ولا يعرف كيف يصل إلى قرار.
ولعل خير وصف لحيرته تلك أحد مشاهد الفيلم حيث نراه داخل إحدى محطات مترو الأنفاق متردداً بين القطارت أيها يستقل.. قطار”كوني ايلاند” حيث “يادويجا” أم قطار “برونكس” حيث “ماشا” أم قطار وسط نويورك حيث “تامارا”.
الجنس اللذيذ
وفيلم له موضوع كهذا، ومن انتاج هولويوود وإخراج “بول مازورسكي”، لابد وأن يكون زاخراً بمواقف لا تخلو من فكاهة، ومشلهد لا تخلو من جنس فاضح، وآية ذلك المشاهد التي تصور علاقة هرمان بماشا.
فهي تصور حبهما الجامح المندفع كالسيل من خلال لقطات لهما، وهما عاريان يتصببان عرقاً.
وفي ظني أن تلك المشاهد هي التي حدت “بڨارايتي” أقدم مجلات السينما وأوسعها انتشاراً إلى وصف الفيلم.. وهي في مجال الثناء عليه – بأنه جنسي لذيذ.
وليس من شك أن الفيلم بتلك المشاهد التي آراها تجارية شديدة الابتذال، قد أساء إلى قداسة المحرقة القائل بها “ڨيسيل” في مقدمته سالفة الذكر.
فإذا ما انتقلنا إلى “صندوق الموسيقى”، لوجدنا أنفسنا أمام فيلم قال عنه صاحبه المخرج “كوستا جافراس” في حديث له مع مجلة “سينيياست” الأمريكية (العدد الثالث 1990)، أنه أراد بإخراجه إعادة المحرقة إلى الذاكرة، وبخاصة ذاكرة الشباب.
الماضي المجهول
والمحور الذي يدور حوله الفيلم وجوداً وعدماً هو العلاقة بين “مايك لازلو” الذي قام بأداء دوره الممثل الألماني الكبير “أرمين مويلر شتال” وابنته “أن تالبوت”، وقد قامت بأداء دورها النجمة الذائعة الصيت “جيسيكا لانج” و”لازلو” حسب سيناريو الفيلم الذي أبدعه “جواشترهاس”، مجري ترك وطنه مهاجراً إلى الولايات المتحدة عقب انتهاء الحرب العالمية بثلاثة أعوام. وبعد أن مضت الأيام حتى أصبحت أربعين عاماً، جاءه كتاب من وزارة العدل الأمريكية مفاده أنه متهم بإخفاء حقيقة مهنته في طلبه الذي مُنح بموجبه الجنسية الأمريكية.
وأنه في حالة ثبوت تلك التهمة، فلابد من ترحيله إلى المجر حيث تتجه النية إلى محاكمته عن جرائم بشعة اقترفها في حق اليهود.
وطبعاً ينكر “لازلو” الاتهامات الموجهه إليه، مُصّراً على أنه كان فلاحاً بسيطاً، وليس حارساً في فرق التعذيب والإبادة.
الولاء لمن؟
وتنبري ابنته “آن”– وهي محامية ماهرة– إلى الدفاع عنه، وذلك لأنها كانت تؤمن ببرائته مما يصفون.
وما أن تنتهي القضية بصدور حكم ببرائته، حتى يتضح لها، بفضل صور ثابتة لأبيها لا تقبل الشك، أنه من عتاة مجرمي الحرب.
وهنا يتنازعها ولاءان أحدهما الولاء للأسرة، والآخر الولاء للمجتمع.
وبعد تردد لم يدم طويلاً، تغلبت مسئوليتها نحو المجتمع على ولائها نحو أسرتها.
وها هي ذي تتصل بمكتب الإدعاء طالبة إليه إعادة إقامة الدعوى العمومية ضد أبيها على أساس الصور الثابتة التي في حوزتها.
والفيلم بتلك النهاية، إنما يريد أن يقول أن على الأبناء أن يشوا بالآباء إذا كان في ذلك تحقيق للصالح العام.
ومثل هذا القول لا يختلف في جوهره عما كان يدعو إليه أنصار النازية في سالف الزمان.