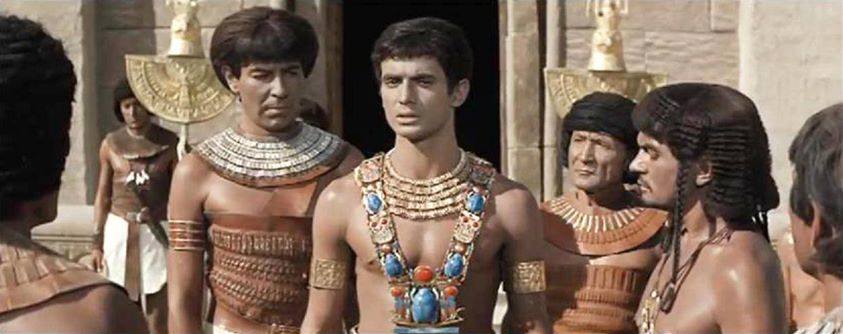تساءل الكثير عن الإمبراطور الأخير من هو، ولماذا توّج الفيلم الذي يدور حول مأساته بتسع جوائز أوسكار، وهو رقم لم يفز به أي فيلم منذ قصة الحي الغربي (1961).
والعجيب أن أحداً لم يتساءل لماذا لم يرشح لأية جائزة من هذه الجوائز المشتهاة فيلم تاريخي آخر يدور حول سيرة ويليم ووكر (1824-1860) ذلك المغامر الأمريكي الذي استولى على نيكاراجوا بنفر من الأشرار لا يزيد عددهم على الخمسين إلا قليلاً.
والعجب العجيب أن أحداً لم يتساءل لماذا لم يجر ترشيح “صرخة الحرية”- وهو الآخر فيلم تاريخي يعرض لسيرة المناضل الأفريقي “بيكو”- إلا لثلاث جوائز ثانوية ليست كبيرة الأهمية، ومع ذلك لم يكتب له أن يفوز بأي منها.
ولنترك “الإمبراطور الأخير” الذي ابتذلته حوادث الدهر، فانتهت به جناينياً في المدينة المحرمة بكين حيث بدأ حياته العامة إمبراطوراً، وهو في الثانية والنصف من سنيه، فلنتركه إلى حين.
الأمريكي القبيح
ولنبدأ بالفيلم الذي أخرجه الإنجليزي “أليكس كوكس” عن الأمريكي “ووكر” الذي استولى على نيكاراجوا بفئة قليلة من المحاربين.
من المعروف تاريخياً أن هذا المغامر قد عاش ومات في العصر الذهبي للاستعمار.
والفيلم الذي يعرض لمغامراته وطموحاته قد أنتج بالتعاون مع الساندينستا حكام نيكاراجوا الممتحنين بتدخل إدارة الرئيس الأمريكي “ريجان” في شئونهم امتحاناً أليماً.
ولا غرابة في هذا التعاون “فووكر” قد غزا نيكاراجوا (1855) حتى بلغ منها ما أراد، فأصبح رئيساً لجمهوريتها ولم يكتف بذلك بل فرض عليها نظام العبيد. وظل ينشر الفساد والاستبداد في ربوع أمريكا الوسطى حتى جاءه الموت ساحقاً ماحقاً برصاصات انطلقت إلى صدره من فوهات بنادق ثلة من جنود هندوراس (1860) وله من العمر 36 عاماً.
والشيء المحقق أن صاحب هذه السيرة غير العطرة التي ملأت الشريط الضيق الفاصل بين الأمريكتين هولاً كان في نظر معاصريه في الولايات المتحدة رجلاً من رجال الأقدار على حين أنه كان في أمريكا اللاتينية ولا يزال معتبراً رمزاً للشيطان.
الماضي والحاضر
ومن هنا سعي صاحب الفيلم إلى تصوير الجانب القبيح من حياة هذا المغامر على وجه يتيح للمشاهد، مع شيء من التفكير اليسير، أن يعقد مقارنة بين ما حدث في نيكاراجوا بعد منتصف القرن الماضي بقليل، وبين ما يحدث فيها الآن ونحن على عتبات القرن الواحد والعشرين.
وهو في سعيه هذا، قد لجأ إلى أسلوب أوبرالي فيه من البرختية والملهاة الشيء الكثير. وآية ذلك مزاوجته الطريفة بين أزمنة “ووكر” وأزمنتنا.
فها هي زجاجات الكوكاكولا تملأ الشاشة رغم أن اختراعها وقت أحداث الفيلم كان لا يزال في علم الغيب، وها هي مجلات أمريكا الشمالية الباحثة عن الإثارة تحمل على أغلفتها صورة “ووكر” وفتوحاته مما يذكرنا “بأوليفر نورث” بطل فضيحة “إيران- كونترا”، وطريقة معالجة الصحافة الأمريكية لها.
وها هي طائرة عمودية تهبط فجأة على أرض المعارك ليندفع منها جنود البحرية الأمريكية شاهرين السلاح.
وعلي كل، فليس يعنينا الآن ما أتيح لفيلم ووكر من الفوز جماهيرياً- وهو فوز عظيم- بقدر ما يعنينا أن نلاحظ أن الجهود التي بذلها مخرجه لكشف تدخل كل رجال الرئيس الأمريكي في شئون بلد صغير كنيكارجوا، ورد ذلك إلى أصوله التاريخية، هذه الجهود التي جعلته وحيد نوعه بين ركام الأفلام، قد انتهت بالمتحمسين له إلى الإخفاق حتى في ترشيحه إلى أية جائزة من جوائز أوسكار.
أبيض وأسود
فإذا ما انتقلنا إلى “صرخة الحرية”، فسنجد أنفسنا أمام واحد من أكثر أفلام العام الماضي نبلاً، وذلك لأنه من تلك الأعمال السينمائية النادرة التي تعرضت بجرأة وصدق لأهوال التمييز العنصري في جنوب أفريقيا.
 ولا عجب في هذا، فصاحبه ريتشارد اتينبره سبق له أن أخرج “غاندي” وهو فيلم عرض في مشاهده الأولى لهذا التمييز المقيت.
ولا عجب في هذا، فصاحبه ريتشارد اتينبره سبق له أن أخرج “غاندي” وهو فيلم عرض في مشاهده الأولى لهذا التمييز المقيت.
وقصة فيلمه الجديد كما “غاندي” ما هي إلا ترجمة حقيقية عاشها بطلاً “صرخة الحرية” “ستيف بيكو” و”رونالد وودز”.
وأحداث الفيلم تبدأ بـ”بيكو” مناضلاً أسود في ريعان الشباب، استقر في ضميره أن الشر كل الشر، والنكر كل النكر، هو في إذلال البيض للسود.
وأنه لابد من تغيير الأمور في جنوب أفريقيا بحيث تقام الصلات بين الناس، مهما تختلف ألوانهم على نظام من العدل والمساواة.
وتنشأ بينه وبين “وودز” محرر جريدة “ديلي ديسباتش”- وهو من البيض ذو نزعات إنسانية- صداقة قوية، بفضلها يزداد وعي “وودز” بخطر العنصرية ووحشيتها، فيصمم على مقاومتها، ما وسعته المقاومة، ولا يدخر في سبيل ذلك جهداً. ومع تفاقم الأحداث، يمر أمام أعيننا شريط دام من الفواجع.
فها نحن نرى هجمة الشرطة على مدينة الصفيح السوداء “كروس رودز” خارج مدينة “كيب تاون”، ونرى تحديد إقامة “بيكو” وكيف جعلت من منزله مكاناً أقرب إلى السجن منه إلى أي شيء آخر.
ثم نراه، حين يُلقى القبض عليه، ويُرمى به وراء القضبان، حتى نفاجأ به فاقد الحياة على أيدي شرطة لا ترحم.
مذبحة الأبرياء
وما أن يختفي “بيكو” بالقتل، حتى يبدأ النصف الثاني من “صرخة الحرية” حيث تمكر سلطة القهر بصديقه الأبيض “وودز” مكراً شديداً يكاد يخلو من قطرة إنسانية.
ولا أريد أن ألخص ما في هذا النصف وهو تصوير هروبه متخفياً في ثياب قسيس ومعه مخطوط كتابه عن “بيكو” يحكي فيه ما رأى، ويكشف فيه عن كل ما جرى. ولا أن ألخص محنة زوجته “وندي” وهي تحاول الفرار بأطفالها من الجحيم، حتى يكتب لها النجاة.
ولا أن ألخص محنة مشاهد مذبحة الأطفال السود في “سوويتو” (1976) أو محاكمة “بيكو” حيث استطاع بصدق لهجته من جهة، وبراعته الفنية من جهة أخرى أن يفضح النظام العنصري في جنوب أفريقيا وجرائمه، تلك المشاهد التي قطع بها مخرج الفيلم سياق السرد لرحلة هروب “وودز” إلى الحرية.
أسباب العقاب
وإنما اكتفى بتلخيص النظرية التي يعتمد عليها الفيلم بنصفيه فهو يريد أن يقول أن الصلة القائمة بين حياة البيض والسود قوامها الاستعلاء والاستكبار. البيض يعسفون ويخسفون، والسود يذوقون ألوان الذل والهوان.
فإذا ما حاولوا الخروج من ذلك إلى شيء من العزة والكرامة، ردهم البيض إلى حياتهم البغيضة أعنف الرد.
وأن يقول أيضاً أنه على البيض إذا ما وعوا أبعاد هذه الحياة المسرفة في الإذلال أن يقاوموا.
ومن هنا عقاب الفيلم بحجب جميع جوائز أوسكار عنه. فمثلاً أوسكار أحسن ممثل ثانوي لم يحصل عليها الممثل الملون “دينزل واشنطن” الذي كان مرشحاً لها عن أدائه لدور “بيكو” بجدارة، وحصل عليها “شين كونري” المشهور “بجيمس بوند” عن تقمصه لشخصية شرطي في خدمة الشعب ضد الفساد في آخر أفلام هوليوود عن المجرم “آل كابوني”ً وأوسكار أحسن أغنية لم تفز بها أنشودة “بيكو” بكلماتها التي تدفع إلى الصمود والنضال، وفازت بها أغنية عاطفية تافهة من فيلم لا غناء فيه “الرقص القذر”.
الفيلم الوليمة
والآن، عود إلى الإمبراطور الأخير، ذلك الفيلم الذي فاز بجميع الجوائز ذات الرنين. صاحبه هو “برناردو برتولوتشي”، المخرج الإيطالي الذي سبق له أن أبدع “قبل الثورة” و”المتلائم” و”التانجو الأخير في باريس” و”القرن العشرين”، وهي أربع روائع لها في تاريخ السينما أثر غير قليل.
 وأغلب الظن أنه أكثر المخرجين الثلاثة موهبة. (يلاحظ أن أحداً منهم لا يحمل الجنسية الأمريكية). وحتى عام 1978 كان عضواً في الحزب الشيوعي الإيطالي وتركه له لعله يعود إلى خلاف جوهري حول مفهوم المتعة في الفن وأشياء أخرى .. وهو في فيلمه الأخير يحكي بطريقتة مأساة الإمبراطور “بويي” الذي اختارته الإمبراطورة “تزوهو” خلفاً لها (1908) وهو لايزال في المهد صبيا.
وأغلب الظن أنه أكثر المخرجين الثلاثة موهبة. (يلاحظ أن أحداً منهم لا يحمل الجنسية الأمريكية). وحتى عام 1978 كان عضواً في الحزب الشيوعي الإيطالي وتركه له لعله يعود إلى خلاف جوهري حول مفهوم المتعة في الفن وأشياء أخرى .. وهو في فيلمه الأخير يحكي بطريقتة مأساة الإمبراطور “بويي” الذي اختارته الإمبراطورة “تزوهو” خلفاً لها (1908) وهو لايزال في المهد صبيا.
عبث الأقدار
وأحداث الفيلم تبدأ به مسجوناً (1950- 1959) بعد أن سلمه الروس إلى الصينيين اثر سقوط حكم الكومنتانج وارتفاع رايات الشيوعية في الصين عالية وكانت التهمة الموجهة إليه هي التعاون مع اليابانيين إبان حقبة احتلالهم للصين. وبلا هوادة سعي سجّانوه إلى تعليمه أو غسل مخه كما يقال في لغة المحللين النفسيين.
أثناء محاولاتهم هذه، ومن خلال بناء سينمائي. يقوم على لقطات تعود بنا إلى الماضي، يتوقف الفيلم عند لحظات من حياة الإمبرطور السجين: الأعمارالثلاثة الأولى (اثنان ونصف، عشرة، خمسة عشر عاماً) من حياته كإمبراطور طفل ومراهق.
 منفاه أثناء عقد العشرينيات، محاولاته مع المحتلين اليابانيين إعادة بناء إمبراطورية في منشوريا مسقط رأسه ثم الفشل النهائي. وفي الحق، فهذا الفشل قدر مكتوب عليه منذ البداية. فهو يتوج إمبراطوراً وله من العمر ثلاثون شهراً وهو- بعد ثلاثة أعوام من اعتلاء العرش- لا يملك من أمر الصين شيئاً لأن ثورة قامت وأعلنتها جمهورية. وهو رهين المدينة المحرمة لا يتركها إلا طريداً في بداية العشرينيات بعد تجريده نهائياً من اللقب الإمبراطوري. هو باختصار سجين طوال الفيلم دائماً أمامه سد لا يستطيع أن يتجاوزه. وسد التاريخ المنيع. وحيثما يستأنف السير في أي طريق فإنه لا ينتهي منه إلى غاية.
منفاه أثناء عقد العشرينيات، محاولاته مع المحتلين اليابانيين إعادة بناء إمبراطورية في منشوريا مسقط رأسه ثم الفشل النهائي. وفي الحق، فهذا الفشل قدر مكتوب عليه منذ البداية. فهو يتوج إمبراطوراً وله من العمر ثلاثون شهراً وهو- بعد ثلاثة أعوام من اعتلاء العرش- لا يملك من أمر الصين شيئاً لأن ثورة قامت وأعلنتها جمهورية. وهو رهين المدينة المحرمة لا يتركها إلا طريداً في بداية العشرينيات بعد تجريده نهائياً من اللقب الإمبراطوري. هو باختصار سجين طوال الفيلم دائماً أمامه سد لا يستطيع أن يتجاوزه. وسد التاريخ المنيع. وحيثما يستأنف السير في أي طريق فإنه لا ينتهي منه إلى غاية.
الحنين لم يعد كما كان
ولا يزال كذلك حتى يجد في سجنه الأخير عالماً جديداً غريباً يستطيع أن يعيش فيه متلائماً مع نفسه ومع الناس. أخيراً تنفتح أمامه الأبواب، فيعمل جناينياً في حدائق المدينة المحرمة حيث كان إمبراطوراً مقدساً وأخيراً يحيا ليموت راضياً مرضياً.
بعد هذا كله، فالإمبراطور الأخير فيه من الخصب والشاعرية والجمال ما لابد وأن يترك في السينما آثاراً بعيدة عميقة، ليس إلى محوها من سبيل.
 ومع ذلك فسدنة العدالة في هوليوود لم يتوجوه إمبراطوراً على جميع الأفلام إلا لأنه زاخر بالحنين إلى الصين القديمة.. صين الأرض الطيبة ( وهو فيلم حاز على جوائز أوسكار كثيرة خلال منتصف عقد الثلاثينيات) ومن هنا خروجه من حلبة الصراع على جوائز الأوسكار الكبرى. فائزاً لا شريك له.
ومع ذلك فسدنة العدالة في هوليوود لم يتوجوه إمبراطوراً على جميع الأفلام إلا لأنه زاخر بالحنين إلى الصين القديمة.. صين الأرض الطيبة ( وهو فيلم حاز على جوائز أوسكار كثيرة خلال منتصف عقد الثلاثينيات) ومن هنا خروجه من حلبة الصراع على جوائز الأوسكار الكبرى. فائزاً لا شريك له.