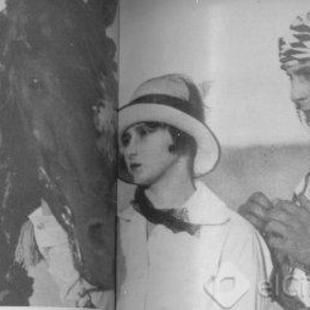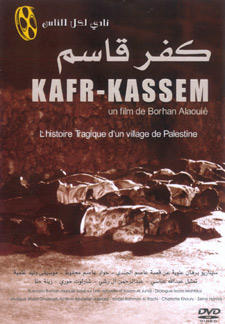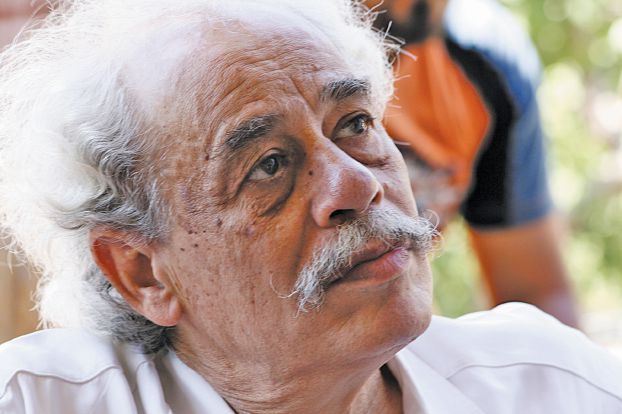لسبب ما أجدني تائها، لست أدري إلى أي من الأحداث السينمائية المتلاحقة أعرض، وعلى أي منها أركز.
هل أعرض لظهور “ليليان جيش” على شاشات مهرجان كان الأربعين باعتباره أكثر أحداث الشهور القليلة التي مضت إثارة ومدعاة للتفاؤل.. لماذا؟
 لأن هذه الممثلة قد بلغت في الرابع عشر من أكتوبر لعام 1986 التسعين من عمرها.
لأن هذه الممثلة قد بلغت في الرابع عشر من أكتوبر لعام 1986 التسعين من عمرها.
ومن المعروف أنها بدأت التمثيل في هوليوود مع شقيقتها الصغرى “دوروثي” في فيلم “عدو خفي” (1912) لصاحبه المخرج “دافيد جريفيث”.
ومنذ هذا التاريخ الذي أصبح خبراً في ظلمات الزمن، لم تنقطع “ليليان” عن التمثيل، سواء أمام الكاميرا أو على خشبة المسرح.
وقد كان الظن، وبعض الظن إثم، أنها تحت وطأة الشيخوخة وأعبائها الجسام، قد اعتزلت التمثيل منذ فيلم “زفاف” 1978 الذي لعبت فيه دور عجوز ثرية تفارق الحياة ليلة زفاف أحد الأحفاد.
ولكن ها هي لا تزال على الشاشة تتطلع إليها الأنظار، تشارك “بيت ديفيز” بطولة رائعة المخرج “ليندسي أندرسون” الأخيرة “حيتان أغسطس” (1978).
 وهاهي، بالألوان تزين صفحات مجلة “بريميير”. (يونية 1987)، تسرق الكاميرا من الأميرة اللعوب “ديانا” توقع بإمضائها لجمهور المعجبين المشدوهين، وتجيب على وابل الأسئلة في المؤتمر الصحفي المنعقد عقب عرض فيلمها الأخير بيقظة ولباقة منقطعتي النظير، تتذكر وتذكر بأجمل وأمجد أيام الريادة في عاصمة السينما التي بمرور مائة عام، احتفلوا قبل أيام.
وهاهي، بالألوان تزين صفحات مجلة “بريميير”. (يونية 1987)، تسرق الكاميرا من الأميرة اللعوب “ديانا” توقع بإمضائها لجمهور المعجبين المشدوهين، وتجيب على وابل الأسئلة في المؤتمر الصحفي المنعقد عقب عرض فيلمها الأخير بيقظة ولباقة منقطعتي النظير، تتذكر وتذكر بأجمل وأمجد أيام الريادة في عاصمة السينما التي بمرور مائة عام، احتفلوا قبل أيام.
والكلام عن النجمة اللامعة على امتداد خمسة وسبعين عاماً من عمر الزمن، لابد أن يجرنا إلى الحديث عن مكتشفها العبقري “جريفيث” وعنه كتب الأستاذ “ألكسندر دوتي” في العدد السادس (ربيع 1986) من مجلة البلاغة المقارنة “ألف” التي تصدر عن قسم الأدب الإنجليزي والمقارن بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، كتب بحثاً تحت عنوان “جماليات المكان والريف المثالي في أفلام “د. و. جريفيث”
السطحية.. لماذا؟
ولعله أول بحث عن جماليات السينما ينشر على صفحات مجلة متخصصة تصدر عن إحدى الجامعات على أرض مصر.
ومن بين ما جاء في هذا البحث القيّم أن “جريفيث” لم ينجح في مجال الإبداع السينمائي للمكان في تصوير حياة الأغنياء فكثيراً ما يبدو هذا التصوير سطحياً، جامداً، أقرب إلى “الكليشيه”، وذلك لأنه لم يبذل جهداً ابتغاء استكناه دلالة للمكان من خلال عناصر الإخراج والتصوير، حتي يغدوالإحساس به تطويراً بصرياً للشخصية وفكرة الفيلم السائدة، وامتداداً لهما.
وإذا كان تصوير جريفيث لأوساط الطبقات العليا، قد ظل سطحياً وتقليدياً فإن خبرته بحياة الطبقة الوسطى الريفية، وبمظاهر الفقر في المدن قد ساعدت على إضفاء دقة ومصداقية على تصويره السينمائي لهما، وذلك حتى في الحالات التي كانت فيها قصص الأفلام التي تعرض لهما مشوبة بطابع عاطفي ميلودرامي.
ألوان وأشجان
ومن عجائب الأشياء أن تظل ليليان حية في سن التسعين على الشاشة وخارجها، وحيدة نوعها لا شريك لها من نجوم جيلها، في حين أن من يصغرها سناً– وبعضهم بكثير قد عاجله موت لا يرحم.
“فأندريه وارهل” الرسام المخرج ورائد سينما تحت الأرض في نيويورك يختفي من الحياة بعد رصاصات انطلقت من غدارة “فاليريا سولانسي” لتستقر في جسمه منذ عشرين عاماً إلا قليلاً (1968) ليعقبها مرض عضال عطل كثيراً مما كان كامناً فيه من آيات الإبداع.
 وداليدا بنت شبرا تنتحر بعد أن رأيناها تحاول التمثيل لأول وآخر مرة في “اليوم السادس”، حيث أسند إليها دور غسالة ريفية من باب الشعرية، تحاول إنقاذ حفيدها الوحيد من وباء الكوليرا، ومع ذلك تنهزم أمام الموت.
وداليدا بنت شبرا تنتحر بعد أن رأيناها تحاول التمثيل لأول وآخر مرة في “اليوم السادس”، حيث أسند إليها دور غسالة ريفية من باب الشعرية، تحاول إنقاذ حفيدها الوحيد من وباء الكوليرا، ومع ذلك تنهزم أمام الموت.
و”دوجلاس سيرك” المخرج الأمريكي المنحدر من أصل نمساوي يجيؤه الموت وهو في السابعة والثمانين، فتفقد السينما العالمية واحداً ممن ساهموا في العلو بفن الميلودراما، والسمو بها في عالم الأطياف. فأفلامه التي أخرجها في الخمسينات، كانت تعبيراً صادقاً عن يأس الشرائح العليا من الطبقة المتوسطة، والقضاء الذي يسيطر على حياتها، ويصرفها كيف يشاء.
نجمة وأميرة
وما كاد العام يقترب من منتصفه حتى كانت وكالات الأنباء قد طيرت خبر وفاة ريتا هييوارث، تلك الراقصة المنحدرة من أصل أسباني والتي صنعت منها شركة كولومبيا لصاحبها “هاري كوهين” نجمة إغراء، فنجمة أميرة أقرب إلى الأسطورة. “ريتا” هذه التي ظلت طوال سنوات الحرب العالمية الثانية نجمة معبودة يتقاسم جمالها جنود العم سام في الأحلام حتى الموت.
فإذا ما انتهت الحرب أصبحت “جيلدا” و”سالومي” و”كارمن” وزوجة عبقري السينما أورسون ويلز وفوق كل هذا أول أميرة شرقية في تاريخ هوليوود بزواجها من “علي خان” ريتا هذه تصاب فجأة بمرض عضال يفقدها الذاكرة نهائياً، فتعيش لا تعرف حتى اسمها عالة على ابنتها “ياسمين” حفيدة زعيم الطائفة الإسماعيلية “أغا خان” حتى ينقذها الموت في السادس عشر من مايو الماضي، وهي في الثامنة والستين من عمرها الحافل بالعجائب والغرائب.
وبعد اختفائها بأيام، وافت المنية “فريد أستير” في الثامنة والثمانين، وقد راقصها في فيلمي “لن تصبح غنياً أبداً” و”ما أجملك” وهي في قمة المجد والصعود. و”أستير” لا ينافسه في نشر المتعة الفنية صافية نقية بين أكبر عدد من الناس سوى شارلي شابلن.
فكما”شابلن” استطاع “أستير” أن يزيل الحواجز بين ما يعتبر فناً شعبياً وما يسمى فناً رفيعاً.
العبقرية عمل
وفي الحق يعتبر أستير أحد العمالقة القلائل في فن الرقص وعنه قال “جورج بالانشين” مصمم الباليه المشهور إنه أعظم راقص على مر العصور، بل ذهب في التعظيم من شأنه إلى حد مقارنته بالموسيقار “باخ” في مجال القدرة على التركيز. وغني عن البيان أن “أستير” لم يصل إلى ما وصل إليه من مستوى في الرقص يوهم المشاهد برشاقة تلقائية دون عناء إلا بفضل عمل متواصل ليل نهار لأيام وأسابيع وشهور.
وفي هذا الخصوص يقال أن “جنجر روجرز” التي راقصها في عشرة أفلام على امتداد ستة عشر عاماً- وهي تعتبر الإنجاز المحوري للفيلم الموسيقي الأمريكي- يقال إنه أدمى قدميها من عناء مراقصتها في “لن أرقص أبداً” من فيلم “زمن السوينج”.. لماذا؟ لأنه استلزم تصوير هذا المشهد أربعين مرة طلباً للكمال!!
وقبل اختفاء”أستير” بأيام، بل قل ساعات معدودات فاجأنا الموت باختطاف حياة واحدة من أعظم ممثلات المسرح والسينما في الولايات المتحدة “جيرالدين بيج”، اختطفها وهي في الثانية والستين.
ولعل أهم ما يميز سيرتها السينمائية هو أن ظهورها على الشاشة كان متقطعاً، لأنها لم تكن في عرف هوليوود نجمة إغراء، فضلاً عن أنها كانت مدققة في اختيار الأدوار.
وقد يبدو أمراً مثيراً للدهشة، أنها ورغم تتويجها بجائزة أوسكار أحسن ممثلة رئيسية عن دورها في فيلم “رحلة إلى الرخاء” (1986)، فلم يسمع بها وبأفلامها إلا نفر قليل من نقاد وعشاق الفن السابع في ربوع الوطن العربي الفسيح.
ولكن الدهشة سرعان ما تزول إذا ما تذكرنا أن العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة، لاسيما في مجال السينما .
والآن، بعد هذا الحديث الطويل عن الأحياء والأموات، وبعد أن احترت في تيه الأحداث كثيراً، اخترت أخيراً أن أقف قليلاً عند مناسبتين هامتين هما يوبيل “بارامونت” الماسي ويوبيل “جيمس بوند” الفضي.
“إمبراطورية زوكور”
في يوم السابع من يناير عام 1973 اجتمعت هوليوود بكل ما تبقى لها من نجوم في صالونات فندق “بيفرلي هيلز” حيث احتفلوا بذكرى غريبة لم يألفها أحد من قبل في كعبة السينما المطلة على الهادي.
فما هي هذه الذكرى الفريدة التي احتشدت احتفالاً بها النجوم.. كل النجوم؟
إنها ذكري بلوغ أحد رواد صناعة السينما الأوائل وآخر الأحياء منهم، بلوغه المائة.
فمن هو ذلك الأب الروحي ذو القرن من عمر الزمن؟
إنه “ادولف زوكور” الذي ولد قبل تاريخ الاحتفال به في بيفرلي هيلتون بمائه عام من أسرة يهودية بريشي من أعمال المجر.
 فلما بلغ السادسة عشرة، هاجر إلى العالم الجديد حيث بدأ جهاده سمساراً ناجحاً في تجارة الفراء بشيكاغو، ومنها انتقل إلى تجارة أكثر انتشاراً وتأثيراً.. السينما فإذا بالحظ يبتسم، فيجعل منه مؤسساً لشركة “بارامونت”، وواحدا من بناة إمبراطورية صناعة الأحلام المخططين لإنتاجها، الراسمين لمسارها على مدى أربعة وستين عاماً.
فلما بلغ السادسة عشرة، هاجر إلى العالم الجديد حيث بدأ جهاده سمساراً ناجحاً في تجارة الفراء بشيكاغو، ومنها انتقل إلى تجارة أكثر انتشاراً وتأثيراً.. السينما فإذا بالحظ يبتسم، فيجعل منه مؤسساً لشركة “بارامونت”، وواحدا من بناة إمبراطورية صناعة الأحلام المخططين لإنتاجها، الراسمين لمسارها على مدى أربعة وستين عاماً.
حكماء هوليود
ومما يثير الدهشة أن ما حدث “لبارامونت” هو بعينه ما حدث لجل إن لم يكن كل شركات هوليوود الأخرى، بحيث تكاد تتفق سيرتها جميعا في أمر واحد.. هو أن يهودياً هاجر وحده أو مع أسرته من وسط أوروبا أو شرقها إلى الدنيا الجديدة حيث اقتحم حقل السينما، ليكتب له نجاح يتوج بإنشاء شركة سينمائية، سرعان ما تتحول إلى واحدة من أمهات الاحتكارات.
فشاموئيل جولدوين الذي ساهم في تأسيس كل من شركتي “مترو جولدين ماير” و”الفنانين المتحدين” هاجر إلى الولايات المتحدة من وارسو عاصمة بولندا.
“ولويس ماير” الذي ساهم في إنشاء الشركة الأولى، وظل مديراً عاماً لها، متحكماً في مصيرها زهاء ثلاثين عاماً، لم يولد في العالم الجديد، وإنما بعيداً في أقصى الشرق من أوروبا، وبالتحديد في مدينة منسك من أعمال روسيا البيضاء.
“ووليم فوكس” صاحب شركة “فوكس فيلم” التي جرى تحويلها فيما بعد إلى فوكس للقرن العشرين هو الآخر قد ولد بعيداً بمدينة “تولكفا” من أعمال المجر.
و”كارل لأمل” الذي أنشأ شركة “يونيفرسال” صاحبة أوسع استديوهات على وجه البسيطة، كان مسقط رأسه مدينة “لوفيم” بألمانيا، ومنها هاجر– وفي جيبه خمسون دولاراً- إلى الولايات المتحدة حيث عمل عند ترزي في شيكاغو، قبل أن يسعى به قدره إلى السينما.
والإخوة “وارنر” ولد أكبرهم “هاري وارنر” في مكان ما ببولندا. ومع والديه وصل إلى ميناء “بليتمور” بالولايات المتحدة، ولما يبلغ من العمر الستة أعوام.
وبالاشتراك مع أشقائه– سام، البرت، جاك– والثلاثة ولدوا بعد الهجرة، قام بشراء بعض دور العرض. ثم ما لبثوا أن أنشأوا شركة إخوان وارنر التي كان لها فضل الانتقال بالسينما من الصمت إلى الكلام المباح (6 أكتوبر عام 1927).
ومما يؤكد هذه الظاهرة مقال الناقد “شارلز فورد” بمناسبة عيد “زوكور” المئوي الذي اعتبر عيداً للسينما، جاء في ختامه “وهكذا.. وبفضل فئة قليلة من (صغار تجار الفراء والترزية من اليهود)- يقصد أصحاب الأسماء المتقدم ذكرها– أتوا من أوروبا الوسطى تم بناء صرح صناعة من أقوى صناعات الولايات المتحدة”.
والأكيد– بعد كل ذلك – أن ظاهرة “بارامونت” ورجلها المعمر الذي وهن العظم منه ليست استثناء من قاعدة.. بل هي القاعدة.
الفك المفترس
ومن المعروف عن “زوكور” عجوز “بارامونت” أنه صاحب عبارة “الجمهور لا يخطئ أبداً”– وهي المرادف لعبارة “الجمهور عاوز كده” عندنا– تلك العبارة التي اتخذت منها هوليوود شعاراً لأفلامها التي غزت بها الجيوب والقلوب.
وأنه مبتكر نظام النجوم ترصع بها سماء عاصمة الأطياف، فإذا بها تتحول إلى سديم بدايته “ماري بيكفورد” فتاة بريئة، معبودة الجماهير، ونهايته “مارلون براندو” أب روحي، عدو للناس أجمعين.
وهم إذ يحتفلون الآن بالعيد الماسي لشركته العملاقة، فإنهم يذكرون محاسنها.. كيف صمدت لأعاصير التغيير، وكما “حوت يونس” أو “الفك المفترس” كيف اتسع جوفها فابتلع الشقيقات الثلاثة “يونيفرسال” و”متروجولدين ماير” و”الفنانين المتحدين”.
وكيف فتحت السوق الصينية مرة أخرى بفيلمها “قصة حب”(17/3/1987) الذي يعتبر أول فيلم أمريكي يعرض في الصين الشعبية منذ عام 1949.
وعلي كل، فمن بين محاسنها التي لا شك فيها البحث الدءوب عن كل وجه جديد موهوب، وعند العثور عليه الإسراع بالتصعيد له إلى أعلى عليين.
ومن بين مساوئها التي لا ريب فيها اختيارها لقصة خروج بني إسرائيل من مصر هرباً من ظلم الفراعين، كي تنتجها مرتين تحت اسم “الوصايا العشر”.
المرة الأولى صامتة بلا ألوان عام 1923، أي عقب وعد بلفور، وفي فترة قل فيها الإقبال على الهجرة إلى أرض الميعاد.
والمرة الثانية متكملة على شاشة عريضة ملونة عام 1956 وفي أيام استشرت فيها موجة هجرة أبناء الشعب المختار إلى فلسطين!
وكلا الفيلمين كان صاحبهما “سيسيل ب دي ميل” شيخ المخرجين.
وفي كلا المرتين لم يكن له من هم سوى أن يتناول قصة موسي وبني إسرائيل أثناء وجودهم على أرض مصر ثم أثناء الخروج منها على وجه مشوه يراد به باطل هو تصوير بني إسرائيل وكأنهم أبناء شعب اختاره الله، وتصوير أهل مصر وكأنهم أبناء شعب نبذه الله، فكتب عليه ذل العيش في أغلال العبودية لفرعون وقومه الظالمين.
الشوق والحنين
فإذا ما انتقلنا إلى “جيمس بوند” ويوبيلة، فسنجد أنفسنا أمام شخصية لها من العمر على الشاشات الفضية خمسة وعشرون عاماً، هو عمر في عرف الزمن السينمائي طويل.
و”ايان فلمنج” الروائي الإنجليزي هو صاحب فكرة “جيمس بوند”.
وأول قصصه التي تحكي بطولات العميل الشهير، هي “الكازينو الملكي” (1953)، أما آخرها فقصة “الرجل ذو المسدس الذهبي” (1965).
وهذان التاريخان لهما مغزى كبير، ففي عام القصة الأولى جرت احتفالات تتويج الملكة “اليزابيث” على وجه قُصد به أن يعاد التأكيد على أمجاد الإمبراطورية التي كان يتغنى بأن الشمس لا تغرب عنها أبداً.
وفي عام القصة الأخيرة حمل جثمان “ونستون تشرشل” رئيس وزراء بريطانيا العظمى في عصر مدو بطبول الانتصارات، حمل إلى مثواه الأبدي في جناز مهيب اعتبر بمثابة لحن الوداع لعصر مفعم بالغنى والمتاع، وبكل ما يثير الزهو.
وطبعا كان لجيمس بوند دور في هذا العصر المشوب بالشوق والحنين، المفعم بالأسى وجلال الذكريات.
فهو باعتباره ضابطاً مرموقاً في المخابرات البريطانية، وبالتحديد فرعها المختص بشئون الحرب والدمار.
وهو بفضل مغامراته الشائقة وانتصارته المبهرة التي تشعل الخيال.
وهو بما عرف عنه من أنه لا يتحرك إلا محتضناً أمراة حسناء، وأمامه قارورة مليئة بشراب الشمبانيا الشهي، وفي متناول يده بندقية مشحونة تحمل للأعداء صنوفاً من الشقاء والبلاء، ومن حوله تحميه ترسانة أسلحة أبدعها عقل مدبر شيطان.
هو بحكم ذلك كله كان تعويضاً خيالياً للفجيعة الكبرى التي غصت حلوق، وحرقت أكباد الإنجليز لخذلان التاريخ لهم على وجه كان من آثاره فقدان الفتوحات التي أرست قواعد امبراطورية سادت اليابس والماء مئات الأعوام.
ومن هنا نجاح هذا المسخ المعبود “جيمس بوند” حتي أن المباع من رواياته في بريطانيا وحدها قد ارتفع من نصف مليون نسخة عام 1957 إلى 000ر790ر22 فيما بين عامي 1962 و1967.
سر البقاء
والأكيد.. الأكيد أن السينما قد لعبت دوراً حاسماً في تحقق هذا النجاح المنقطع النظير.
فما أن ظهر “بوند” على الشاشة بدءا بفيلم “الدكتور نو” (1962) حتى تعلق به الجمهور، وأصبحت له منزلة مذهلة في قلوب الجميع صغاراً كانوا أم كباراً.
وتفسيراً لذلك يقول الناقد الإنجليزي “جون راسيل تايلور” في دراسة له منشورة في المجلد الخامس من موسوعة السينما (ص103 – دار أوربيس – لندن) أن “الدكتور نو” وما جاء بعده من أفلام مثلها “شين كونري” وهي “من روسيا مع حبي”، “جولد فنجر” (1964)، “الرعد الصاعق” (1965) ، “أنت لا تعيش سوى مرتين” (1967) و”الماس إلى الأبد” (1971)– هذه الأفلام قد اتسمت جميعاً بامتزاج روح الدعابة الساخرة بألاعيب المخترعات غير المألوفة، يتزاوج الجنس المسرف بالعنف غير المعهود.
والشيء المحقق أن حسن اختيار شاب مغمور منحدر من أصل اسكتلندي اسمه “شين كونري” لتقمص شخصية “بوند” قد لعب دوراً كبيراً في نجاح الموجة الأولي من الأفلام المستوحاة من روايات “فلمج”، فلولا سحر حضوره، ولولا إعجاز توحده في تلك الشخصية لما تحول العميل “بوند” الذي لا يهزم أبداً إلى بطل أسطوري، ولما ظفر بهذا الكثير من التوفيق.
وفوق هذا فإن الشخصيات الرئيسية في هذه الأفلام الأولى قد رُسمت على وجه روعي أن يتحقق معه الإرضاء للرجال والنساء على حد سواء.
ففتيات “جميس بوند” مستقلات، متحررات، يخرجن من البحر كما الحوريات، ليس لأجسادهن من ساتر سوى رداء في حجم ورقة التوت إن لم يكن أصغر قليلاً.
يلاحظ هنا أن أحداً لا يتذكر من “الدكتور نو” سوى مشهد “اورسولا اندرسن” في لباس بيكيني أبيض، خارجة من البحر منتصبة كما عروس البحر “فينوس”.
ومع ذلك فالأمر ينتهي بهن في معركتهن مع “بوند” إلى الخضوع والاستسلام التام.
قوة العمر
ومهما يكن من شيء فمع مرور الأيام والأعوام، ومع اعتزال “كونري” تمثيل الدور ليحل محله “روجر مور” الذي استقر في دور “بوند” حتى مشهد “حادثة قتل” (1985)- بدأ الشوق والحنين “لكونري” باعتباره “جميس بوند” الأصيل.
ومن هنا إغراؤه بحوالي خمسة ملايين دولار مقابل الموافقة على العودة عميلاً في خدمة صاحبة الجلالة في “أبداً لا تقل أبداً مرة أخرى”.
ومن عجب أنه قد غاب عن صانعيه من هيئة المنتفعين “ببوند” أن “كونري” عام1984 يقترب من الستين وبالتالي لم يعد صالحاً كما في سالف الزمان، لتقمص شخصية الفارس المغوار الذي لا يشق له غبار.
ورغم نجاح الفيلم في الشباك، كما العادة مع كل ما هو منتسب لاسم “بوند”، فقد فجع الجمهور في المعبود، إذ وجده عجوزاً متصابياً.
ومع هذا الإحباط، لم يكن ثمة مفر من استدعاء “مور” مرة سابعة ليمثل فيلم “بوند” الرابع عشر.
ومرة أخرى يكتشف الجمهور أن “بوند” الثاني “مور” قد اقترب بدوره من سن الإحالة إلى المعاش، ولا يرجى منه خير، فهو مقطوع النفس، مثقل بحمل الشيخوخة، لا يصلح للاستمرار في تقمص شخصية بطل الأبطال.
وأسقط في يد المنتفعين من الماركة المسجلة “بوند”. وثار السؤال.. ما العمل؟
البحث والتجلي
وكانت الإجابة بأنه لابد من العثور على شاب له حضور، ذو وجه وجيه وسيم، وشخصية جذابة يندمج فيها الرجال وتذوب في فحولتها النساء.
وشاءت لهم الأقدار أن يعثروا على ضالتهم المنشودة في شاب إنجليزي يتفجر حيوية، شاب صاعد في سماء المسرح والسينما اسمه “تيموني دالتون”.
وسرعان ما كلفوه بأداء دور “بوند” في رواية “فلمنج” المسماه “أضواء النهار الحية”.
وأحداث فيلم “بوند” الأخير أو بمعنى أصح مطارداته اللاهثة، إنما تجري بداية من تشيكوسلوفاكيا والمغرب وجبل طارق، ثم تنتقل بأبطاله إلى هضاب وسجون أفغانستان حيث يتضامن “بوند” مع المجاهدين ضد امبراطورية الشر!!
وبغض النظر عن العبث الذي يقوله فيلم “بوند” الخامس عشر، فهل سيكون في استطاعة بوند الجديد “دالتون” أن يُكمل مشوار “كونري” و”مور” حتى نهاية القرن العشرين أم أنه سيسقط في أول اختبار، لن يكون عميلاً أعظم إلا مرة واحدة؟
عن هذا السؤال يجيب كتاب الدعاية “جيمس بوند الرسمي” (1987) بنعم متفائلاً ولكن منذ متى يؤخذ تفاؤل المتربحين مأخذ الجد؟