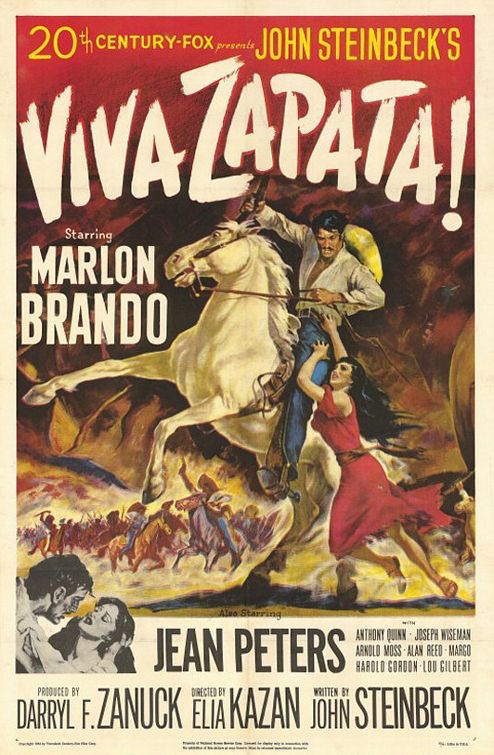قبل مائة عام، انطلقت «تايتانيك» من ميناء «سوثهمبتون» بانجلترا صوب نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية في أول رحلة لها، وقتها لم يكن ليرد علي البال، أن هذه السفينة العملاقة التي أطلق عليها أصحابها من باب الزهو والتفاخر أنها أضخم كتلة عائمة من صنع الإنسان وغير قابلة للغرق.
ستصطدم بعد بضعة أيام من إبحارها بجبل جليدي عائم، ولن تمض سوي ساعتين علي اصطدامها إلا وتكون حطاما راقدا في قاع المحيط، وركابها وبحارتها يصارعون الموت غرقا،أو تجمدا من انخفاض درجة الحرارة الي ما دون الصفر بكثير.

وعن هذه الكارثة الكبري في تاريخ الملاحة البحرية أبدع «چيمس كاميرون» المخرج الكندي ، ذائع الصيت قبل خمسة عشر عاما، فيلما تحت اسم «تايتانيك»، من نوع الإنتاج الضخم يمتد عرضه زهاء 194 دقيقة، وتجاوزت تكاليفه مائتي مليون دولار. وحقق حيثما عرض إيرادات مذهلة حتي جاوزت في مجموعها الألف مليون دولار.
وبفضل نجاحه علي هذا النحو أصبح من الأفلام العلامات في تاريخ السينما الأمريكية، مثله في ذلك مثل «ميلاد أمة» لصاحبه المخرج «داڤيد جريفيث» و«ذهب مع الريح» لصاحبه المخرج «ڤيكتور فلمنج». وكما فاز الفيلم الأخير بالعديد من جوائز الأوسكار، قبل سبعين عاما، أو يزيد فاز «تايتانيك» هو الآخر بالعديد منها، خاصة جائزتي أوسكار أفضل فيلم ومخرج «كاميرون» 1998 وسيناريو «تايتانيك» من تأليف مخرج الفيلم أي «كاميرون»، وهو سيناريو محكم البناء، يقوم علي خيطين أساسيين،أحدهما غرق السفينة بمن فيها ومن عليها، والآخر قصة حب بين فتي فقير من ركاب الدرجة الثالثة، «چاك» ويؤدي دوره «ليوناردو دي كابريو» وفتاة من الطبقة الراقية «روز» وتؤدي دورها «كيت وينسلت»، ويقف عقبة كأداء أمام حبهما أن «روز» مخطوبة لرجل واسع الثراء، يصطحبها إلي الولايات المتحدة، هي وأمها، حيث يتم الزفاف في فيلادلفيا وتتشابك قصة الكارثة مع قصة الحب، خاصة والسفينة تلفظ أنفاسها الأخيرة لتستقر في قاع المحيط، وقد أصبحت حطاما والمدهش في الفيلم أن مخرجه قد عني بالتفاصيل أشد عناية وكان متئدا، رزينا، لم يجنح الي الاستثارة أو التهريج، وبفضل تحريكه لهما صعد «دي كابريو» و«وينسلت» الي مصاف النجوم، ولم تمر سوي بضعة أعوام إلا وكانت «وينسلت» فائزة بجائزة أوسكار أفضل ممثلة رئيسية عن أدائها في فيلم «القارئ».
وبعد «تايتانيك» لم يخرج «كاميرون» سوي فيلم واحد «اڤاتار» الذي حقق بدوره إيرادات، فاقت كل التوقعات، كما فتح الباب للأفلام ثلاثية الأبعاد، وقد جري ترشيحه للعديد من جوائز أوسكار أذكر من بينها جائزتي أوسكار أفضل فيلم ومخرج، وكان المنافس الرئيسي لفيلمه «اڤاتار» فيلما لزوجته السابقة «كاترين بيجلو» اسمه «مخزن الأيلام»، ولدهشة الكثير خرجت هي وفيلمها من مضمار المنافسة، فائزتين بجائزتي أفضل فيلم ومخرج وكانت، بهذا الفوز أول مخرجة في تاريخ الأوسكار تتوج بجائزة أفضل مخرج.
يبقي لي أن أول إنه بمناسبة مئوية مأساة «تايتانيك»، عاد «كاميرون» بفيلمه عن تلك المأساة، ليعرضه في نسخة ثلاثية الأبعاد،وفي عرض خاص للفيلم في نسخته تلك، لاحظت أن رقابتنا الساهرة علي حمايتنا من أنفسنا حذفت من الفيلم مثلما فعلت قبل أربعة عشر عاما، مشهد رسم «چاك» لحبيبته «روز» وهي عارية، وعكس ذلك تماما، مكان موقف الرقابة في الهند.
فحسبما أذيع في وسائل الإعلام صححت الرقابة الهندية موقفها من ذلك المشهد، فلم تحذفه كما فعل من قبل، بل أبقت عليه، ليعرض الفيلم لأول مرة كاملا، لم يمسسه مقص الرقيب، ولعل رقابتنا، تتعظ فتكون علي شيء من الشجاعة، وتعيد إلي الفيلم ما حذف منه دون وجه حق!