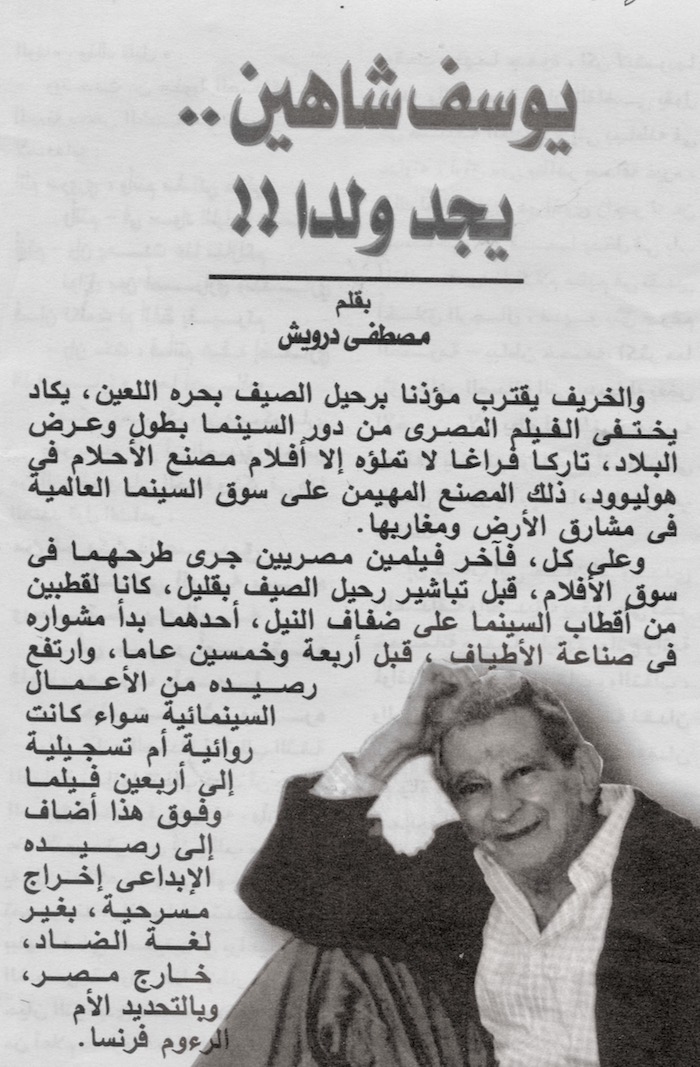شعرت بخيبة أمل شديدة و”حالة حب” أحد أفلام العيد يقترب من النهاية السعيدة، حيث يعود الابن الضال في فرنسا إلى حضن أمه وشقيقه الوحيد في مصر، بعد سنوات طوال من الفراق، وعذاب الاغتراب. وخيبة الأمل مرجعها عدة أسباب، لعل أهمها، أن الفيلم بدا لي من خلال متابعة مشاهده الأولى أن صاحبه المخرج “سعد هنداوي” يحاول في أول عمل له روائي طويل، أن يقول شيئاً جديداً ومفيداً فربما لأول مرة في تاريخ السينما المصرية يتعرض مخرج لمعاناة المصريين الذين تركوا أرض الآباء، بحثاً عن وسائل رزق في بلاد الغربة، خاصة فرنسا.
كيف أضاعوا العمر، بمغامرة مغادرة مصر، في وهم أنهم من يعيشون في بلد ترفرف عليه أعلام الحرية والمساواة والإخاء.
وكيف أنهم، بعد فاجعة تدمير البرجين التوأم في حي مانهاتن بنيويورك (11/9) وذلك قبل ثلاثة أعوام، قد فقدوا نهائياً الشعور بالأمن والأمان.
وهو، أي “هنداوي” في عرضه لمعاناة المصريين المغتربين، لم يطرح مسألة الهجرة إلى الخارج، من منطلق الترغيب في مغادرة مصر، جرياً وراء سراب النجاح، كما فعل المخرج الراحل “عاطف سالم” في فيلمه “النمر الأسود”، حيث لعب “أحمد زكي” دور مصري دفعه الفقر إلى الهجرة إلى ألمانيا. ورغم أنه لم يكن يعرف حرفاً واحداً من لغة الألمان صعد وارتقي، بفضل الإرادة، حتى وصل إلى أعلى عليين.
لم يفعل “هنداوي” ذلك بل على غير المعتاد، طرح مسألة الهجرة، من منطلق آخر، ألا وهو الحرص على توعية الشباب بمخاطر الاطمئنان إلى أن بلاد الغربة، أرض الميعاد، حيث النعيم المقيم.
ولكن، ولسوء الحظ خانه التوفيق، فلم يصل بفيلمه إلى ما كان يريد.. لماذا؟
لأنه مع الذي شاركه في كتابة سيناريو الفيلم “أحمد عبد الفتاح” أرادا أن يقولا الكثير، فتعثرا، حتى كادا ألا يقولا شيئاً.
كان لزاماً عليهما أن يركزا على محنة المصريين المغتربين، وألا يحيدا عن ذلك، تحت تأثير أي اغراء.
غير أن شيئاً من هذا لم يحدث. فكان أن أصبح الفيلم مثل دكان عطارة، فيه من كل صنف ولون.
إثارة وتشويق، حب وخيانة، رقص ومغنى، وأسرار.
فما أكثر العناصر التي ازدحمت بها قصة الفيلم.
وما أكثر التفريعات التي أخرجته عن سياقه الأصلي.
والمحصلة، نتيجة ذلك، اختلاط الحابل بالنابل، على نحو، ضاع معه الخيط الأساسي، في تيه الخيوط المتعددة، المتشابكة، التي جعلت متابعة أحداث الفيلم، أمراً صعب المنال.
وكان لا مناص، مع تعدد الخيوط وتشابكها على نحو فيه من الهرجلة الشيء الكثير، أن يحيط الغموض ببعض الأحداث، وأن يسود بعضها الآخر الافتعال.
فعلى سبيل المثال، اقتسام الولدين أحدهما “هاني سلامة” يسافر وهو صغير مع أبيه “محمد سعد” إلى المهجر في باريس، والآخر “تامر حسنى” يبقى مع أمه “مها أبوعوف” في مصر، ذلك الاقتسام الغريب، وكأن الولدين تركة تورث، يظل أمراً مجهولاً بالنسبة لنا، نحن المتفرجين، لا نتبين كيف حدث، ولماذا، إلا بعد جهد جهيد.
هذا عن الغموض، أما الافتعال، فاذكر منه على سبيل المثال، تفريعة الفتاة الأمريكية “دنيا” التي تغري المراهق “شريف رمزي” وغيره من شباب مصر المحروسة، على تعاطي المخدرات وبيع حبوبها، فضلاً عن ممارسة الفحشاء.
ويشتد الافتعال، ويتصاعد، بضبط الحبوب المخدرة في حيازة “رمزي” وهروبه مطارداً من رجال الشرطة، وصديق عمره “تامر” الذي يضبطه مختفياً، ملتحياً، بأحد المساجد في الريف!!
ومن الأمثلة الأخرى على الافتعال، وهو مثل صارخ بكل المعايير، التقاء الشقيقين “هاني” و”تامر” لأول مرة، منذ أن افترقا، وهما صغار، فاللقاء يتم بينهما صدفة ودون أن يعرف أي منهما أن الآخر شقيقه.
ولأمر ما، لعله حنين الدم، يذهب كلاهما إلى الشرفة، حيث يتعانقان، وعيونهما مغرورقة بالدموع، دموع لقاء الأشقاء، بعد فراق طويل. كل ذلك، دون سابق معرفة أو تقديم.
وعلينا أن نصدق هذا الهراء، وغيره كثير مثل قيام “هاني” بتصوير أولاد الشوارع لحساب إحدى الفضائيات الفرنسية، والقبض عليه متلبساً بالتصوير، ثم الإفراج عنه، وكأن شيئاً لم يحدث.
ومثل صمود “تامر” أمام إغراء ممولي أشرطة التسجيل الذين أرادوا له أن يسير في طريق الأغاني المبتذلة التي تحقق ربحاً سريعاً، وصعودا إلى النجومية في عالم الطرب والغناء.
وعلى كل، فهذا كله، لم يمنع أن “هاني” أدى دوره باتقان. وأن “تامر” كان في مستوى طيب، يؤهله لمواصلة المشوار. كما أنه لم يحل بين “هنداوي” وبين أن يثبت جدارته كمخرج صاعد واعد، بحكم درايته بقواعد لغة السينما، وهو أمر نادر، في هذه الأيام التي يغلب فيها الاستسهال والابتذال.
وختاماً، يبقى لي أن أقول أن النهاية السعيدة التي جرى اختيارها “لحالة حب” جاءت مخالفة لمنطق الفن والحياة معاً.
فكل قصة ليس ضرورياً أن تنتهي نهاية سعيدة، بل قد تكون النهاية الحزينة أكثر تأثيراً في النفس، لما يرسب بعدها من أحزان، وليدة ثقل المأساة في قلب الانسان. واختيار نهاية سعيدة لقصة مغتربي “حالة حب” يعد والحق يقال نوعاً من التلفيق، لا ينسجم مع المسار الفاجع للأحداث. وأرجح الظن أن أصحاب الفيلم لم يجنحوا إلى النهاية السعيدة، وهي أبسط الحيل السينمائية، إلا لكسب رضاء الجمهور، ومع ذلك، فلم يصادفهم التوفيق!!