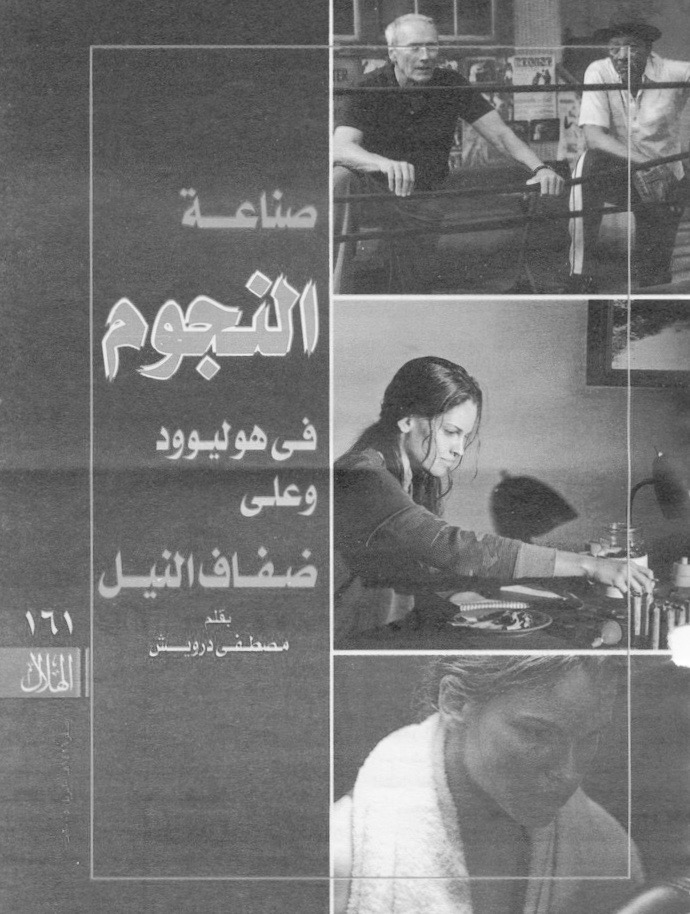ما أكثر الغرائب والعجائب في تاريخ السينما المصرية، لاسيما ما كان من أفلامها متصلاً بالمأساة الفلسطينية، وهي أقل من القليل.
فخلال عمر هذه المأساة، لم تفلح أقدم وأقوى سينما متكملة بلغة الضاد، في انتاج فيلم روائي طويل يعرض بالتزام وجدية لمأساة الشعب الفلسطيني على أرض وطنه السليب، أو خارجها في الشتات.
ومرت الأيام منذ قرار التقسيم، أعواماً بعد أعوام، وصانعو الأفلام عندنا، على حالهم، غير ملتزمين بالجدية اللازمة في مثل هذه الأحوال.
داء الاستسهال
وعلى كُلٍ، فالحال استمر على هذا المنوال القائم على الاستسهال، إلى أن جاءتنا من وراء المحيط مجلة التايم الامريكية بخبر مفاده أن ناقدها السينمائي المرموق اختار، من بين أفضل عشرة أفلام شاهدها خلال العام الماضي، فيلم “باب الشمس” لصاحبه المخرج المصري “يسري نصر الله”.
ولقد تصادف مجئ الخبر، والعيد الكبير على الأبواب وطبعاً، توقعت للفيلم المختار، وأحداثه تدور حول المأساة الفلسطينية وجوداً وعدماً، توقعت له، وقد أعلن عن عرضه بمناسبة العيد السعيد، أن تكون أفسحت له عشرات دور السينما، بطول وعرض البلاد، أسوة بأفلام العيد الأخرى، مثل “أبو علي” و “الباحثات عن الحرية”، ولكن شيئاً من ذلك لم يحدث، إذ اقتصر عرضه على ثلاث دور سينما في القاهرة والاسكندرية.
سوء المصير
وكأنه أريد بذلك أن يكون عرضه في أضيق الحدود.
أما لماذا أريد له ذلك المصير، فذلك علمه عند ربي، ربما إلى يوم الدين.
كل ما أعلمه على وجه اليقين، أن طول الفيلم (خمس ساعات إلا قليلاً) وتقسيمه إلى جزئين يعرض كل واحد منها بمفرده، قد لعبت دوراً كبيراً في قلة الاقبال على مشاهدته، عكس ما كان متوقعاً.
والآن، إلى موضوع “باب الشمس” لأقول أنه مستوحى من رواية بنفس اسم الفيلم صاحبها “الياس خوري” الأديب اللبناني الشهير.
واللافت للنظر مشاركت كل من المخرج وآخر “محمد سويد” في كتابة سيناريو الفيلم، الذي أعطيت له امكانيات هائلة، واشترك في تمثيله حشود كبيرة من الناس العاديين.
ملحمة الخروج
ولقد تبدت براعة صاحب الفيلم، في تصوير المجموعات، مثل مشاهد طرد الفلسطينيين من ديارهم ودفعهم قسراً إلى مغادرة أرض الآباء إلى الشتات، بداية في لبنان.
ومن مزايا الفيلم الأخرى، وهي كثيرة، جنوح صاحبه إلى عدم الاستعانة – على الأقل في الجزء الأول بممثلين مصريين. فبفضل ذلك، تحررت ملحمته من نظام النجوم.
ومن آثار ذلك، كان الممثلون الذين أدوا الأدوار الرئيسية مقنعين إلى حد كبير.
أولاً: لأنهم كانوا يتكلمون بلهجة أهل البلدين، حيث كانت تدور الأحداث، وهما فلسطين ولبنان.
وثانياً: لأنهم جعلوا من أدوارهم التي رسمت بعناية فائقة، شيئاً جديداً، منبت الصلة بعالم التمثيل عندنا.
وليس ثمة شك في أن الفضل في ذلك أنما يرجع إلى تحريك المخرج لهم، واهتمامه في هذا المجال، بأدق التفاصيل.
وأحداث الملحمة ترجع إلى ما قبل قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة الصادر يوم التاسع والعشرين من نوفمبر لعام 1947 بتقسيم فلسطين إلى دولتين، إحداهما عربية والأخرى يهودية.
ولكن صاحب الملحمة آثر أن يبدأ سردها من عام اتفاقية أوسلو بالنرويج، ذلك العام الذي وقف فيه “ياسر عرفات” و”اسحاق رابين” قبل أحد عشر عاماً، أمام مبنى البيت الأبيض بواشنطن، حيث تصافحا ولأمر ما ساد التفاؤل.
بداية النهاية
ورغم ذلك، فأنهم بمعسكر “شاتيلا” للاجئين ببيروت، كانوا، بالعكس متشككين، بل قل متشائمين.
وفي هذا الجو المشحون بالتوتر وعدم الثقة، إلى درجة التخوين، تطلق مناضلة شابة الرصاص على أحد المناضلين في ذلك المعسكر، فترديه قتيلاً.
وما هي إلا ثوان، حتى نشاهد أحد المناضلين القدامى، وهو يسقط صريع شلل كلي أقعده عن الحركة، وأفقده القدرة على الكلام.
وفي محاولة من ابنه الروحي وأحد أبناء الثورة، لإنقاذه من براثن الموت، يحكي له سيرته بدءًا من أيام مقاومته الاحتلال البريطاني، قبل خمسين عاماً، وقت أن كان في مقتبل الشباب، يعيش في إحدى قرى الجليل، مع أبيه الشيخ الضرير، الذي قام بتزويجه دون رضاء أمه، من صبية، لم يرها إلا يوم الزفاف.
وفيما هو منهمك في مقاومة الاحتلال، دمر ما كان يسمى وقتها بجيش الدفاع اليهودي، قريته، مما أجبر سكانها، بمن فيهم عائلته على النزوح إلى التلال المجاورة.
ومن خلال تتبع أمثلة فردية عن بطولة المناضلين، قدّم لنا صاحب الملحمة لوحة درامية كاملة، ورائعة لبطولة مقاومة الفلسطينيين، وهي مقاومة تقاسم بطولاتها مع الرجال، نساء وشيوخ وأطفال.
يبقى لي أن أقول، أنه مما يحسب “لباب الشمس” أنه عكس معظم الأفلام السابقة عليه، لم ينحدر بالمحنة الفلسطينية، من منزلة المأساة إلى ميلودراما صارخة، لا تقول شيئاً، فلا تقنع أحداً.
إنه والحق يقال، قال لنا الكثير وأقنعنا إلى حدٍ كبير!!