“في الحب” كتاب ألفه الأديب الفرنسي “ستندال” منذ مائة وخمسة وستين عاماً أو يزيد، وقال على صفحاته ضمن ما قال إن هناك أنواعاً أربعة من الحب أولها الحب الجامح الذي يملك على النفس أهواءها وعواطفها وحسّها وشعورها، والذي يندفع كالسيل لا يلوي على شيء، ولا يترك حظاً من أناة أو رويّة أو تفكير.
فهل ثمة وجود لهذا الحب الذي تفنى فيه النفس فيما نرى من أفلام عربية، وبخاصة ما كان منها مصنوعاً على أرض مصر؟
أجاب عن هذا السؤال المخرج “عمر أميرآلاي” (سوريا) بفيلمه التسجيلي “تابوت الحب” أو في تسميته العربية “الحب الموءود”.. وكانت إجابته بلا.
وقد اعتمد للوصول إلى هذه النتيجة على عدد غير قليل من نماذج لنساء ورجال، اختارها بعناية من بين أناس، البعض منهم كتبت له شهرة واسعة، والبعض الآخر لم يكتب له منها شيء.
كما اعتمد على قطع باتر، وتوليف ماكر بين المشاهد التي ظهر فيها من وقع عليهم الاختيار.
وهو في فيلمه يبدأ– وقبل ظهور العناوين– بفرح في سرادق.. عروس وعريس يرتديان ثياب الزفاف البيضاء، مطربة تتلوى وهي تغني “يا قمر”، منادي يصيح بأحلى السلام للضيوف الكرام.
وصوت من خارج إطار الفيلم يقول أن البيت هو الاستقرار والراحة الكاملة، وأن المرأة اليابانية تمثل المرأة كما أنزلت، أما المرأة المصرية فمتخلفة “خالص”، لأن الإنسان المصري يحمل في أعماقه تخلفاً دام أربعة آلاف عام.
وبعد انتهاء هذا الكلام، تبدأ عناوين الفيلم التي ما تكاد تنتهي، حتى تظهر امرأة مثقفة تقدمت بها السن قليلاً، قليلاً حتى بلغت الأربعين دون أن تورط نفسها في زواج.. لماذا؟
لأن شخصيتها قوية، والرجال في مصر لا يشغفهم حب النساء الجريئات، المقدامات.
حديث الجوزة
وفجأة نلتقي بشاب مضت به الأيام حتى أصبحت خمسة وثلاثين عاماً. ولقد فاته القطار، فلم يستطع الزواج حتى الآن. وها هو ذا يتعاطى الحشيش متصاعداً دخانه من جوزة، وها هو ذا مثقل بقيود التقاليد والعادات، مقصوص الجناح، ليس في وسعه أن يمارس الحب، أن يبادل من يحب هياماً بهيام. فإذا ما انتهى حديث هذا الشاب الضائع في الأوهام خرج بنا صاحب الفيلم إلى شوارع القاهرة، كي يطوف بنا من حي الموسكي الشعبي إلى فوضي ميدان رمسيس المعروف بباب الحديد، وأخيراً إلى عمارة غير شعبية تطل على النيل شاهقة، شامخة، ليصعد بنا من داخلها إلى نجمة الجماهير “نادية الجندي”.
 وها هي “الفنانة التي حققت جزءاً من ذاتها، ولايزال أمامها طريق طويلة لتحقيق أحلامها” ها هي تتحدث عن الإغراء وماهيته شارحة بعينيها وبشفتيها ثم بفخذيها ما لم تستطع شرحه بالكلمات “مفهومي للإغراء يختلف تماماً.. مش لازم الإغراء إني أعري رجلي، ممكن عمل الإغراء بنظرة تدي تأثير أكثر من لو لبست مثلاً مايوه.
وها هي “الفنانة التي حققت جزءاً من ذاتها، ولايزال أمامها طريق طويلة لتحقيق أحلامها” ها هي تتحدث عن الإغراء وماهيته شارحة بعينيها وبشفتيها ثم بفخذيها ما لم تستطع شرحه بالكلمات “مفهومي للإغراء يختلف تماماً.. مش لازم الإغراء إني أعري رجلي، ممكن عمل الإغراء بنظرة تدي تأثير أكثر من لو لبست مثلاً مايوه.
ممكن أعمل منظر بشفايفي يبقى يوحي بأنوثة أكثر وأخطر من لو لبست فستان مفتوح.
مفهومي للأنوثة يختلف تماماً عن مفهوم الأنوثة في السينما الأمريكية، يعجب كافة الأذواق والطبقات”.
جبروت خادمة
وما إن انتهت النجمة “الأعظم” من هذا العرض لوسائلها في الإغراء المحتشم– وفيما هي تتحدث عن فيلمها “الخادمة” وموضوعه الذي “يمس البيئة المصرية” لأن بطلته خادمة تسلقت، فسيطرت على مصائر أسرة ثرية من خلال إغراء ولدها الوحيد، والتحريض له بالتمرد على أمه سيدة الأعمال، مما مهد لها طريق الاستيلاء على بيت العائلة وشركتها وحُلي الأم، وغير ذلك من عزيز الأشياء- فيما هي منهمكة في هذا الحديث عن خادمتها أو شيطانتها– تركتها الكاميرا منتقلة بنا خلسة إلى خادمة حقيقية شقية ( أم حماد) نراها صاعدة، وهي تحمل ابنها درجات سلم عمارة سكنية- ومعها صوت ملكة أو خادمة الإغراء مصاحباً– إلى حيث تسكن أسرة من تلك الأسر التي تنتسب إلى الشرائح العليا من الطبقة المتوسطة.
وهنا نكتشف بعيداً عن خيالات وخادمات السينما– أن “أم حماد” قد عقد قرانها على رجل مسن وهي صبية، بل قل طفلة لم تتهيأ بعد للزواج لا جسدياً، ولا نفسياً، وبالتالي لم تكن تعرف من أسرار الرباط المقدس شيئاً.
وأن حياتها كانت جحيماً ذاقت فيه مرارة الحرمان من القروش القليلة التي كانت تكسبها بكدها وكدحها؛ فقد كان زوجها، بل– قل– أبوها، دائم الاستيلاء عليها ليصرفها على هواه.
فإذا ما ثابت إلى الرشد والحريه والتمست الطلاق، عذبها في المحاكم، لم يرد إليها حريتها إلا بعد أن حصل منها على تنازل عن كل مستحق لها.
على أنها– بعد الطلاق– لم تلبث أن تزوجت مرة ثانية.. لماذا؟
خوفاً من كلام الناس. وفي بعض حديثها عن زيجتها الثانية قالت ما مفاده أنه لا فائدة، وأنها لن تنعم بحياة هادئة سواء أكانت داخل جنة الزواج أم خارجها.
الفن والإيمان
وبعد هذه الكلمات التي تقطر بؤساً ويأساً تعود بنا الكاميرا إلى ملكة الإغراء أو خادمة السينما بين فساتينها الفاخرة لنسمعها تقول أن “الفن فيه كثيرمن الأنانية.. عشان أوصل للنجاح لازم اتنازل عن نادية الجندي كامرأة لأحتفظ بنادية الجندي الفنانة”.
ومع لقطة من فيلمها “وكالة البلح” في أحضان “محمود ياسين” متعرياً من أعلى حتى خصره، مغرياً لها بالقبلات الحارة تواصل النجمة المعبودة حديثها قائلة “حياتي الخاصة بامارسها بطريقة تختلف تماماً.. يعني يمكن أن أقول لك، أني أكثر من متدينة، متطرفة في الدين”
فإذا ما قاطعها صاحب الفيلم متسائلاً “ألا يعتبر هذا انفصاماً في الشخصية؟”
ردت بالإيجاب دون تردد مؤكده كلماته “ده انفصام في الشخصية مائة في المائة.. بس أتعودت على كده”!!
وطبعاً لا تقتصر نماذج “الحب الموءود” على ما تقدم ثمة نماذج أخرى شقية وشائقة بثها “أميرألاي” في كل مشهد من مشاهد فيلمه.
الذبح العظيم
ومع ذلك فليس من المفيد الوقوف حالياً عند أي منها، فيما عدا نموذج مستثنى وحيد.. فما هو؟
قريباً من منتصف الفيلم – وبعد مشهد مع رب أسرة لم يتزوج عن حب، وإنما عن طريق أمه – فلما سئل عن شريكة حياته وحاله معها، أجاب بأنها كانت وديعة، مطيعة، إلا أنها مع مر الزمن أخذت في التمرد، حتى خيل إليه أنها غير صالحة، وأنه لم يبق له فيما لو خير بينها وبين أمه، إلا أن يذبحها هي وأولاده منها- بعد هذا المشهد الغريب حقاً- تتسلل بنا الكاميرا إلى صحن جامع حيث نرى فتى نقياً وسط دائرة من المصلين .
فإذا ما تكلم سمعناه يقول أن الضائقة الاقتصادية تحول دون إشباع الإشتهاء للأنثى بالطريق الحلال، وأن الشاب في هذه المحنة ليس أمامه من سبيل سوى الرحيل إلى الخارج لجمع المال اللازم للزواج أو الامتثال إلى الصبر والصوم الذي هو خير علاج للشهوة.
وما يكاد الفتى ينتهي من قولته الأخيرة “معك قرش تساوي قرشاً، ليس معك شيء لا تساوي شيئاً”! حتى تنطلق الكاميرا بنا إلى موكب مهيب لمشايخ وأتباع الطرق الصوفية– ومنه، وبفضل قطع سريع، إلى حلقات ذكر يشارك فيها فتيان بنشوة فوارة، جذوتها لا سبيل إلى إطفائها.
ثم تستأنف الكاميرا مسيرتها الاستطلاعية، حتى إذا ما اقتربت من نهاية المشوار؛ عادت إلى الشاب الضائع في دخان الأوهام، لنسمعه يقول، والجوزة لاتزال في قبضة يده، أنه غيور جداً، ولن يسمح لخطيبته بالعمل، وأنه سيعقد قرانه عليها بعد العيد الكبير.. لماذا؟
يجيب عن هذا السؤال بهذه الكلمات التي جرت على لسانه- وكانت آخر كلمات الفيلم– “اذبح واذبح، الخروف واذبح” تتبعها ضحكة فيها من الخداع والانخداع الشئ الكثير.
هذا هو حال الحب في الأصل والصورة حسب رؤية “عمر اميرالاي” في فيلمه “الحب الموءود”.
وعلى ما يبدو من معظم الأفلام العربية الهازل منها والجاد على حدٍ سواء، أن الحب فيها كما في “الحب الموءود” مختلف، أو ليس له وجود.
الرجولة.. أين؟
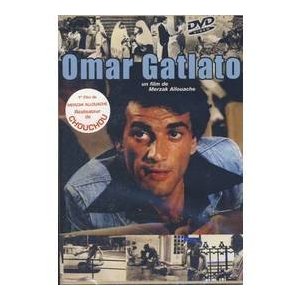 فالبطل في “عمر قتلته الرجولة” لصاحبه “مرزوق علواش” (الجزائر)- وهو أحد أفضل عشرة أفلام في تاريخ السينما العربية وفقاً لاستفتاء أجرته مجلة “اليوم السابع” في عدد 23 من فبراير سنة 1987- هذا البطل موظف صغير مقهور، يعيش على الهامش خارج الحياة كما يعيشها الناس، يحاول أن يملأها بنفر من الزملاء، كلهم وبلا استثناء من صنف الرجال.
فالبطل في “عمر قتلته الرجولة” لصاحبه “مرزوق علواش” (الجزائر)- وهو أحد أفضل عشرة أفلام في تاريخ السينما العربية وفقاً لاستفتاء أجرته مجلة “اليوم السابع” في عدد 23 من فبراير سنة 1987- هذا البطل موظف صغير مقهور، يعيش على الهامش خارج الحياة كما يعيشها الناس، يحاول أن يملأها بنفر من الزملاء، كلهم وبلا استثناء من صنف الرجال.
والغريب في أمره أن الصلة بينه وبين المجتمع منقطعة، وأنه يسعى إلى إعادتها فلا يجد سبيلاً إلى ذلك إلا في كرة القدم والسينما الهندية واقتناء جهاز تسجيل يعيش من خلاله مع الوهم مخدراً تارة بأغان هندية، وتارة أخرى بأغان شبه شعبية لعبد القادر الشاوي أحد مشاهير مطربي الجزائر.
وبينما هو في طريقه إلى منزله عبر حي القصبة، عائداً من عرس سجل فيه لهذا المطرب، إذا بعصابة تنقض عليه، تسلبه جهاز التسجيل. ولا تطول المأساة الصغيرة، فسرعان ما وفر له صديق مسجلاً جديداً بالتقسيط المريح. وفوق هذا أهداه شريطاً فارغاً.
وما يكاد يجرب الشريط، حتى يفاجأ بسماع صوت نسائي مسجل يتحدث في عذوبة ورقة عن آلام الوحدة ومرارة الفراق والحرمان .
فإذا ما استفسر من صديقه عن صاحبة هذا الصوت، وألح في الاستفسار حتي أخبره بأن اسمها “سلمى” وأعطاه رقم هاتفها في المصلحة التي تعمل بها، ويسرع “عمر” بالاتصال بها هاتفياً وأثناء الحديث معها، يعبر لها عن حبه لصوتها، ويتفق معها على موعد للالتقاء، حتى إذا ما حل الموعد، ورآها من بعيد تنتظره قريباً من مدخل المصلحة خانته شجاعته، فظل متسمراً في مكانه لا يتحرك، معلقاً بين اليأس والرجاء، وكأن ثمة قوة خفية تقطع كل سبب بينه وبين صاحبة الصوت الساحر، حتى انصرفت يائسة.
وغني عن البيان أن هذا التهرب من التعارف مع الجنس الآخر، إنما هو وليد العجز عن التجارب والمؤانسة، هذا العجز الذي نراه متجليا في شخصيات “وللحب قصة أخيرة” لصاحبه “رأفت الميهي” والذي يعتبر واحداً من أهم أفلام منتصف الثمانينيات.
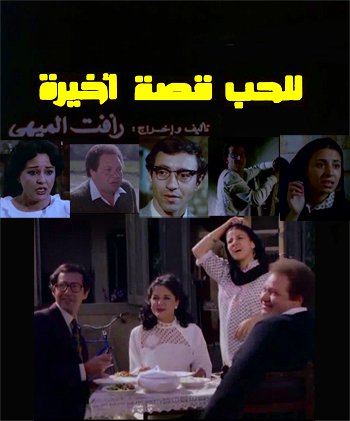 ففي جزيرة “الوراق” حيث تدور أحداث الفيلم يعيش الطبيب الشاب “حسين” (عبد العزيز مخيون) خاملاً، هاجراً زوجته وأولاده، لأنه أسير الوفاء لأم في غيبوبة، لا تعي من أمر نفسها شيئا منذ خمسة عشر عاماً.
ففي جزيرة “الوراق” حيث تدور أحداث الفيلم يعيش الطبيب الشاب “حسين” (عبد العزيز مخيون) خاملاً، هاجراً زوجته وأولاده، لأنه أسير الوفاء لأم في غيبوبة، لا تعي من أمر نفسها شيئا منذ خمسة عشر عاماً.
وهو لا يتحرر من هذا الوفاء الزائف الذي هو أقرب إلى الكابوس، إلا بالفسق مع بغي.
أما “رفعت” (يحيى الفخراني) بطل الفيلم، فهو الآخر عاجز لأنه صاحب قلب عليل، يحاول إخفاء علته عن زوجته التي احتملت من مرارة الحرمان الجنسي أهوالاً ثقالاً، بأن يوهمها بالتواطؤ مع الدكتور حسين بأنه ليس مشرفاً على النهاية، بل على العكس في كامل الصحة والعافية.
 الحب الغائب
الحب الغائب
وختاماً فلو ألقينا نظرة طائرة على الأفلام المتقدمة لجائزة الدعم السينمائية للأفلام المتميزة، انتاج عام 1986- وعددها اثنان وثلاثون فيلماً– ثم تأملناها قليلاً، لوجدنا أنها في معظمها أفلام بلا حب “كالبداية” “لصلاح أبو سيف” و”الضائعة” “لعاطف سالم” و”قاهر الزمن” لكمال الشيخ، وإما بحب هشّ غير قادر على الصمود للنوائب أو لإغراء الأشياء “كجذور في الهواء” “ليحيى العلمي” و”الورثة” “لأحمد السبعاوي” و”وصمة عار” “لأشرف فهمي” و”انتحار صاحب الشقة” “لأحمد يحيى”؛ وإما الحب فيها مستورد في شخوصه وأحداثه، لأن قصته مستوحاة من فيلم أجنبي لعب دوراً هاماً في تاريخ السينما العالمية، كما “قبل الوداع” لحسين الوكيل، والمأخوذ جملة وتفصيلاً من فيلم “انتصار الظلام” الذي مثلته “بت ديفيز” مع “رونالد ريجان” (رئيس الجمهورية) منذ خمسين عاماً إلا قليلاً، وأخيراً إما الحب وقصته فيها من ذلك النوع المشوه الماجن الذي يدخل بمن أصيب به في مسالك الريبة والعبث لينتهي به إلى مصير بشع بغيض.
الرحيق والحريق
ولعل “بلاغ ضد إمراة” بموضوعه الذي استوحاه كاتب السيناريو “أحمد صالح” من حادثة وقعت بالفعل، خير مثل على هذا النوع الآثم من الحب، أو بمعنى أصح هذا النوع من العلاقات التي تقوم على الشهوات النارية العاجزة عن الارتفاع إلى مستوى الحب الذي قال به “ستندال”؛ فـ”رضوان” (محمود ياسين) بطل هذا الفيلم الذي أخرجه “أحمد السبعاوي” زوج مخدوع. أكتشف مسالك الريبة والعبث التي تسلكها زوجته “كريمة” (بوسي)، تركها وقتاً ما حتى ظنت أنه لا يعلم من أمر خيانتها شيئا.
 فإذا ما اطمأنت تماماً إلى جهله بما تقترف، دبّر لها مكيدة تدل على الحزم والعزم وشدة المضاء.
فإذا ما اطمأنت تماماً إلى جهله بما تقترف، دبّر لها مكيدة تدل على الحزم والعزم وشدة المضاء.
طلقها مرتين لأسباب تافهة، ثم ردها إلى عصمته بعد أن كان يبدي لها في كل مرة الندم على فعلته ويجزل لها العطاء هدايا سخية، حتى إذا ما طلقها مرة ثالثة وبات مستحيلاً أن يعيدها شريكة لحياته دون زواجها من آخر، تقدم إليها متضائلاً، متهالكاً، مقترحاً أن تتزوج لليلة واحدة من عشيقها “مجدي” (محمد صبحي).
ومع إشراق شمس الصباح التالي لتلك الليلة، كشف لها ولزوجها أنه كان على علم بما كانا مندفعين فيه، وكشف لهما كذلك عما دبره لهما كيداً في الخفاء. فهي بموجب الزواج الذي اصطنعه لها، قد فقدت حقها في النفقة والحضانة.
 وهي لن تملك من حطام الدنيا شيئاً، فالعربة المرسيدس الفارهة، والمجوهرات الثمينة، والفيلا الفخمة التي تحيط بها طبيعة رائعة نسقتها يد الفن أحسن تنسيق؛ كل ذلك قد ضاع عليها لأنه لم يكتبه باسمها كما أوهمها.
وهي لن تملك من حطام الدنيا شيئاً، فالعربة المرسيدس الفارهة، والمجوهرات الثمينة، والفيلا الفخمة التي تحيط بها طبيعة رائعة نسقتها يد الفن أحسن تنسيق؛ كل ذلك قد ضاع عليها لأنه لم يكتبه باسمها كما أوهمها.
ولنا أن نتصور تأثير لحظة الحقيقة هذه على عريس الليلة الواحدة.
فقد كشف عن أن ما كان بينه بين معشوقته ليس حباً وإنما مجرد نزوة عابرة.
وقد كان يمكن “لبلاغ ضد امرأة”– وهو يعرض لعلاقات خطيرة كهذه أن يرتفع إلى مستوى مأساة بطلته، تلك المرأة التي قاومت السقوط، فلم تستطع ثم خادعت نفسها فصورته حباً، فلم يغن الخداع عنها شيئاً.
وأخيراً، وقفت حائرة ممزقة بعد ضياع كل شيء، واكتشفت أن ما قدم لها في الكأس التي شربت منها لم يكن رحيقاً بل حريقاً.
إلا أن شيئاً من هذا لم يعرض له الفيلم، وهذا أمر ولا شك ليس بغريب في سينما تجهل أن الحب أمر خطير.
التصنيف: مجلات
سينما الضياع إلي أين تمضي بنا؟
كان في نيتي أن أدبر جانباً من حديث السينما في شهر مارس حول “دليل الفيلم العالمي 1987” لصاحبه الناقد الإنجليزي “بيتر كووي” لما احتوى على معلومات عن السينما داخل بعض أقطار الوطن العربي وإسرائيل، تقول فيما تقول إن الفن السابع عندنا في واد، والحياة السياسية بنزفها الرتيب في واد آخر، أما عندهم ففن يحتج، يصرخ، يشهر الرايات.
كان في نيتي لولا أنني وقبل أن أحمل القلم لأكتب، شاهدت “الضائعة” و”سكة سفر” فكان أن قفزت إلى ذهني من ظلمات الماضي غير البعيد صورة من أفلام أخرى، لعل أهمها “عودة مواطن” و”وصمة عار” و”الصبر في الملاحات” وكان أن تركت جانباً – خطأً أو صواباً – ما كنت قد هممت بكتابته مستوحي من ذلك الدليل وما سجل على صفحاته من معلومات.. لماذا؟
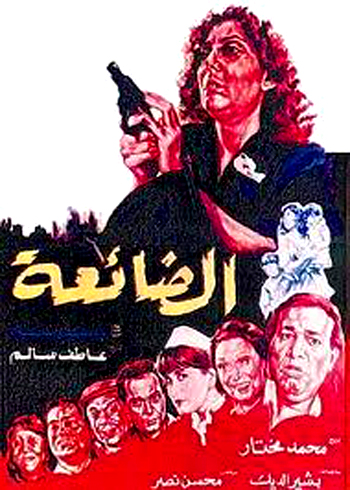 لوجود ظاهرتين أولاهما: أن هذه الأفلام الخمسة تقوم على الميلودراما، ذلك النوع من الفن الراسخ رسوخ الجبال في السينما منذ ولدت في الوطن العربي على أرض مصر قريباً من نهاية العشرينيات، لم تتزحزح عنه أبداً طوال عمرها البالغ ستين عاماً بعد أشهر معدودات.
لوجود ظاهرتين أولاهما: أن هذه الأفلام الخمسة تقوم على الميلودراما، ذلك النوع من الفن الراسخ رسوخ الجبال في السينما منذ ولدت في الوطن العربي على أرض مصر قريباً من نهاية العشرينيات، لم تتزحزح عنه أبداً طوال عمرها البالغ ستين عاماً بعد أشهر معدودات.
فنظرة طائرة على “الضائعة” و”الصبر في الملاحات” و”وصمة عار” تؤكد أن الميلودراما في أبشع صورها، لايزال لها التسلط على السينما عندنا، ولاتزال من ثوابت الجبال.
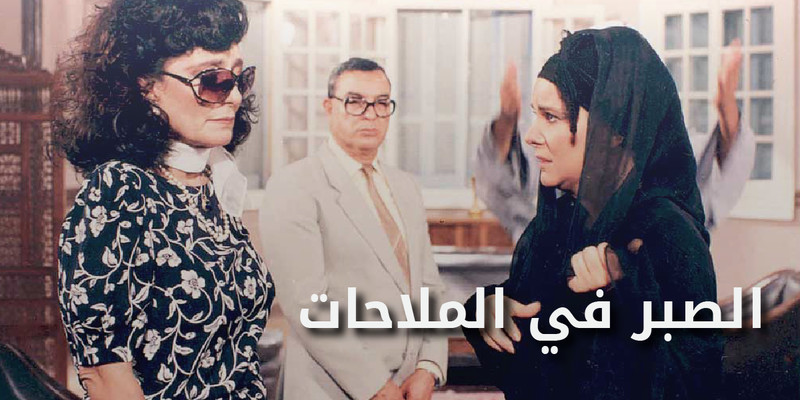 وأن المعركة التي دارت حول الميلودراما في المسرح أواخر عام 1926، أي قبل يوم ميلاد السينما بأشهر قلائل، وكان فارسها “سعيد عبده” الذي أعمل قلمه الحاد في جسم الميلودراما بقوله عن مسرحية “الصحراء” من تأليف “يوسف وهبي” وهو يخلط الجد بالفكاهة.
وأن المعركة التي دارت حول الميلودراما في المسرح أواخر عام 1926، أي قبل يوم ميلاد السينما بأشهر قلائل، وكان فارسها “سعيد عبده” الذي أعمل قلمه الحاد في جسم الميلودراما بقوله عن مسرحية “الصحراء” من تأليف “يوسف وهبي” وهو يخلط الجد بالفكاهة.
“غاب جحا عن أهله أعواما، ثم عاد وقد برح به الشوق إليهم، فسأل أول من طالعه على مدرجة الطريق، قال: أهم جميعاً بخير؟
قال: نعم، اللهم إلا كلبك الأمين، قال: ما خطبه؟ قال: أصابه سعر، فعض أخاك، فقتلوه. قال: وما فعل الله بأخي؟ قال: هلك، فماتت أمك حزناً عليه. قال :وارحمتاه لوالدي المسكين. قال: هوّن على نفسك، فأبوك قد أراحه الله من زمن، فقد قتله الحزن على أخيه الذي ذبحه اللصوص.
ولولا أن حجا المسكين أدرك غراب البين بضربة صرعته لزف له مصارع أهله أجمعين!”
(مسرح الدم والدموع. دراسة في الميلودراما المصرية والعالمية د. على الراعي (ص6) مطبوعات الجديد. الهيئة المصرية العامة للكتاب 1973)
تلك المعركة لاتزال دائرة لم تحسم بعد لصالح أعداء ذلك الفرع من الميلودراما الذي يدور وجوداً وعدماً حول فواجع متراكمة متزاحمة في غير صدق، بل المحزن أنها لاتزال دائرة، وكأن أحداً لم ينطق ضد الميودراما المتردية في العقد الثالث وما بعده بشيء.
مذبحة الضائعة
آية ذلك أول الأفلام الثلاثة “الضائعة” لصاحبه المخرج “عاطف سالم”، فأبطاله وهم أربعة، “زينب” (نادية الجندي) تنتهي بها الخطوب إلى إدمان الهيروين ثم القتل بالجملة، أما الباقون: مطلقها وأبو عيالها (سعيد صالح) وزوجته الثانية وأمها الشريرة (تحية كاريوكا) فجميعاً يموتون برصاصات تنطلق من غدارة الضائعة في لقطات النهايات.
وهكذا وبفضل هذه المذبحة تحققت عدالة السماء كما جاء على لسان ناقد انبهر بالضائعة وفيلمها، فكال لهما المديح والثناء. وثاني الأفلام “الصبر في الملاحات” الذي ألفه وأنتجه “سمير عبد العظيم) وأخرجه له “أحمد يحيى”- هوالآخر إذا ما استبعدنا “فيفي عبده” و”هياتم” و”عزت العلايلي” و”أحمد بدير”- ذو أبطال أربعة، ضابطة متخرجة في كلية الشرطة وتجيد الرقص (نبيلة عبيد)، وأم”مديحة يسري” تتبرع لابنتها الضابطة بإحدى كليتيها إنقاذاً لحياتها، ومجرم (سعيد صالح) سرعان ما نكتشف مع الضابطة التي كانت تجري تحقيقاً معه أنه شقيقها وأن أمها ليست أمها الحقيقية، وإنما سيدة أخرى (تحية كاريوكا مرة ثانية) كان قد ألقي بها وراء القضبان بمكيدة دبرتها لها (مديحة يسري) التي يتبين لنا من جريان الأحداث أنها كانت في سالف الزمان- قبل أن تتوب وتنوب- تاجرة مخدرات تنافس الرجال، ولها شأن كبير في دنيا الكيف والأعمال.
الوفاء والأمل
وأول ما يلفت النظر في فيلم ميلودرامي ساذج كهذا أنه- وعلى عكس الضائعة- افتعل نهايات توفيقية سعيدة، فالضابطة يعقد قرانها على الجراح منقذها، وشقيقها وأمها الحقيقية تكتب لهما النجاة من تيه السجون، وأمها غير الحقيقية تبقى أماً روحية لها من منطلق الوفاء لصنيعها . ولم لا؟
ألم تجدها لقيطة فآوتها وأحسنت تربيتها، ومنحتها كليتها، وفوق هذا جعلت منها ضابطة شرطة وراقصة في نفس واحد.
ولعل تلك النهايات السارة للناظرين، والتي هي تدخل في باب اللغو منها، في باب الفن الذي يحمل في طيه معاني، فيها بعض التفسير لظاهرة إقبال الجمهور العريض على مشاهدة “الصبر في الملاحات”.
فإذا ما انتقلنا إلى ثالثهم “وصمة عار”- وهو أحسنهم- لوجدنا أنفسنا أمام فيلم مأخوذ عن “الطريق” للأديب “نجيب محفوظ”، وهي قصة سبق التحول بها إلى عمل سينمائي من إخراج “حسام الدين مصطفى” وبطولة “رشدي أباظة” و”شادية” و”سعاد حسني”. وبطل الفيلم “مختار سيد الجميعي” (نور الشريف) رجل قد جاوز الشباب شيئا.
وها هو ذا بعد وفاة أمه التي كانت تعوله- هارباً من حياة خاصة في الإسكندرية كلها نكد وشر، مستقلاً القطار السريع إلى القاهرة بحثاً عن أبيه “السيد السيد الجميعي” الذي اختفى من ثلاثين عاماً أو يزيد، ولا دليل على سابقة وجوده على قيد الحياة سوى قسيمة زواجه من أمه وصورة عائلية قديمة.
وسرعان ما يتبين لنا بعد وصول “مختار” إلى المدينة البدينة، ونزوله في لوكاندة “القاهرة” المتواضعة، أن الشيء الأكيد بالنسبة له أنه حائر، قلق، مهموم. والسبب أنه لا يملك شهادة، ولا مهنة. ومن هنا سعيه إلى العثور على أبيه المختفي ابتغاء استرداد بعض ثقته بنفسه.
ميتة كلب
ولكن أحداً لا يدله على مكان أبيه، ولا يُلمح له بطريقة ترشد إليه، وإنما هو أمل يتبعه يأس، ويأس يتبعه أمل، وحيرة مهلكة لنفسه البائسة اليائسة، حتى إذا ما انتهت به رحلة العذاب إلى قتل صاحب اللوكاندة “خليل أبو النجا” (محمد توفيق) بتحريض من زوجته الشابة “كريمة” (شهيرة) وإلى اتهامه بقتل هذه الزوجة والاستيلاء على مالها ثم إلى غرفة الإعدام حيث رأى “عشماوي” مقبلاً نحوه ليحيط رقبته بحبل المشنقة، فعرف أنه الموت، قال هذه الكلمة التي ينتهي بها الفيلم “أبويا”.
الرقص على السلالم
ولم أعرض شيئاً من تفاصيل “وصمة عار” وإنما عرضت خلاصته في كثير جداً من الإيجاز، ولو قد عرضت تفاصيله لتنقلنا داخل عالم غريب، لا هو بالواقعي، ولا هو بالوهمي. وإنما هو شيء بينهما مليء بالرموز والغموض، يفاجئنا قربه وتدهشنا غرابته.
وفي الحق فالفيلم، كما القصة متأثر إلى حدٍ كبير بأدب “فرانز كافكا” ذلك الأدب الذي أظهر ما يمتاز به من الخصائص أنه يصورالقلق الذي يوشك أن يبلغ اليأس ويصور الغموض الذي يضطر القارئ إلى حيرة لا تنقضي.
ومن هنا سعى صاحب “وصمة عار” (أشرف فهمي) إلى استعمال لغة سينمائية غير مألوفة في الأفلام عندنا للتعبير عن هذه المعاني.
وعندي أنه كان في إمكان الفيلم أن يعلو شأنه سينمائياً لو أن صاحبه آثر أن يطوّع مشاهده بحيث يرتفع بها إلى مستوى الرموز في القصة، وابتعد عن الجنوح إلى جعله متجانساً مع نسيج الميلودراما السائدة، ذلك النسيج المجدب الذي لا يُجدي شيئاً.
والآن، إلى الظاهرة الثانية، وهي وليدة خيط رفيع يربط بين بعض هذه الأفلام، وهي بالتحديد “عودة مواطن” و”الضائعة” و”سكة سفر”.
ومما يحمل على التفكير العميق في هذا الخيط أن الأفلام الثلاثة قد جرى عرضها في فترة زمنية متقاربة لا تزيد على أربعة شهور، وأن “بشير الديك” كاتب سيناريو وحوار “الضائعة” هو نفسه مخرج وكاتب سيناريو وحوار “سكة سفر”.
فما هو هذا الخيط؟
عودة الابن الضال
قد يكون من المفيد هنا أن نبدأ بـ”عودة مواطن” بحكم أنه بداية الخيط، فنتوقف قليلاً عند وقائعه ونماذجه متأملين.
المواطن في هذا الفيلم هو “شاكر”(يحيى الفخراني) العائد من مدينة عربية في الخليج مع رصيد كبير من العملات الصعبة، هو مفتاح السعادة في الأرض، وسيارة فاخرة مكيفة الهواء محمولة إليه على ظهر عبارة جبارة، وشقة في عمارة شاهقة بحي راق بعيد عن بيت العائلة في حلوان تتحقق به الأحلام. والجهة العائد إليها هي القاهرة التي كان يتوهم أنها القاهرة نفسها التي تركها هارباً من الأيام منذ ثمانية أعوام، فإذا بها مدينة أخرى غيرها الانفتاح، وغيرها السلام، فهي تبدو لناظريه أرحب وأكبر بكثير من القاهرة التي عرفها قبل السفر، إلا أنها على الإجمال ازدادت مع كرّ الأيام ابتعاداً عن النظافة والجمال، عن الهدوء والنظام.
يبدأ الفليم بلقطات لاهثة مكثفة يتسم بها أسلوب المخرج “محمد خان” نتعرف بفضلها على الشخصيات الرئيسية من خلال رسم سريع لملامحها.
فما أن تلامس عجلات الطائرة أرض المطار حتى نتعرف على “شاكر” العائد إلى أرض الآباء بملء إرادته، حنيناً إلى المصدر، وشوقاً إلى الأهل والمنبت.
إنه من المتفائلين، الواثقين، ولم لا؟ والحقائب الكثيرة الكبيرة المنتفخة بالأشياء تحيط به في جمرك المطار مفصحة عن واسع الثراء، والدولارات هي العملة الوحيدة التي يتعامل بها مع مقتنصي الأرزاق من مقدمي الخدمات.
الكل ساقط
ولا نكاد ننتهي من التعرف على “شاكر” حتى تسبقه الكاميرا إلى بيته الكائن بضاحية حلوان، حيث نكتشف المكان الذي كان مسرح الطفولة والصبا والفتوة، فإذا به عبارة عن مبنى قديم من طابق واحد منعزل عن البيوت، مؤثث بأرائك وأسرّة ومرايا عتيقة تدل على أن عائلة العائد متوسطة الحال.
ثم نتعرف على البقية من أفراد العائلة بعد موت الوالدين أثناء غياب العائد، فإذا بهم أربعة أخوة.
وأول ظهور لأي منهم كان في المطبخ حيث نرى الأخت الكبرى “فوزية” (ميرفت أمين) وقد أوشكت على الانتهاء من إعداد فطيرة شهية.
إنها ربة بيت بمعنى الكلمة، تنهض على رعاية شئون أخواتها، تتفانى في حبهم والسهر على راحتهم، ليس لها من هواية في الدنيا سوى التفنن في صنع أحلى الحلويات.
والفيلم يعتمد عليها في مواجهة شقيقها العائد، فهي وهو البطلان، ومن حولهما أشخاص كثيرون لكل مكانه وأثره.
الأخت الصغرى “نجوى” (ماجدة زكي) تخرجت في الجامعة، تعمل مضيفة في أحد الفنادق الكبرى، اختارت بإرادتها الحرة زميلاً لها يعمل معها ليكون زوجها.
بل ذهبت في شق عصا الطاعة إلى حد الاشتراك معه في شراء شقة دون علم أحد من أهلها.
وأخ “إبراهيم” (أحمد عبد العزيز) هو الآخر تخرج في الجامعة، شارك في شرف العبور، ناله ما ناله بسبب ثغرة “الدفرسوار”، ينتظر خاملاً قرارالحكومة بتوزيع القوى العاملة على المصالح والمؤسسات.
وأثناء الانتظار الطويل الممل يحاول قتل الوقت مع الشطرنج وحبوب مهدئة تأتي إليه بنوم عميق، يتحول به إلى إنسان غير حافل ولا مكترث.
وأخ أخير “مهدي” (شريف منير) لايزال طالباً في الجامعة يهوى الحمام الزاجل، بنى له أبراجاً صغيرة فوق سطح البيت، يحنو عليه، يرعاه، يطير حاملاً الرسائل إلى بيت خاله القريب، هذا الخال (عبد المنعم إبراهيم) الذي هرم قبل الأوان، والذي نكتشف أن بينه وبين “مهدي” محب الحمام تواصلاً سياسياً سببه رحلة طويلة نحو آفاق بعيدة قام بها الخال، وانتهت به نهباً لأقسام الشرطة والمحاكم والسجون.
هكذا كان حال كل فرد من أفراد العائلة لحظة عودة عميدها الأخ الأكبر.
وسواء أكان هذا الحال طيباً أم خبيثا،ً فسيظل كما هو لا يطرأ عليه تغيير أو تبديل ذو قيمة بالنسبة للجميع باستثناء الأخت الكبرى “فوزية”.
لعنه الحلال
فقد كان سقوطها هي الأخرى مفاجئاً، لأن مجيئه كان بلا تمهيد من شخصيتها التي صيغت لنا في أول المشاهد واللقطات صياغة جعلت منها ربة بيت مشغولة بأخواتها وما يختلف عليهم من أحداث، مفتونه بشيء واحد يملك عليها حياتها هو صنع الحلويات.
ولو أن كاتب السيناريو، “عاصم توفيق” مضى في سائر الفيلم على النحو الذي مضى عليه في أوله بالنسبة لهذه الأخت، لأهدى إليها شخصية رائعة تجاهد وتضحي، ولا تشعر بأنها تجاهد وتضحي، وإنما تشعر بأنها تؤدي واجبها نحو عائلتها ونحو نفسها في أيسر اليسر.
ولكنه لم يلبث أن تعثر، فمضى بها هي الأخرى ضحية أخيرة للفساد.
فلا يكاد أخوها العائد يهديها مبلغ عشرة آلاف جنيه كي تحقق به حلم أن يكون لها محل تبيع فيه ما تصنع من حلويات، حتى تكشف أخلاقها عن مكنونها. فكانت الأثرة والأنانية والجري وراء المال والرجال.
وكأنه بذلك أراد أن يقول إن المال الناتج عن الجهاد والاجتهاد على امتداد الوطن العربي ليس مدخلاً إلى حياة بسيطة هادئة في أحضان مصر، وإنما إلى جحيم كل ما فيه نكر وشر.
و”زينب الضائعة” كما “شاكر” المواطن العائد تُبتلى بالعمل في أبي ظبي بلاءً شديداً.
العقاب.. لماذا؟
فها هي وحيدة في مستشفى بهذا البلد البعيد محرومة من فلذتي كبدها وزوجها في مصر، لا لشيء سوى أن تجمع قدراً من المال تشتري به شقة تكون لها ولعائلتها الصغيرة ملاذاً أخيراً.
ولكنها في خضم المهجر المتلاطم بشتى الأهواء والشهوات تتعرض لألوان من الشقاء تنتهي بها متهمة زوراً وبهتاناً بالشروع في إغراء طبيب كان قد سعى إلى الاعتداء على شرفها فباء سعيه بالخسران المبين، وثانياً بسرقة أنابيب أفيون مخصص لتسكين آلام المرضى ضبط بعضها مخبأ ضمن ما تملك من أشياء الحياة.
وطبعاً تشتد بها وتمتد أمواج الاضطهاد، فإذا بنا نراها مفصولة من خدمة المستشفى، عائدة إلى مصر لتجد نفسها فاقدة كل ما أدخرت من مال، بل الأدهى والأمر فاقدة الزوج والعيال، ومن بعدهم العافية والعقل.
وكأن صاحب السيناريو والحوار أراد أن يتخذ من “الضائعة” منبراً يقول منه إن من يقدم على مغامرة السفر والعمل في الوطن العربي ليأتي بمال قليل يكفل له حياة شريفة، لن يظفر بشيء، ولن يترصد له كل يوم سوى العار وسوء المصير.
نقطة مضيئة
وهذا نفس ما تغيّاه بفيلمه “سكة سفر” فبطله “زغلول” (نور الشريف) يعود من بلد عربي بعد غياب دام خمس أعوام قضاها بعيداً عن قريته الفقيرة المطلة على البحر، والتي يكدّ ويكدح أهلها في ملاحات وسط ظروف بالغة الصعوبة، لعل خير مثل على قسوتها ومرارتها “مسعود” (عبد السلام محمد) ذلك الأنسان الغلبان بجسمه النحيل المكدود بعمل بائس لا ينتهي، وتسول بائس لا ينقطع، والذي به يستهل الفيلم في أولى لقطاته حيث نراه يتسلل إلى عشة فراخ ظامئاً إلى بطة يتحقق له بسرقتها حلم التلذذ بالتهامها منفرداً. (هنا يلزم التنوية بدقة الرسم لشخصية مسعود وببراعة أداء الفرفور عبد السلام محمد لها)
واقعية أم عبثية
وعل كُلٍ فإذا ما تركنا تلك الشخصية الفرعية الشهية جانباً، وعدنا إلى “زغلول” الشخصية الرئيسية في الفيلم لوجدنا أمامنا كائناً كاريكاتوريا، بل قل مسخاً شائناً رسم بطريقة تتسم بالفكاهة .
ولكنها فكاهة مرة تضحك من حماقة هذا المواطن العائد وسخفه وضعفه وتعلقه بالمنافع العاجلة وانقياده للوهم.
فهو ما إن استقر به المقام في بيته عند أمه الداية “رتيبة”( عايدة عبد العزيز)، حتى خطط شيخ البلد “توفيق” (حسن مصطفي) للاستيلاء عل ثروته التي كسبها بعرق الجبين في الغربة، مستغلاً في ذلك رغبته الجامحة في الصعود والإثراء.
وبسذاجة منقطعة النظير ينساق “زغلول” إلى مصيدة الإغراء، فيسلم الشيخ ثروته، ويخطب ابنته الدميمة متنكراً لابنة عمه “نعيمة” (نورا) التي بادلته حباً بحب، وانتظرت عودته كما “بينيلوب” طويلاً.
وعندما يفيق من كل هذا يكون قد فقد كل شيء فإذا بحياته تمضي على شرّ حال، وإذا به يعد نفسه للسفر من جديد.
هذه هي الخلاصة الظاهرة للأفلام الثلاثة، وهي كما ترى يربط بينها خط فكري واحد، وهي كما ترى لا تدل على عمق الخيال، ولا على براعة في الابتكار، لأنه ليس من العمق، ولا من البراعة في شيء أن يقال إن السعي إلى تحسين الأحوال بالعمل الشريف في أرجاء الوطن العربي، هو السبب فيما فيه الناس الآن من اضطراب عام أدى إلى انتشار وباء التنافس والتباغض والاحتيال، وأن المال ثمرة هذا العمل بعيداً عن أرض مصر إنما هو مال موصوم ملعون مآله الضياع.
السينما العالمية بين أنياب الفك المفترس
لو اطلعنا على كل من “كتاب الفيلم السنوي-1987″ و”دليل الفيلم العالمي- 1987” لملئنا مما انطويا عليه من معلومات رعبا.
فالأول تقتصر أخبار السينما فيه على الأفلام التي جرى عرضها داخل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وما دار حولها من حواديت وأخبار أما ماعدا ذلك من أفلام فلا ذكر لها- حتى لو كانت من روائع السينما العالمية- سواء بالخير أو بالشر باختصار جعل أصحاب الكتاب منها نسياً منسياً.
ونظرة طائرة على الأفلام التي عرض الكتاب لها يتبين منها :
أولاً: إن معظمها من انتاج أو توزيع الشركات الأمريكية السبعة الرئيسية، ومعها شركة ثامنة إسرائيلية الهوية، اطلقوا عليها اسم ” كانون “.
ثانياً: أن السينما التي أبدعها صانعو الأطياف في الهند والصين الشعبية وجنوب شرق أسيا– وهي في مجموعها يشكل سكانها أكثر من نصف تعداد سكان العالم- هذه السينما لم تحظ بنصيب– ولو ضئيل – من زمن العروض على الشاشات الأمريكية والإنجليزية.
السود واليهود
ثالثاً: أن القارة السوداء لم يستطع المتفرج الأمريكي أو الإنجليزي أن يراها بعيون أفريقية، فلم يعرض على الشاشات سوى فيلم واحد آت من “مالي” اسمه “الريح ” بل إن أحداً من محرري الكتاب لم يتسع وقته لإلقاء نظرة سريعة عليه والكتابة عنه.
رابعاً: أن الأفلام المعبرة عن هذه القارة المبتلاة بثالوث الفقر والجهل والمرض، إنما عبّرت عنها من خلال عيون يهودية أمريكية “اللون القرمزي” لصاحبه “ستيفن سبيلبرج” و “الخروج من أفريقيا” لصاحبه “سيدني بولاك”.
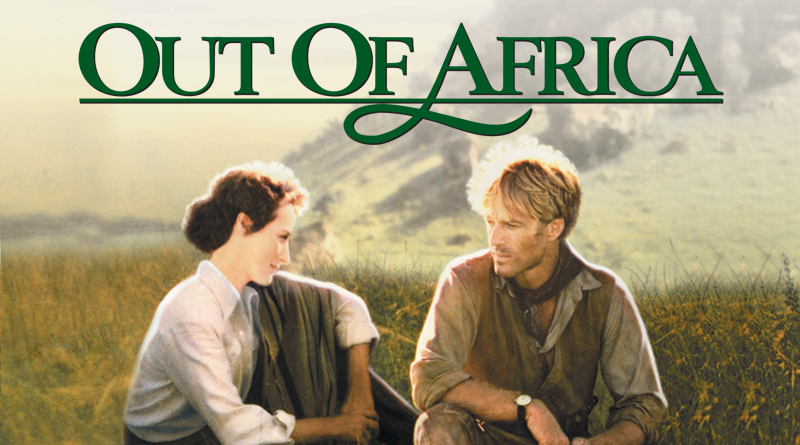 خامساً: إن سينما الوطن العربي وما حوله من شرق أدنى ممتد من تركيا إلى باكستان مروراً بإيران، هذه السينما لم تُتح لأي من أفلامها فرصة الوصول إلى قلوب وعقول الملايين من الأمريكيين والبريطانيين.
خامساً: إن سينما الوطن العربي وما حوله من شرق أدنى ممتد من تركيا إلى باكستان مروراً بإيران، هذه السينما لم تُتح لأي من أفلامها فرصة الوصول إلى قلوب وعقول الملايين من الأمريكيين والبريطانيين.
سادساً: أن الفيلم الوحيد الذي نجح في التسلل إلى هذه القلوب والعقول بفضل شركة “اخوان وارنر” الأمريكية، فيلم اسمه “فيما وراء الجدران” لصاحبه المخرج الإسرائيلي “يوري بارباش”.
ومما قيل، ولايزال يقال عنه في مجال الإشادة به، أنه يعرض لمعاناة الفلسطينيين والإسرائليين في غيابات سجون أرض الميعاد.
سابعاً: أن أفلام أوروبا الشرقية التي جرى عرضها– وهي قليلة جدا– كان من بينها “عندما كان أبي غائباً في رحلة عمل” لصاحبه المخرج الشاب “امير كوستاريكا” المنحدر من عائلة مسلمة-وهو أول فيلم يوغسلافي يخرج من مهرجان كان متوجاً بجائزة السعفة الذهبية (1985).
ولعله من اللازم هنا أن نذكر ان هذا العرض العالمي قد أتيح له لا لشيء سوى أن شركة “كانون” الإسرائيلية قد بادرت إلى شراء حق توزيعه فور فوزه بالجائزة الثمينة المشتهاة.
رامبو- ريجان
 ثامناً: إن الجمهور الذي شاهد أفلام “سيلفستر ستالوني” وحدها– وهي ثلاثة فقط لا غير- فاق بكثير الجمهور المشاهد لجميع الأفلام التي لعب دور البطولة فيها نجوم هوليوود من الرجال “روبرت ردفورد” و”جاك نيكلسون” و”كلينت ايستوود”، فضلاً عن نجومها من النساء الفائزات بجائزة الأوسكار مجتمعات “فستالوني” عارياً إلا من العرق المتصبب من أعلى الخصر في “رامبو 2” و”روكي 4″، مدججاً بالسلاح من أخمص قدميه حتى قمة رأسه في “كوبرا”، متحدياً الجاذبية والممكن كما “طرزان”، هازماً جميع جيوش الأعداء وحده، “ستالوني” هذا هو الذي حدد معايير النجاح والفشل، المكسب والخسارة، تلك المعايير التي خضع لها شباك التذاكر، والتزم بها بالنسبة لجميع الأفلام على مدار العام، مبرهناً بذلك أن أحداً لا يستطيع أن يقهر العضلات الهرقلية الجبارة إذا ما تحركت في عام الغارة الأمريكية على ليبيا.
ثامناً: إن الجمهور الذي شاهد أفلام “سيلفستر ستالوني” وحدها– وهي ثلاثة فقط لا غير- فاق بكثير الجمهور المشاهد لجميع الأفلام التي لعب دور البطولة فيها نجوم هوليوود من الرجال “روبرت ردفورد” و”جاك نيكلسون” و”كلينت ايستوود”، فضلاً عن نجومها من النساء الفائزات بجائزة الأوسكار مجتمعات “فستالوني” عارياً إلا من العرق المتصبب من أعلى الخصر في “رامبو 2” و”روكي 4″، مدججاً بالسلاح من أخمص قدميه حتى قمة رأسه في “كوبرا”، متحدياً الجاذبية والممكن كما “طرزان”، هازماً جميع جيوش الأعداء وحده، “ستالوني” هذا هو الذي حدد معايير النجاح والفشل، المكسب والخسارة، تلك المعايير التي خضع لها شباك التذاكر، والتزم بها بالنسبة لجميع الأفلام على مدار العام، مبرهناً بذلك أن أحداً لا يستطيع أن يقهر العضلات الهرقلية الجبارة إذا ما تحركت في عام الغارة الأمريكية على ليبيا.
تاسعاً: إن الأفلام التي على شاكلة “رامبو” و”كوبرا” مثل “فقد في المعركة” و”غزو الولايات المتحدة الأمريكية” و”كوماندو” و”قوة دلتا” لم تر النور إلا لأنها حسب رأي الناقد “هارلان كينيدي” (ص146) وليدة ذلك الشعور بالفشل الناجم عن الهوة المتزايدة بين المواقف السياسية المعلنة وبين الانجازات في أمريكا المعاصرة.
 فلو كان مذهب “ريجان” القائم على مواجهة إمبراطورية الشر بالعنف ناجحاً في العمل كما في القول، لما كان ثمة حاجة لصناعة سوبر أبطال من بنات الخيال كما “رامبو” (ستالوني) ومغاوير (ارنولد شوارزنيجر) و(شك نوريس).
فلو كان مذهب “ريجان” القائم على مواجهة إمبراطورية الشر بالعنف ناجحاً في العمل كما في القول، لما كان ثمة حاجة لصناعة سوبر أبطال من بنات الخيال كما “رامبو” (ستالوني) ومغاوير (ارنولد شوارزنيجر) و(شك نوريس).
وهنا يحلو للناقد أن يذكرنا بدور المعوق المقطوع الرجلين في فيلم “كنجزراو” الذي يعتبر في نظر الكثير أشهر وأحسن دور أسند لرونالد ريجان طيلة الحقبة السينمائية من حياته الحافلة بالتناقضات.
التمييز العنصري
عاشراَ: إن ما عُرض من أفلام بلاد الشمس المشرقة لا يتجاوز في العدد أصابع اليد الواحدة، وذلك رغم أن السينما في تلك البلاد ولئن كانت قد ضلّت طريقها في السبعينات وبدايات الثمانينات، فإنها سرعان ما أستردت أنفاسها، وسرعان ما احتلت مكان الصدارة في ساحة الفن السابع منذ عامين أو يزيد.
ولعل الفضل في ذلك يعود إلى شيخ مخرجيها “اكيرو كوراساوا” مع كوكبة ملهمة من مبدعي الأفلام أمثال “ماساهير شينودا” صاحب “جونزا الرماح” الفيلم المتوج بجائزة مهرجان برلين الأولى (1986) والذي عرض في مهرجان القاهرة الأخير، و”يوشيشيجي يوشيدا” صاحب “وعد” و”يوشيميتز موريتا” صاحب “بعد ذلك” و”الموت في توكيميكي” و”يوجيرتاكيتا” صاحب “مجلة هزلية” و”كايزو هاياش” صاحب “النوم من أجل الحلم”.
وقد يكون من الخير هنا أن نلاحظ أن أصحاب الكتاب قد اعتبروا “فوضى” فيلم “كيروساوا” الأخير واحداً من أهم أفلام العام، أدخلوه ضمن أحسن أربعة عشر عملاً سينمائياً لاقت استحسان النقاد أو الناس أو الإثنين معاً، وهي “حنا وشقيقاتها” (وودي آلن) “اللون القرمزي”، “قبلة المرأة العنكبوت” (هيكتور بابنكو)، “مبتدئون تماما” (جوليان تمبل) “في قاع بيفرلي هيلز” (بول مازورسكي)، “رامبو 2” (جيمس كاميرون)، “روكي 4” (ستالوني)، “شرف بريزي” (جون هوستون)، “بعد ساعات العمل” (مارتين سكورسيزي)، “العودة إلى المستقبل” (روبرت زيمسكي)، “البرازيل” (تيري جيليام)، “حد خشن” (ريتشارد ماركان) ثم “الخروج من أفريقيا”.
والفيلم الأخير كان مرشحاً مع “فوضى” للعديد من جوائز أوسكار (1986).
ومن عجب أنه هو الذي كتب له أن يخرج من مضمار أوسكار الدامي متوجاً بسبع جوائز، من بينها جائزتا أحسن فيلم وأحسن إخراج.
في حين أن فيلم “كيروساوا” لم يقدّر له أن يفوز إلا بجائزة واحدة يتيمة (الملابس) تفضل بها المسنون المتحكمون في شئون أكاديمية السينما الأمريكية تفضلوا بها على المخرج الياباني الكبير.
 وهنا قد يكون من المفيد الوقوف قليلاً عند هذين الفيلمين، كيما نرى كيف تخطيء هوليوود الحساب.
وهنا قد يكون من المفيد الوقوف قليلاً عند هذين الفيلمين، كيما نرى كيف تخطيء هوليوود الحساب.
أنفقت عاصمة السينما على “الخروج من أفريقيا” ستة وعشرين مليون دولار. ومع ذلك جاء الفيلم خلواً من السحر والسر اللذين بدونهما لا يمكث العمل الفني في الذاكرة، خلواً من تصوير أفريقيا إبان الربع الأول من القرن العشرين على الوجه الذي نحب.
أما “فوضى” فلم ينفق عليه سوى نصف هذا المبلغ من الدولارات أو ربما أقل قليلاً، ومع ذلك فهو آية من آيات الفن السابع التي نتجمل بها، نحيا بزادها طويلاً.
وعلى كُلٍ ففي فيلم “بولاك” تمثيل النجمة اللامعة “ميريل ستريب” دور كاتبة القصة “ايزاك دينيسن” المنحدرة من أصل دانمركي، والتي شدّت الرحال إلى كينيا قبيل إندلاع نيران الحرب العالمية الأولى بأشهر معدودات، لا لشيء سوى أن تبدأ حياة جديدة مع زوجها البارون “براو بليسكن” (كلاوس ماريا برانداور) في ضيعة لزراعة البن اشترياها بغرض الاستقرار والاستعمار.
 أغنية البجعة
أغنية البجعة
غير أنه ما إن لمست قدما البارونة “كارين بليسكن” أو “ايزاك دينسن” أرض الضيعة، حتى انتصبت أمام عينيها أفريقيا شامخة في كبرياء، حتى سمعت تغاريد تخرج من فم القارة العذراء، يرددها صوت رخيم انخطفت بحزنه، شعرت به مجهداً، مودعاً الحياة، فأحست بقلبها ينعصر وعينيها تغيمان.
وكان أن أسرعت بتدوين ما سمعت، تحولت به في نهاية المطاف إلى أنشودة تبكي مرارة الفراق والفقدان.
والفيلم مستوحى بتصرف من كتاب “ايزاك دينيسن” الذي أعطته اسم “الخروج من أفريقيا” وهو عبارة عن ذكريات وباقة من الحكايات، ضغطت الزمن فيها وأعادت تشكيله ، دمجت الوقائع بحيث لم تبح فيه إلا بالنزر اليسير من الأسرار. لم تسجل منها إلا مقاطع لا تصلح للدلالة فقط عن أحاسيسها في دورة حياتها التي قضتها في ربوع أفريقا تسمع التغاريد الأخيرة.
 ومهما يكن من شيء، فبفضل “كورت بوتكيه” كاتب السيناريو والحاصل على الأوسكار عنه، ملئت الفراغات في هذه الذكريات والحكايات، وبفضل “بولاك” صاحب “إنهم يقتلون الجياد.. أليس كذلك” خرج الفيلم في شكل قصة كاملة متكاملة، وفي صورة مشاهد مرسومة رسماً مدهشاً. تنهض على أقل القليل من الحوار.
ومهما يكن من شيء، فبفضل “كورت بوتكيه” كاتب السيناريو والحاصل على الأوسكار عنه، ملئت الفراغات في هذه الذكريات والحكايات، وبفضل “بولاك” صاحب “إنهم يقتلون الجياد.. أليس كذلك” خرج الفيلم في شكل قصة كاملة متكاملة، وفي صورة مشاهد مرسومة رسماً مدهشاً. تنهض على أقل القليل من الحوار.
حلاوة زمان
وهو يبدأ بالبطلة وحيدة لا تغمض لها عين، تستعيد حلماً بعيد المنال، تتصور أفريقيا بمروجها وغاباتها، بوديانها وجبالها تناطح بجلالها السحاب، تتصور حبها الأول والأخير.
ثم يلتفت الفيلم إلى الوراء، إلى ماضيها حيث نراها في كينيا تستقبل حياتها الجديدة بوجهها الناعم الهادئ، بعينيها الزرقاوين الواسعتين اللتين لم تفقدا بعد حلاوة الحياء.
ومع ذلك فثمة مسحة من الحزن والألم المكبوت تطفو على سطح هذا الوجه الجميل. لماذا؟
لأن الأقدار قد جمعتها في رباط يعز فكه مع رجل “برانداور” لا يجمع بينها وبينه أي جامع، لا الذوق ولا العقل، ولا المزاج ولا العاطفة.
فما من لذة في الكون تفوق في اعتباره، لذة الاستمتاع بالمال والنساء، وهي من هذه السوقية في جحيم.
ثم كان ماكان، غيّرت أفريقيا مسار حياتها، دفعت نفسها المتعطشة إلى الهدوء والبساطة والصفاء، دفعتها دفعاً إلى حب الأرض والناس.
اعتمدت على إخلاص خادمها الصومالي الأمين “فرح”، وعلى صداقة رائدين لا يستقران، لا يتقبلان الحياة كما هي، يبحثان عن المجهول دوماً.
وكان لأحدهما “فنسن هاتون” (روبرت ردفورد) منزلة خاصة، كان أرستقراطي الطباع، طياراً، بطلاً في الحرب، رياضياً، مولعاً بالصيد.
وكان كلما اقتربت منه زاد من الابتعاد.
ولكن لا دوام لنعيم مقيم على الأرض. فبعد أعوام من السعادة أفلست المزرعة، مات “هاتون” فارس الأحلام أصابها الزوج البارون بالزهري، تركت الفردوس مهزومة، أقرب إلى حطام .
واذا كان فيلم “بولاك” هكذا فهو لا يعدو أن يكون في جوهره حنيناً واشتياقاً إلى أيام كانت فيها أفريقيا فردوساً يسود فيه البيض السود.
الاتحاد قوة
والآن إلى “فوضى” الذي جاءت فكرته “كيروساوا”، وهو يعيش في كوخه المحبب إلى نفسه، والمطل على جبل “فوجي” بمنظره الخلاب بعد أن فقد شريكة حياته الممثلة “بركوياجوش” كيف؟
منذ عشرة أعوام إلا قليلاً، وأثناء شتاء برده قارص شديد، أخذ “كيروساوا” يتذكر حكاية شهيرة من التاريخ الياباني القديم، بطلها لورد محارب اسمه “موري موتوناري”.
وما أن اكتملت في ذهنه صورة هذا اللورد، حتى بدا وكأنه من لحم ودم، وحتي بات لا يفارقه.
فما هي الحكاية؟
كي يوضح لأبنائة الثلاثة مزايا أن يكونوا يداً واحدة، وصوتاً واحداً، أمسك اللورد “موري” بسهم منفرد وشرع في كسره فانكسر، ثم أمسك بثلاثة أسهم مجتمعة محاولاً كسرها، فلم يفلح.
 وفهم الأبناء المقصود بالرسالة، عاشوا بحكمتها سعداء ولكن سؤالاً ظل يطارد “كيروساوا” ماذا كان يمكن أن يحدث لأسرة اللورد “موري” فيما لو لم يستمع الأبناء للنداء، فتفرقوا وأصبحوا أعداء؟!
وفهم الأبناء المقصود بالرسالة، عاشوا بحكمتها سعداء ولكن سؤالاً ظل يطارد “كيروساوا” ماذا كان يمكن أن يحدث لأسرة اللورد “موري” فيما لو لم يستمع الأبناء للنداء، فتفرقوا وأصبحوا أعداء؟!
وهنا شرد به خياله إلى العجوز “لير” وبناته “جونريل” و”ريجان” و”كورديليا” في مسرحية شكسبير.
ولادة رائعة
ومن داخل نفسه المولعة بالأديب الإنجليزي الكبير من داخل ما ترسب فيها على مدى السنين تذكر فيلمه “قلعة خيوط العنكبوت” أو “عرش الدم” (1957) المستوحى من مسرحية “ماكبث”.
تذكر كيف ازدادت “ليدي ماكبث” اندفاعاً بجنون الطموح، بقوة تداعي الأحداث، ومنطقها إلى مزيد من القتل والإيغال في الجريمة وأوحالها.
كيف اغتالت النوم بحيث لا تستطيع أن تفلت من حمى الأرق إلا إلى كابوس دائم لا يقتصر عذاب العيش فيه عليها وعلى زوجها بل يشمل الجميع مذنبين كانوا أم أبرياء.
وبفضل هذه الافكار والمؤثرات التي اتصلت بفكره، وبفضل وشوشات لم يكن يحسب لها أي حساب، تحولت بنات “لير” الثلاث إلى أبناء ثلاثة للورد “هيديتورا” وتحولت “ليدي ماكبث” إلى زوجة الابن الأكبر “ليدي كايدي”.
وما أن اكتملت في ذهن المخرج الكبير صورة هذا اللورد، وهذه الليدي، حتى بات من السهل عليه أن يخلق الظروف التي تمكن من كشف ما في نفسيهما ومن فضح ما في الحياة التي تكرّ حواليهما من بشاعة وغثيان.
وفي أقل من شهر انتهى مع معاونية من كتابة سيناريو “فوضى” الذي ظل بأطيافه حبيس الأدراج، أسير الظلام زهاء تسعة أعوام.
وبغتة جاءه الفرج في صورة ممول يحمل في حقيبته المال اللازم للإبداع .
وما أن اكتمل الإعداد للتصوير، وأخذت الكاميرات في الدوران حتى بدأت ملامح اللورد “هيد يتورا- لير” (تاتا سويا ناكا داي) و” الليدي كايدي” ( ميكوهارادا) تبرز كما من خلال الضباب، ثم لم يلبث الضباب أن أنقشع وإذا أمامنا فيلم يعكس كمرآة الفوضى التي تشوب العلاقات الاجتماعية.
 عالم يشتعل
عالم يشتعل
فكل أنواع الولاء التي يرتهن بها الاستقرار كولاء الرعية للحاكم، والولد لأبيه، والزوجة لزوجها، والخادم لسيده، ها هي ذا على الشاشة العريضة تتفكك، تتهاوى حتى تذوب وتتلاشى.
فليدي “كايدي” وزوجها “جيرو” وشقيقه “تارو” ابنا اللورد العجوز، إنما هم من عالم بعيد انقطعت صلته بالإنسان، هم أقرب إلى قوى فوضى أطلق لها العنان.
وعكس ذلك الابن الاصغر”سوبارو” والبهلول المتدثر بثياب النساء، فالصلة لم تنقطع بينهما وبين قيم الولاء ولعل خير وصف لهذا الزمن الموغل في القدم الذي أبدع تصويره “كيروساوا” في كل لقطة كبرت أم صغرت من فيلمه الأخاذ! لعله ذلك الوصف الذي جاء على لسان أحد الأبطال: “وإذا الحب يفتر، والأصدقاء يتمردون، والإخوة ينقسمون، الشغب في المدن، والفتنة والخيانة في القصور.
لقد انقضى أفضل ما في زماننا، وراحت المؤامرات والنفاق والغدر وضروب الشغب الهدّام تتعقبنا بضجيجها حتى القبر.
الفلك المترنح
وختاماً فالأكيد أن “كيروساوا” قد اتخذ من”هيديتورا” ترجماناً لأفكاره، فصوّر ما كان من شأنه مع أبنائه الثلاثة وزوجة ابنه الأكبر “ليدي كايدي” خلال الأيام العصيبة التالية لقيامه بتوزيع ما يملك من متاع الحياة الدنيا على الأبناء الثلاثة، جاعلاً منه رجلاً عجوزاً بلغ من العمر ثمانين وزيادة، رجلاً مستبداً، ولكن مستنير الفكر والقلب.
 تبدأ مأساته حيث تنتهي عادة المآسي، تبدأ وكأنه في اللحظات الأخيرة من رحلة العمر، في حين أن تلك الرحلة لم تبدأ بعد، وأن أمامه ليالياً سوداء طوالاً، كلها بؤس وعسر.
تبدأ مأساته حيث تنتهي عادة المآسي، تبدأ وكأنه في اللحظات الأخيرة من رحلة العمر، في حين أن تلك الرحلة لم تبدأ بعد، وأن أمامه ليالياً سوداء طوالاً، كلها بؤس وعسر.
وجعل من ابنائه وزوجته الأكبر سناً نماذج لشتى النزعات البشرية من الشهوات الجامحة إلى الطهارة المطمئنة. ومع ذلك فلا أحد منهم مطلق في خيره أو في شره، فحتى “ليدي كايدي” التي تجمع في شخصيتها شر “جونريل و”ريجان” و”ادمون” في ” الملك لير” مضافاً إليها شر “ليدي ماكبث” و”ياجو” المتآمر الحسود في “عطيل” حتى هذه المرأة المتحجرة والتي تعتبر في الفيلم رمزاً للشر، أو هكذا تبدو لنا، نشعر نحوها ببعض التعاطف لأننا نحس أن ما بها من تشويه يدفعها إلى السعي لتدمير كل من كان منها قريب، إنما سببه فوضى أسلوب الحياة في قصور، هي في حقيقة الأمر قبور، تلك الفوضى التي أطلقت أبشع غرائزها، حطمتها جعلت كل ما حولها خراباً يباباً.
لقاء
وبعد، فإذا كان لكل ما تقدم مغزى، فهو أن السينما عند مصنع الأحلام في هوليوود موظفة لخدمة السياسة، ومن هنا غلو أصحابه في تقدير “الخروج من أفريقيا” وغلوهم في عدم تقدير “فوضى” غلواً شديداً.
والآن، وقد طال الكلام عن “الكتاب” إلى حد الإملال، فلا مفر من الاعتذار، وتأجيل الكلام عن “الدليل” إلى لقاء قريب.
